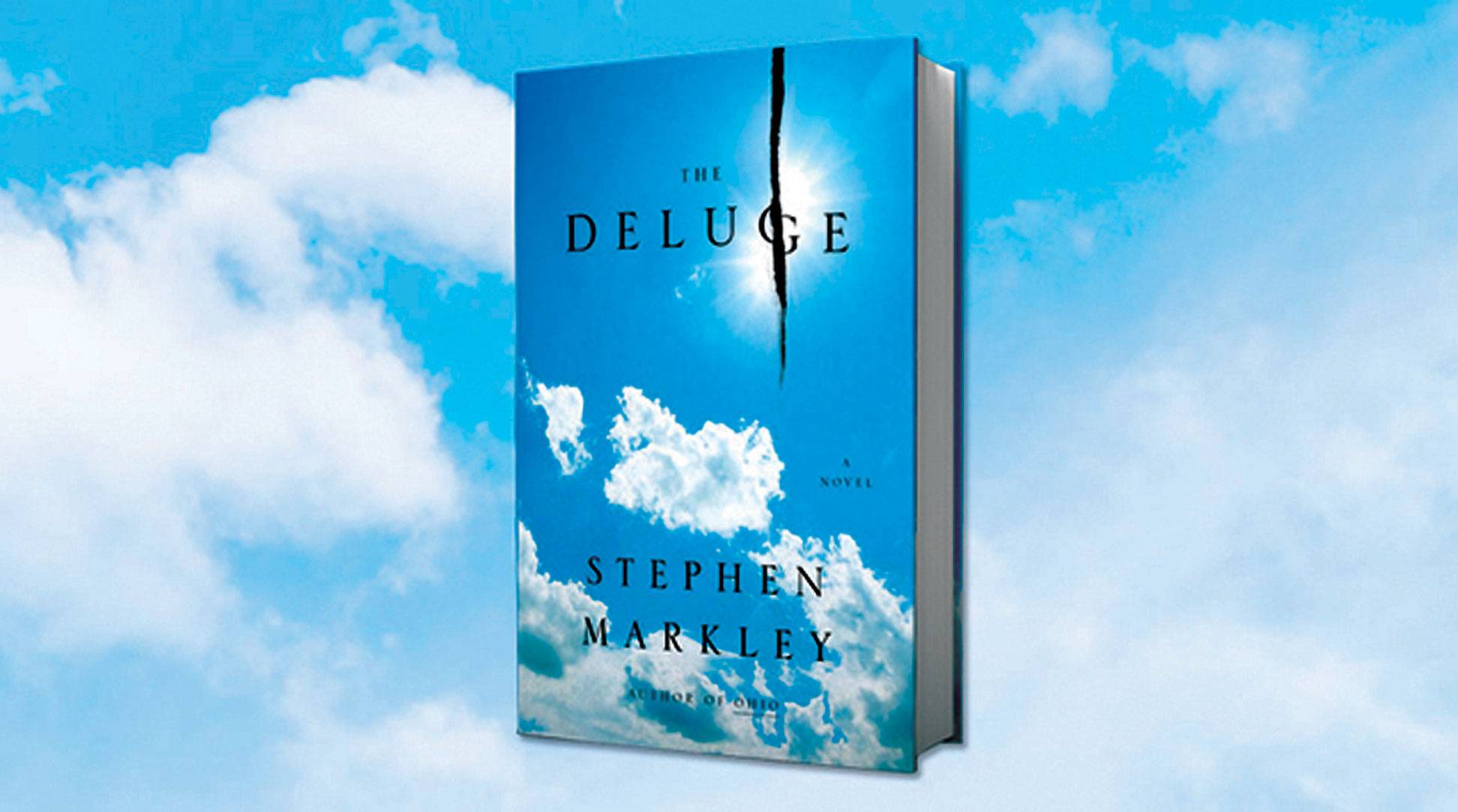نعى مثقفون وأدباء الناقد والأكاديمي المصري البارز الدكتور محمد عبد المطلب الذي رحل عن عالمنا «اليوم الأربعاء» عن 88 عاماً بعد مسيرة حافلة بالعطاء، أثرى من خلالها النقد الأدبي، وكان من أبرز المؤسسين للرؤى والأفكار التي تدعو للتجديد، واحتضن شعراء الحداثة في الوقت الذي كان فيه زملاؤه يهاجمونهم بقسوة، كما انفتح على التيارات الإبداعية التي رفعت شعارات التمرد والقطيعة مع الأجيال السابقة.
تميز الراحل بحس إنساني راق ومدهش من حيث خفة الظل واختصار المسافة مع الآخرين والتواضع اللافت، مع الحرص الشديد على حضور الأمسيات والندوات المختلفة ما دام كانت لديه المقدرة الصحية، كما حرص على التواصل المباشر مع المبدعين والاشتباك مع نصوصهم بقوة وحرارة، ولم ينزو وراء أسوار الجامعة في أبراج عاجية، مكتفياً بالتنظير وترديد أحدث النظريات الغربية في الأدب والنقد.
ولد الراحل في عام 1937 بمدينة المنصورة، وحصل على الماجستير والدكتوراه في «النقد والبلاغة» عامي 1973 و1978، كما ترأس لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة بمصر، فضلاً عن ترؤسه تحرير كثير من السلاسل الإبداعية الصادرة عن وزارة الثقافة المصرية، مثل «دراسات أدبية»، و«أصوات أدبية».
تميز الدكتور عبد المطلب بالتعمق في أسرار التراث العربي البلاغي والشعري، والجمع بينه وبين التيارات الحداثية ابنة اللحظة الراهنة، وهو ما تجلى في كثير من مؤلفاته، مثل «قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني»، و«دراسات في النقد القديم»، و«قراءة ثانية في شعر امرئ القيس»، و«اتجاهات النقد والبلاغة في القرنين السابع والثامن الهجريين»، و«بناء الأسلوب في شعر الحداثة»، و«قراءات في الشعر الحديث»، و«هكذا تكلم النص»، و«شعراء السبعينات وفوضاهم الخلاقة»، و«اللغة والهوية»، و«قراءات في اللغة والأدب والثقافة».
مصدر طمأنينة
ويرى الشاعر إبراهيم داوود في الراحل «حالة فريدة في الثقافة المصرية، ليس فقط بسبب منجزه النقدي العريض والمتنوع الذي تشهد عليه كتبه الـ35، ولا بسبب مكانته الأكاديمية كونه أستاذاً في جامعة عين شمس تربت على يديه أجيال، ولكن بسبب رحابة صدره ونقائه وحبه للحياة ودفاعه عن الثقافة المصرية ودورها، هو الرجل الذي كان يتمنى أن يصبح شاعراً، وحين عجز عن قوله، اتجه إلى نقده، وقدم 14 كتاباً عنه، وكتب في أصوله التراثية وفي تحولاته الجديدة، وقدّم أول كتاب عن قصيدة النثر هو (النص المُشْكل) بعد أن كنا لا نقرأ عنها إلا من خلال ترجمات سوزان بيرنار وغيرها».
ويضيف: «مشكلته الوحيدة، كما قال الناقد السوري الكبير كمال أبو ديب، تكمن في اسمه، لأنه لو كان اسمه (جون) أو (أوستن) لكان له شأن عظيم في العالم، أراد إقناع الناس أن التراث به ما يصلح لمواجهة التحديات الجديدة في الأدب والنقد، لم تعجبه مقولة (البلاغة علم قد احترق ولم يعد صالحاً)، وبعد رحلة مع المنجز الغربي في نظريات ومناهج الحداثة، كتب كتابه (بناء الأسلوب في شعر الحداثة)، الذي طبق فيه علم البديع، والذي يقول عنه المتحذلقون إنه علم متخلف، على الشعر الحديث، ليثبت أن كثيراً من مصطلحات الحداثة ليست إلا تعديلاً للمصطلح العربي القديم، النقد بالنسبة له هو مناقشة الأمر في ضوء شرطه التاريخي، لأن معظم مقولات النقد الجديد تغفل هذا الشرط، ويتصور البعض أن النقاد القدامى يجب أن يقولوا ما يقولونه هم الآن، فهو يرى أن الأسلوبية عند الجرجاني أدق من الأسلوبية الوافدة، وأن البنيوية التي افتخروا بها وروج لها أبناء جيله ماتت سنة 1968، لأنها حولت النص الأدبي إلى نص لقيط من دون آباء ودون أبناء، ولم تنجح التفكيكية أيضاً لأنها نظرية فلسفية وليست نقدية».
ويختم داوود شهادته قائلاً: «أحببت الدكتور عبد المطلب على المستوى الإنساني لبساطته وعفويته وتواضعه، ولأنه يمتلك إلى جوار قيمته كونه ناقداً عظيماً روح الفنان المحب للناس والثقافة ومصر المكان والمكانة، والذي تشعر وأنت في حضرته بطمأنينة لا تعرف مصدرها» .
الأب قبل المعلم
ويسترجع الناقد اليمني البارز الدكتور فارس البيل ذكرياته الشخصية وعلاقته الإنسانية مع الراحل الذي يصفه بأنه «أستاذه ومعلمه الأول، فمنذ دلف إلى المدرسة لا يتذكر معلماً واحداً كان له هذا الأثر في حياته، بوصفه أستاذ أجيال وبحاثة ملهماً، ناقد النظريات وصناجة الأدب وشارح البلاغة الكبير». ويضيف: «التقيت به لأول مرة طلباً للتتلمذ على يديه، ليمنحني فخر إشرافه على رسالتي للدكتوراه، بعد أن انتقلت من جامعة القاهرة إلى جامعة عين شمس من أجله خصيصاً هو والناقد الراحل الدكتور صلاح فضل، كي أظفر بأحدهما، والحقيقة أني ظفرت بهما معاً، لكني رغبت أكثر بالتتلمذ على يده، رغم ما سمعته عن حزمه وشدته على تلاميذه، ودقته المتناهية في كل شيء، إلا أنني وجدته أباً قبل أن يكون معلماً. أفسح لي في قلبه مكانة، وهكذا كان يفعل مع كل تلاميذه ومن عرفه، ثم قربني حتى صارت مكتبته الخاصة في شقته العتيقة التي يقيم بها وحيداً بحي مصر الجديدة، مرتعاً لي. وكلما زرته في بيته عدت بحصيلة ثمينة، لا يمانع أن أتطفل على مكتبته وأقتنص منها ما أشاء. ولا ينسى أن يشير لي إلى ثلاجته الممتلئة بالعصائر لضيوفه. ويمضي الناقد اليمني قائلاً: «منذ أول لقاء، وكان في الثمانينات من عمره، أدركت قيمة الوقت عنده، تأخرت دقيقتين فقط عن موعدي فعاتبني بشدة رغم أني كنت أنتظر على الباب وبعدها لم أتأخر دقيقة واحدة. ما إن أدرك رغبتي في التعلم حتى منحني من العلم ومفاتيح المعرفة ما شاء له الله، لا يدخر شيئاً ليهبك، ولا يحتفظ بمعلومة دون أن يسديها بكل تواضع وحب. كان صاحب نظام صارم في حياته، وترتيب دقيق لوقته، وهذا ما جعله يترك عشرات المؤلفات ومئات الأبحاث التي تجول في ثنايا الجامعات العربية والأجنبية، ويستفيد منها آلاف الباحثين والطلاب والأساتذة على السواء . يصحو باكراً، ويقرأ حتى موعد ذهابه إلى الجامعة، ويعود عند الظهيرة، وينام قليلاً ثم يعود لكتبه حتى المساء. في الليل يفتح تليفونه الأرضي لساعتين فقط، للرد على مكالمات أصدقائه وطلابه، ثم ينزعه. وكانوا يعرفون مواعيد تليفونه بالضبط حتى موعد نومه. توقف عن متابعة نشرات الأخبار والبرامج السياسية قبل سنوات بعيدة».
ويؤكد الشاعر والناقد المسرحي يسري حسان أن «الدكتور محمد عبد المطلب لم يكن مجرد أستاذ جامعي تتلمذ على يديه المئات، بل كان أباً وأخاً وصديقاً للجميع، ولم يكن من أولئك الأساتذة القابعين خلف أسوار الجامعة، لكنه كان متواصلاً مع الحياة الثقافية في كل مكان بمصر وخارجها. ورغم أستاذيته ومكانته الكبيرة وعلمه الغزير كان آية في التواضع والبساطة وجبر خواطر الآخرين».
ويسترجع القاص والكاتب المغربي أنيس الرافعي ملابسات أول زيارة له إلى مصر قائلاً: «كنت أشارك حينها في مؤتمر القصة القصيرة الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة، وفوجئت أن الناقد الكبير والعالم الحُجة الدكتور محمد عبد المطلب هو من يدير الندوة، وقد كان شخصاً ذا مهابة وجلال وعلم غزير. وفي نهاية شهادتي، أثنى علي ثناء لن أنساه ما حييت، أمام أسماء عربية وازنة، ثم طلب مني - بتواضع العظماء - أن أعطيه مجموعة قصصية لي، كي يطلع على كتاباتي بشكل أفضل».