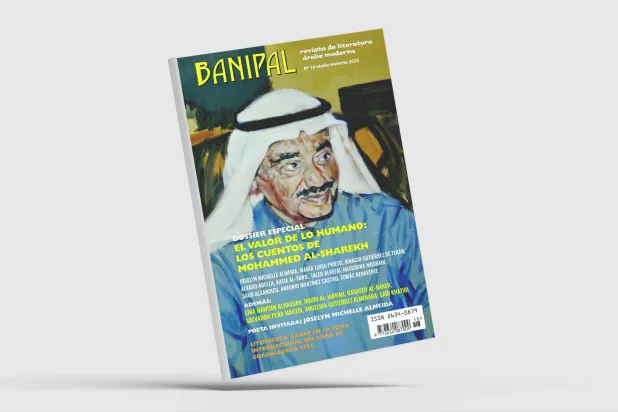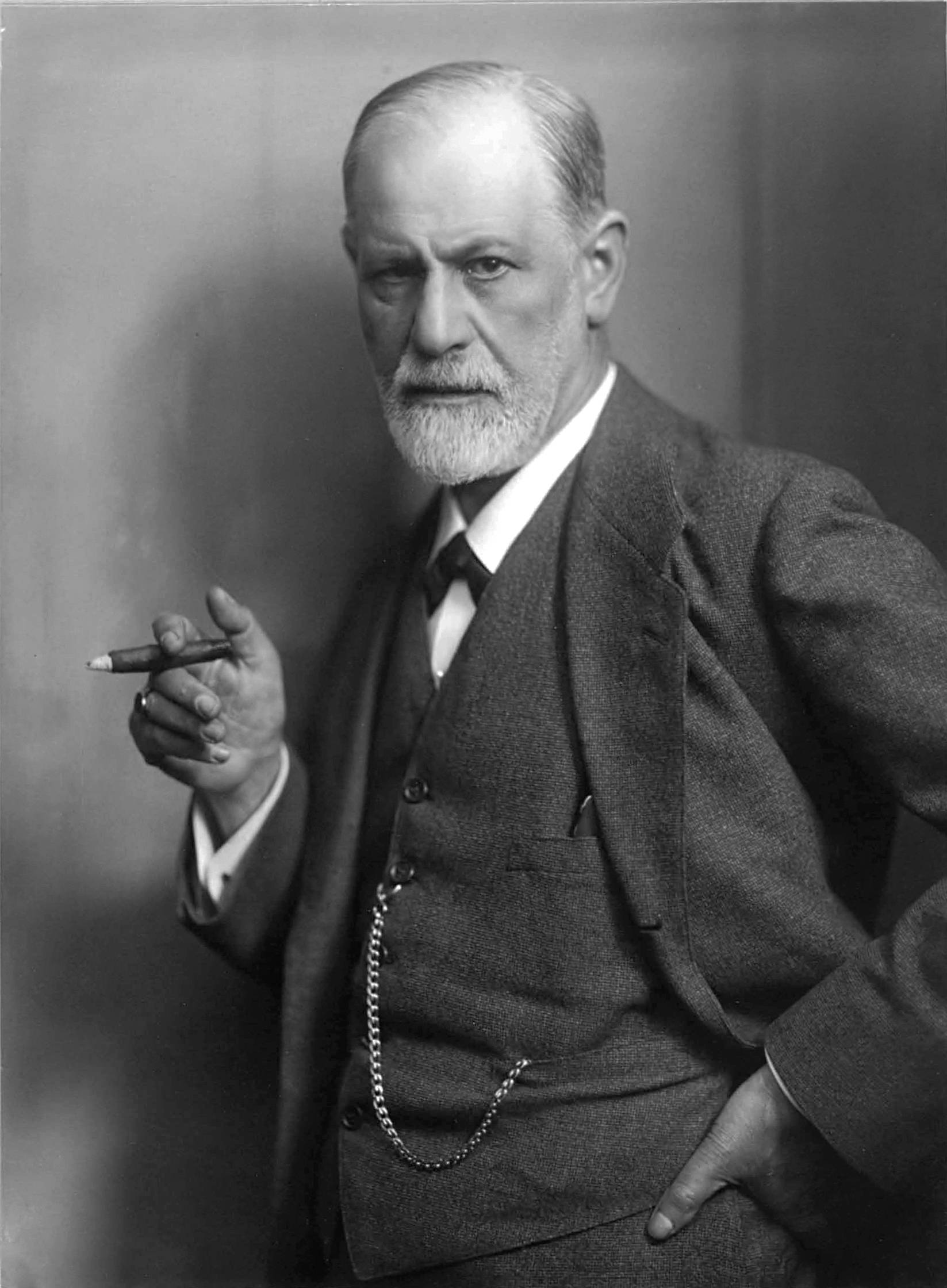في الثامن من سبتمبر (أيلول) من كل عام، تتجدد وقفة الإنسانية مع قضية تمس صميم كرامتها وجوهر تقدمها: اليوم العالمي لمحو الأمية. هذا اليوم، الذي أقرته الأمم المتحدة منذ عام 1965، يكتسب في عصرنا الراهن أبعاداً أكثر عمقاً وتشابكاً. ففي زمن تتداخل فيه الحروف مع الخوارزميات، وتتصارع الكتب الورقية مع بريق الشاشات الذكية، نجد أنفسنا عند مفترق طرق حضاري يحتم علينا إعادة تعريف مفهوم «الأمية» ذاته. لم تعد الأمية اليوم مجرد عجز عن فك الرموز المكتوبة، بل تحولت إلى ظاهرة متعددة الأوجه تشمل الأمية الرقمية، والإعلامية، والمعلوماتية.
هذا الواقع يضعنا أمام تحدٍ مزدوج: كيف نستثمر الثورة التقنية الهائلة لمحو الأمية التقليدية، دون أن نسقط في فخ أمية جديدة، قد تكون أكثر تعقيداً وخطورة؟
لقد شهد العالم خلال القرنين الماضيين تحولاً جذرياً في مشهد المعرفة. ارتفعت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة من نسبة متواضعة لم تتجاوز 10 في المائة في مطلع القرن التاسع عشر، إلى ما يزيد على 86 في المائة من سكان العالم اليوم. هذا التقدم الحضاري الهائل يعكس جهوداً دؤوبة بذلتها الأجيال المتعاقبة في سبيل تحرير العقل البشري من أسر الجهل. لكن هذه الصورة المشرقة لا تخلو من ظلال قاتمة، إذ ما يزال 754 مليون شاب وبالغ حول العالم يفتقرون للمهارات الأساسية، بينما يعيش 2.6 مليار إنسان خارج العالم الرقمي، محرومين من نعمة الاتصال بالشبكة العنكبوتية. إنها أرقام تذكّرنا بأن رحلة محو الأمية لا تزال في بدايتها.
الأمية الرقمية
وفي فضائنا العربي، تتجلى تعقيدات هذا التحدي بوضوح أكبر. فقد سجل مرصد «المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» (الألكسو) ارتفاعاً مقلقاً في أعداد الأميين من 61 مليوناً عام 2016 إلى 70 مليوناً عام 2020، مع تحذيرات من بلوغ هذا الرقم 100 مليون بحلول عام 2030 إن لم تتسارع وتيرة المعالجات. لكن في قلب هذه الصورة، تضيء بقع نور مشرقة؛ فقد حققت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً ببلوغ معدل الإلمام لدى البالغين 97.9 في المائة، كما مثّل إطلاق منصة «مدرستي» نقطة تحول تاريخية في مسيرة التعليم السعودي، مبرهنةً على قدرة التقنية في ضمان استمرارية التعلم. وعلى صعيد المبادرات الإقليمية، استطاع «تحدي القراءة العربي» أن يستقطب أكثر من 28 مليون طالب، مما يعكس حيوية الحراك الثقافي العربي وإصراره على مواجهة تحديات عصر المعلومات.
تقف الثورة الرقمية اليوم على مفترق طرق أخلاقي حاسم. فمن جهة، تحمل في طياتها إمكانات هائلة لتعميم المعرفة، ومن جهة أخرى، تحمل مخاطر تعميق الفجوات الاجتماعية. فبينما يتمتع 68 في المائة من سكان العالم بالوصول إلى الإنترنت، تنخفض هذه النسبة بشكل صادم إلى 27 في المائة فقط في الدول المنخفضة الدخل.
هذه الفجوة الرقمية المروعة تعني أن ثلث البشرية ما يزال معزولاً عن فرص التعلم التي توفرها التقنيات الحديثة.
وفي مفارقة لافتة، قد تؤدي الثورة الرقمية ذاتها إلى تفاقم الأمية عبر تعزيز ثقافة الاستهلاك السطحي للمعلومات. تشير تحليلات برنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA) إلى تراجع ملحوظ في الأداء القرائي عالمياً، وهو ما يرتبط بوضوح بالمشتتات الرقمية التي تؤثر سلباً على قدرة الدماغ على التركيز. كما تُظهر الدراسات انخفاضاً في فهم المقروء عند القراءة على الشاشات مقارنة بالورق. ومع هيمنة ثقافة المحتوى السريع، تترسخ عادات استهلاك سطحية لا تبني مهارات التحليل النقدي.
من هنا، فإن التعامل مع هذه التحديات المعقدة يتطلب تبني نهج متوازن يجمع بين الاستفادة من فرص التقنية والمحافظة على قيم التعليم الأصيل. هذا ما يمكن أن نسميه «محو الأمية المزدوج»، وهو نهج يهدف إلى بناء جيل متمكن من مهارات القراءة والكتابة التقليدية إلى جانب المهارات الرقمية المتقدمة. ويمكن تطبيق هذا النهج من خلال اعتماد أطر عمل عالمية مثل إطار «اليونيسكو» لكفاءات المعلمين، وتعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة مع «الألكسو»، لتنفيذ خطط تركز بشكل خاص على النساء والمناطق الريفية.
وفي الأخير يجب أن نتفق على أن الرقمنة ليست غايةً في حد ذاتها، بل هي أداةٌ فائقة القوة يمكن أن تكون جسراً نحو المعرفة، أو سيفاً يقطع صلتنا بجذورها. إن التحدي الأعمق لا يكمن في الاختيار الساذج بين حبر الماضي وضوء المستقبل، بل في حكمة نسج خيوطهما معاً في ثوب حضاري واحد. فالحرف المنقوش على الورق ليس مجرد رمز، بل هو حاملٌ لذاكرة الأجيال وسحر التأمل البطيء، بينما تفتح لنا الشاشات نوافذ لا متناهية على الإبداع الإنساني. إن مهمتنا التاريخية اليوم هي أن نضمن ألا يتحول هذا الفيضان الرقمي إلى طوفان يغرقنا في السطحية، بل أن يصبح نهراً يروي ظمأ العقول للمعنى. عندها فقط، سنكون قد أوفينا بوعد المعرفة الحقيقية: عالمٌ لا يقرأ فيه الإنسان ليعرف فحسب، بل ليصبح أكثر حكمةً وإنسانية، في فضاءٍ رقميٍ ينبض بروح القيم، ويتسع لآفاق الكون.
* كاتب سعودي