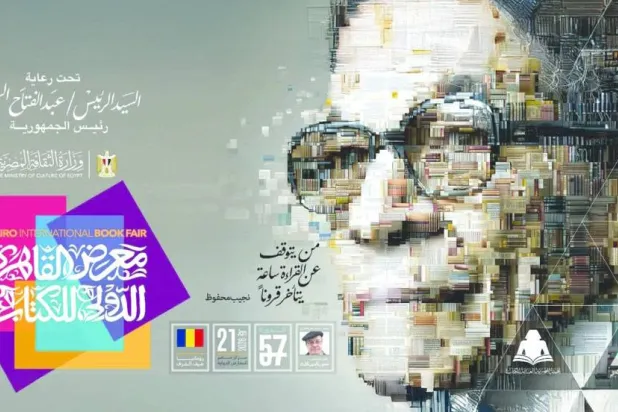يروي المترجم محمد الفولي في كتابه «النص الأصلي - عن الترجمة ومسارات الحياة» الصادر عن دار «الكرمة» بالقاهرة فصولاً من كواليس وخفايا الترجمة الأدبية بين اللذة والمعاناة، انطلاقاً من تجربته الشخصية كمترجم قدّم للمكتبة العربية 28 كتاباً عن الإسبانية، فضلاً عن 4 كتب قيد النشر.
ويضرب الفولي مثالاً شديد الدلالة بأزمة المترجم مع السياق العام، الذي قد يبدو غامضاً أحياناً، فيتسبب الأمر في مشكلات كارثية، مشيراً إلى أن «أفضل مثال مبدئي يمكنني طرحه لإيضاح قدرة السياق على تحديد المعنى المقصود في الترجمة هو
رواية (العصامي) للكاتب التشيلي إيرنان ربييرا ليتيلير، التي تدور أحداثها كأغلب رواياته في مستوطنات الملح الصخري في صحراء (أتاكاما) التشيلية».
ويضيف: «حين عرض الناشر على الفولي الاشتغال على الرواية، طلب كالعادة مهلة زمنية لقراءتها كي يحدد أولاً ما إذا كانت ستروقه أم لا، وثانياً لمعرفة ماهية الصعوبات التي قد تعرقله أثناء هذه المهمة، وبناء على هذا تحديد المهلة الزمنية المتوقعة لتسليم الترجمة».

النصّ وسياق الحياة
الغريب أنه حين بدأ الفولي القراءة شعر بعجز تام أمام النصّ حتى إنه لم يفهم نسبة تكاد تقارب الربع من مفرداته، التي لم تتوافق قط مع السياق الذي ظهرت فيه داخل الكتاب. وليس مرد الأمر تقعير لغوي مبالغ فيه استخدمه المؤلف التشيلي، ولا إلى وجود تركيبات طويلة من الفقرات الملأى بجمل اعتراضية، يصعب معها استشفاف المعاني.
بل ارتبطت المسألة برمتها، كما يوضح، بسياق الحياة الاجتماعي والتاريخي في هذه المستوطنات التي تبعثرت هنا وهناك، وسط صحراء «أتاكاما» الشاسعة، «وهذا لم يخلق لهجة أو لغة جديدة فحسب، بل سياقاً لغوياً اكتسبت فيه الكلمات معاني مختلفة عن معانيها الأصلية ومفردات جديدة تماماً. حدث كل هذا طبعاً على أرض الواقع، وتعمد ليتيلير أن ينقله كما هو إلى صفحات أغلب رواياته، التي تتناول الحياة في هذا العالم».
لم يستسلم الفولي لإحساسه بالعجز، بل بدأ العمل بهدوء بعد تلاشي آثار الصدمة، وتحديد دوائر البحث الأولية. وفي الوقت نفسه، بدأ عملية البحث في المصادر التاريخية التشيلية لمعرفة كيف ظهرت صناعة الملح الصخري؟ ولماذا استمرت هذه المدة؟ وكيف انتهت؟ ولماذا بُنيت هذه المستوطنات أصلاً في وسط الصحراء؟
بعد بحث مضنٍ وطويل، تضمن تجربة عدد لا بأس به من الكلمات المفتاحية المحتملة، انفتحت أبواب «الفردوس الإلكتروني» حين ظهر له رابط سحري قاده إلى تحميل نسخة ضوئية رقمية لقاموس صادر عن جامعة تشيلي عام 1934. وحين اطلع على الملف، تهللت أساريره، لأن عنوانه هو مفردات الملح الصخري. كان عجزه منطقياً، فقد خلق عالم مستوطنات الملح الصخري سياقه اللغوي الخاص، إلى درجة أن جامعة تشيلية كلّفت نفسها عناء إصدار قاموس يوضح معانيه.
هكذا تمكن محمد الفولي، عبر هذا القاموس السحري، من حلّ الأزمة، وتبين على سبيل المثال لا الحصر أن كلمة «buque» التي إن بحث المرء عنها في أي قاموس من الإسبانية إلى العربية، أو أي قاموس أحادي اللغة، بما فيها قاموس «الأكاديمية الملكية الإسبانية»، فسيجد أن معناها «سفينة» أو «باخرة» أو «مركب»، لكن هنا وتحديداً في السياق اللغوي لمستوطنات الملح الصخري يغدو معناها «سكن العُزاب». هكذا تمنطق كل ما بدا شاذاً، فمن المستحيل وفقاً للسياق أن يعيش بطل العمل ومن معه في سفينة أو باخرة وسط الصحراء، لكن أن يعيشوا في سكن للعزاب أمر يقبله العقل.
كذلك، عرف أيضاً أن كلمة «oficina » التي إن بحث عنها المرء في أي قاموس وفقاً لكل التصنيفات التي ذكرناها سلفاً، فسيجد أن معناها «مكتب»، لكن معنى هذه الكلمة داخل هذا السياق اللغوي مختلف، فالمقصود هنا «المستوطنات» التي عاش وعمل فيها هؤلاء القوم الذين جابهوا حرّ الصحراء وشمسها القاسية وزوابع رمالها نهاراً وبرودة خلائها ليلاً. تلك الأماكن التي أنشئت فيها مدارس ومقاصف ومطاعم وأماكن ترفيه بدائية، بما فيها السينما، وكانت تفكك مع انتهاء العمل في كل منجم يجاورها لتنقل العائلات التي سكّنتها إلى مكان آخر تماماً في وسط الصحراء قرب أي منجم جديد.
من المفترض بالنسبة للمحرر الأدبي الجيد ألا يتدخل في النص المترجم إلا إذا استدعت الحاجة
تدخل المحرر الأدبي
ويشير الفولي إلى نقطة أخرى، تتعلق بعمل المحرر الأدبي، وهو يعتقد أنه «من المفترض بالنسبة للمحرر الجيد، الذي يعمل لدى الناشر، ويشتغل على نسخة المترجم، ألا يتدخل في النص المترجم إلا إذا استدعت الحاجة، وألا يمارس (تغييرات صبيانية) من دون داعٍ، لكن ما يحدث على أرض الواقع يأتي أحياناً عكس ذلك». ويذكر أنه شاهد هراء كثيراً في «تحرير» بعض من ترجماته، ومنها أشياء كادت تصيبه بالجنون، وتعلقت بإدخال تغييرات من دون أي سبب أو منطق واضح، فهي تغييرات لمجرد التغيير!
على سبيل المثال، يغير محرر ما جملة «من جهة أخرى» إلى «من جانب آخر»، فيقول الفولي: «حسناً ربما هذه صيغته المفضلة. وذات مرة، استخدم المترجم عبارة «شُغل عيال» التي تنتمي إلى العامية المصرية، لكن يمكن قراءتها بالفصحى ومفهومة من المحيط إلى الخليج، لكن المحرر قام بتعديلها إلى «أفعال صبيانية»، مع أنها وردت في النص الأصلي بمصطلح دارج يوازي في طبقته اللغوية كلمتي «شغل عيال».
ويتوجه الفولي في نهاية الكتاب بعدة نصائح أو رسائل من واقع تجربته العملية إلى المترجمين الشبان، مؤكداً أن الفشل من ثوابت الحياة. ليس عثرة، إنه جزء من الطريق، بل الطريق الوحيد نحو النجاح.
ويضيف قائلاً: «قد تفشلون في فهم المعاني وفي تقديم أفكاركم وفي صياغة عروضكم أمام الناشرين، ومع كل مرة تلعنون فيها أنفسكم أو العالم ستضعون أياديكم على مكمن الخطأ، ستقبضون عليه بأصابعكم المرتعشة من فرط الندم أو الغضب. هكذا فحسب ستعرفونه وستعترفون به، وحينئذ لن تكرروه. لا أحد يفوز دائماً. الأفضل هو من يخسر وينهض ويقاوم، لأن من يستمر في المقاومة لا ينهزم أبداً».