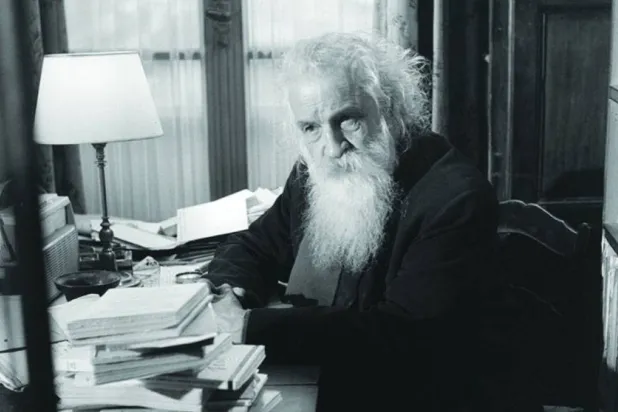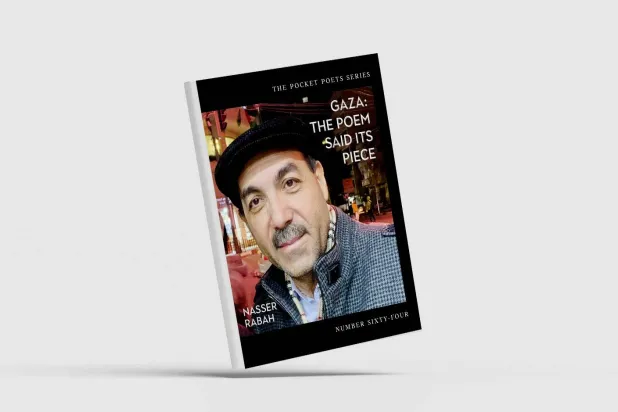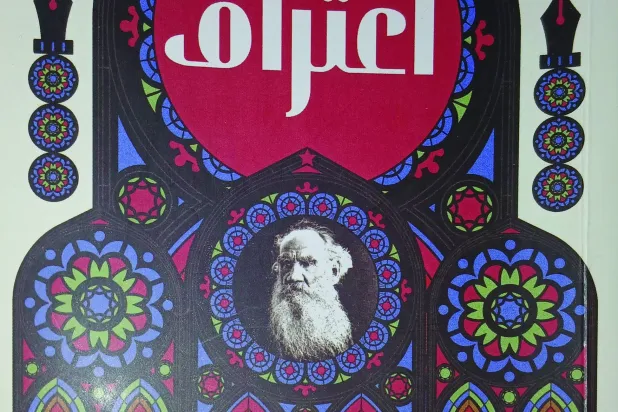في مقالة سابقة، نقلتُ رأي غلين ماغي، الذي وصف فلسفة هيغل بأنها مفعمة بالرموز الهرمسية والتأويلات الباطنية، حتى إنه تساءل إن كان هيغل فيلسوفاً حقاً، أم منظّراً من طراز غنوصي عريق. ولقي هذا الطرح تفاعلاً كبيراً، لكنه في الوقت نفسه أثار تساؤلات تستحق التأمل والمراجعة. هل يُنصف هيغل، بوصفه أحد أعظم أنظمة الفلسفة العقلية في التاريخ، أن نردّه إلى مجرد نزعة صوفية درويشية؟ الصورة أكثر تعقيداً. فهيغل، في بداياته، كان بالفعل أقرب إلى التصوف. كان يعيش في بيئة صوفية ألمانية، وتأثر بأفكار يعقوب بوهمه، كما اطلع على تراث المتصوفة المسيحيين في عصرهم الذهبي في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. أولئك الذين مزجوا بين الحدس والفكر، وبين الكليّ والجزئيّ، وبين حضور الروح وحركة العقل. في كتاباته المبكرة، مثل «روح المسيحية ومصيرها»، كان مشغولاً بمفاهيم الاتحاد بالكل، والتجاوز الحدسي للحدود، والانخطاف الذي يتجاوز الثنائية بين الذات والموضوع. هذه البدايات لا يمكن إنكارها، ولا ينبغي التهوين منها. فهي تمثّل حجر الزاوية الذي انطلقت منه رحلته العقلية، رحلة الروح الثلاثية.
لكن هذه المرحلة لم تكن النهاية. شيئاً فشيئاً، بدأ هيغل يُخضع تلك الرؤى الحدسية لمنهجية عقلية متينة، ويعيد تأويل التجربة الصوفية في ضوء مسار جدلي متكامل. مثل معظم عظماء الفلاسفة الألمان، لم يرفض التصوف، بل احتواه داخلياً، وأعاد بناءه من الأساس. وكما لاحظ فريدريك كوبلستون في دراسته «هيغل وعقلنة التصوف»، فإن هيغل لم يكن صوفيّاً بالمعنى الساذج، بل فيلسوف عقلاني استخدم التصوف منجماً للمعنى، وأخضعه لبنية جدلية دقيقة.
التصوف، عند هيغل، لا يعني الانفصال عن الفكر أو الطيران في عوالم اللاعقل، بل يشكّل لحظة من لحظات تطور الوعي في سعيه نحو المطلق، وكيف بنى البشر حضاراتهم في أثناء الرحلة.
وقد استلهم من المتصوفة، لا سيما بوهمه ومايستر إيكهارت، فكرة الاتحاد بالكل، لكنّه أصرّ على إعادة تنظيم تلك الرؤى الحدسية ضمن منطق جدلي عقلاني يُفكّر بها دون أن يُفرّغها من قوتها الشعورية. لقد استبقى من التصوف عمقه، وحرّره من غموضه.
وتأكيداً لوجود الاتجاه المبكر، وجدنا هيغل في شبابه يكتب قصيدة رمزية بعنوان «إليوزيس»، مستوحاة من الطقوس الغامضة لمعبد إليوسيس اليوناني، وملأها بالإشارات إلى «الكهنة» و«الحكمة الخفية» و«الرموز المضنون بها». ورغم أن القصيدة لا تُعدُّ عملاً شعرياً عظيماً، فإنها تُظهر تلهف هيغل الشاب لاختراق الحجب، وكشف المستور، وتوقه إلى معرفة تتجاوز المألوف، وتساؤله حول قدرة اللغة على حمل المعنى الباطني. لقد كانت تلك القصيدة بمثابة اعتراف شعري بأزمة الحدس، كأعمى يتحسس طريقه في الظلام، وسعيه إلى بناء فهم أمتن. إنها لمحة نادرة عن عقل يتأرجح بين الخشوع الغامض والرغبة في الفهم، عقل سينتقل لاحقاً من القصيدة إلى النسق، ومن الرمز إلى المفهوم.
أما غلين ماغي، فقد أصاب حين أشار إلى أثر الهرمسية والرمزية في فكر هيغل، لكنه أخطأ حين تعامل مع هذا البُعد بوصفه قطيعة مع العقل، أو خيانة للفكر الفلسفي. فالحقيقة أن التصوف، كما ظهر عند هيغل، لم يكن نقضاً للعقل، بل أحد تجلياته. تجربة الصوفي، في صورتها الهيغلية، ليست رفضاً للتفكير، بل إدراك حدوده، والسعي لتجاوزها من داخله، لا عن طريق النفي، بل عن طريق التصعيد الجدلي. لم يكن العقل عنده سجناً، بل الجسر الذي يفضي إلى الحرية.
لقد بيّنتُ أن غلين ماغي فصل التصوف عن العقل، لكن التصوف، بعمقه وحدسه، هو فعل عقلاني أيضاً. حجة ذلك أننا في تقاليد الهند، نجد آلاف الكتب التي تعلن الحرب الفكرية على العقل، لكن هل كان ممكناً أن يفعلوا هذا بدون العقل؟ لا أحد يهرب من العقل. والخلاص منه وهم، أما الكمال فليس في إسقاطه، بل في إدماجه.
ومن هنا تكتسب عبارة برتراند راسل قيمتها الكبيرة، حين قال «إن الاتحاد الحقيقي بين الصوفي ورجل العلم هو أسمى ما يمكن أن يبلغه الإنسان في عالم الفكر». لقد رأى راسل أن المثالي ليس الانقسام بين الإيمان والعقل، ولا بين الحدس والتجريب، بل لحظة الجمع والانسجام. وهذه اللحظة النادرة هي عرش الفكر الذي سعى هيغل للجلوس عليه.
الكمال لا يتحقق في العقل وحده، ولا في التصوف وحده، بل في لحظة اتحادهما. اللحظة التي لا يُلغى فيها أحدهما لصالح الآخر، بل يُركّبان في هيئة جديدة. هيغل، في هذا المعنى، لم يكن مجرد صوفي عقلاني، ولا عقلانيّاً متصوفاً، بل كان المفكر الذي حاول أن يضمّ في فلسفته تلك الثنائية التي طالما شطرت الروح الإنسانية، فلا تبقى ثنائية.
وإذا شئنا الدقة، فإن مشروع هيغل يعلّمنا فقط كيف نفهم التصوف، ويعلمنا كيف نحفظ له كرامته الفكرية. لقد كان يعي أن لكل حدس روحي مكمناً عقلياً، وأن كل لحظة إشراق لها جذر في التجربة والتأمل. التصوف، حين يُنظر إليه بوصفه اجتهاداً داخلياً لفهم المطلق، لا يقل صرامة عن أي نشاط فلسفي آخر، بل قد يكون أكثر توتراً، لأنه يركض على الحافة القصوى للعقل. وهيغل، حين أعاد تأطير هذه الحركة، لم يكن يروّضها أو يدجّنها، بل منحها ما لم تمنحه لنفسها: وضوح البناء وصرامة المبدأ.
من هنا نفهم كيف يمكن للفلسفة أن تكون روحانية من غير أن تهجر الفكر، وكيف يمكن للحدس أن يستقيم في طريق العقل دون أن يُبتَر. إن فهم هيغل للتصوف لا يكشف عن ميول باطنية ضبابية، بل عن تصميم وجودي على جعل التجربة الداخلية قابلة للفهم، دون أن تُنتَزع منها شرارتها الأولى.
* كاتب سعودي