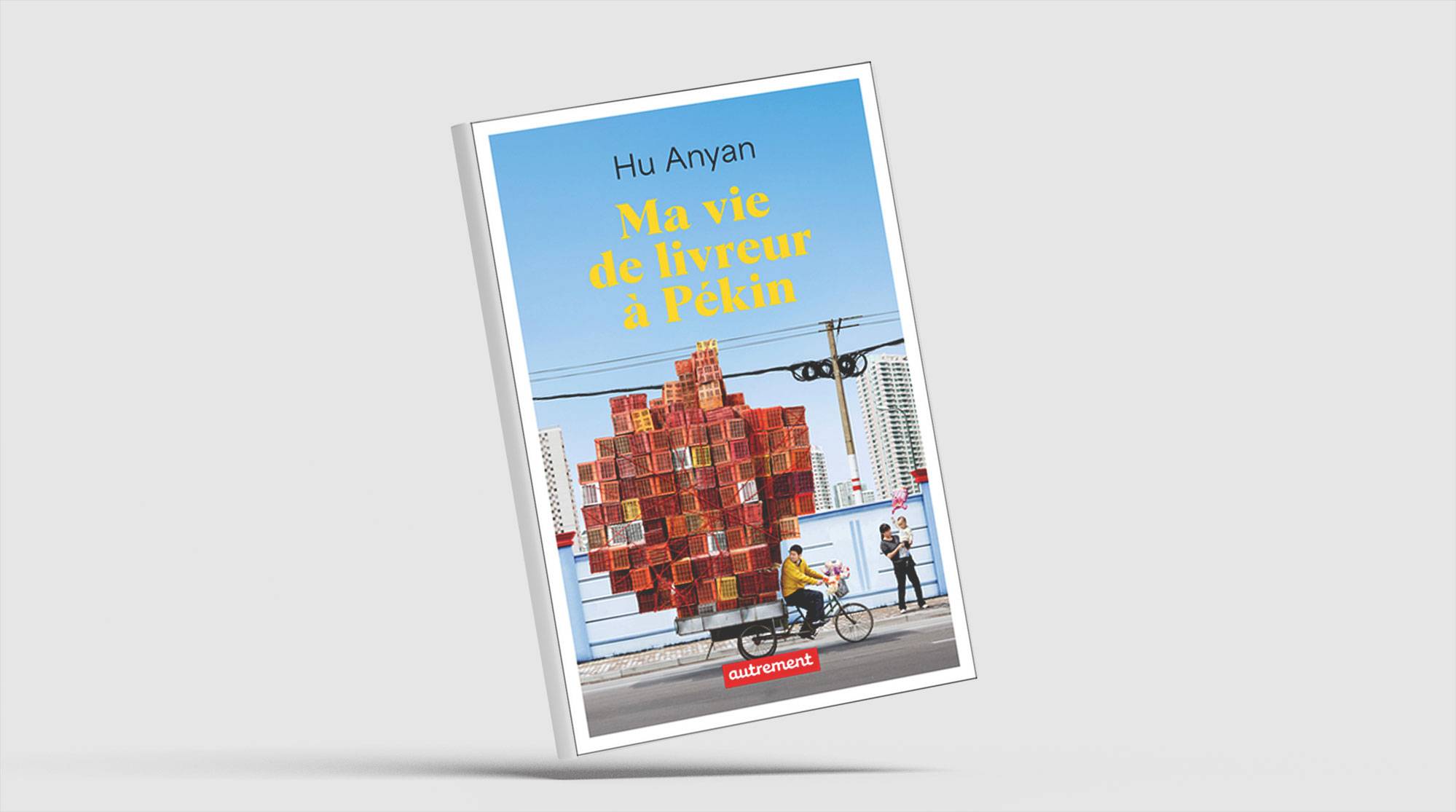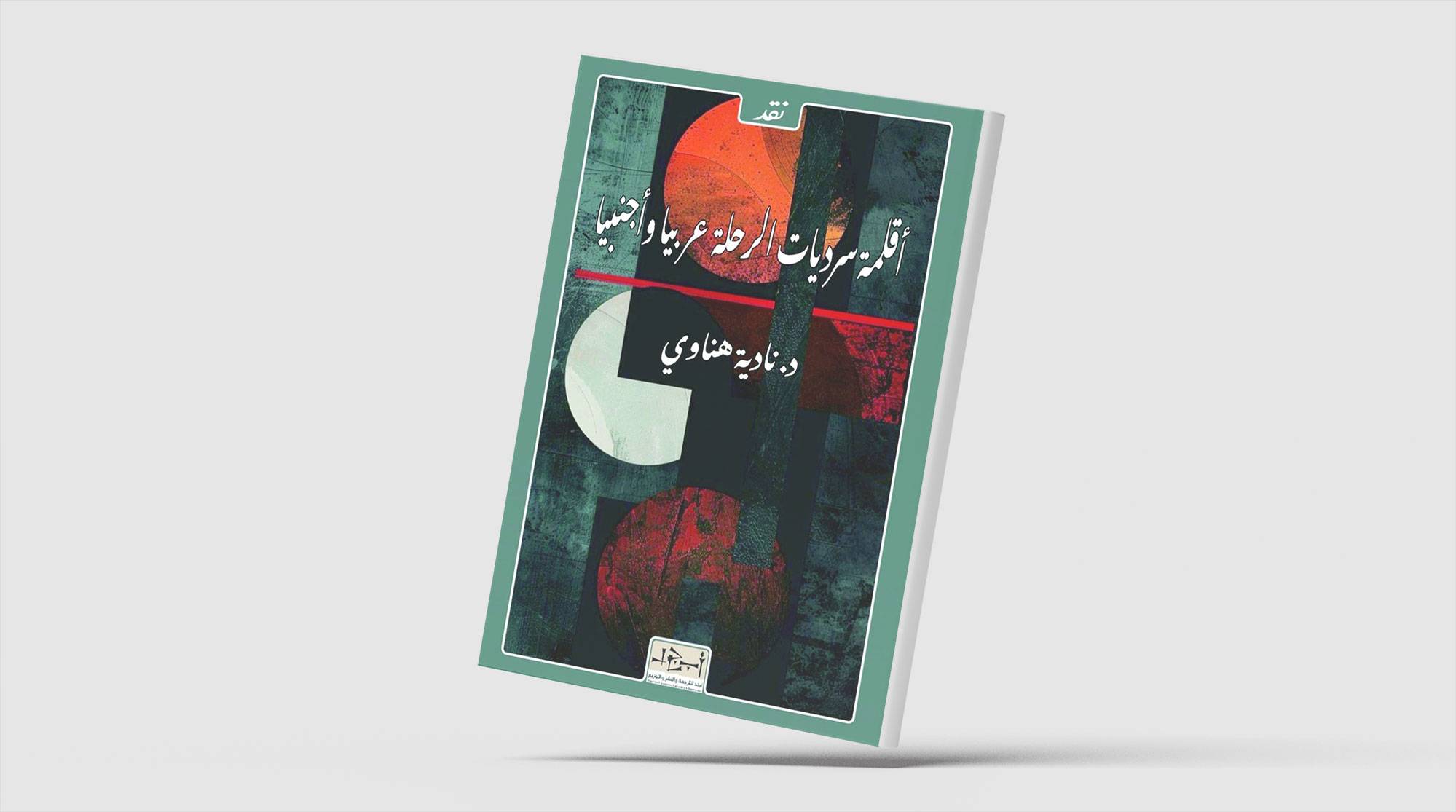«لقد كُتبت شهرة كازانوفا بجميع اللغات، حتى أنه يفوق في عالميته معاصريه غوته وفريدريك الأكبر، فمن أقصى شمال العالم إلى جنوبه يبتسم الملايين لذكر اسمه في حين أنهم لا يعرفون عن الآخرين من العظماء سوى معلومات جافة. لقد غطى تألقه على بريق الملوك والشعراء في عصره، حتى ليُعتبر أشهر رجال القرن بعد نابليون، الذي قُورن به في معرض الفكاهة».
لم أجد ما أستهل به هذه المقالة عن جياكومو كازانوفا أفضل من هذا النص الذي كتبه الناقد الألماني إميل لودفيغ عن المكانة التي احتلها كازانوفا في نفوس القراء والمهتمين من شرق العالم وغربه. على أن ما كتبه لودفيغ، لم يكن ليختلف بشيء عما كتبه نقاد آخرون فائقو الأهمية من طراز ستيفان زفايغ وهافيلوك أليس وجيمس ستيوارت، الذي رأى في حياة العاشق الإيطالي المغامر، نوعاً من «أوديسة صغيرة كتبها رجل قُدّر له أن يتخذ مكاناً له بجوار الخالدين في الأرض».

وإذا كانت الكتابة عن كازانوفا (1725 - 1798م) تأتي في سياق الكتابة عن رموز العشق الغربي، فإن ما يميزه عن الآخرين هو كونه لم يولد من رحم المخيلات والتصورات الصرف، كما كان شأن تريستان وروميو ودون جوان، بل ولد من الأحشاء الحقيقية للقرن الثامن عشر، حيث كانت التقاليد القديمة تتصارع مع الجديدة، والشعوذة مع العقل، والديني مع الدنيوي.
ويكفي أن نتتبع سيرة كازانوفا الشخصية، لكي نشعر أننا إزاء شخص متعدد الهويات والطبائع، بحيث يظهر أحياناً في صورة شيطان، وأحياناً أخرى في صورة ملاك، وأحياناً ثالثة يتحول إلى مزيج غريب من هذا وذاك. ولأن له سمات الأعاصير، فقد كان كازانوفا لا يميز بين بيضاء أو سمراء، متزوجة أو عزباء، فقيرة أو موسرة، بل يرى في كل امرأة يصادفها بصمة مختلفة من بصمات الأنوثة الكونية، وتسوقه رغباته إلى القيام بمجازفات لا تخطر على بال.
وإذ يطلعنا كازانوفا في مذكراته على أن الهوس بالنساء، بخاصة الممثلات والمغنيات والراهبات، هو جزء من تراث عائلته القديم، يشير إلى رحيل أبيه المبكر، وإلى قرار أمه الفتية العزوف عن الزواج، موثرة التفرغ لتربية أطفالها. ومع أنه يشير بعد ذلك إلى انحراف صحته ونحوله المرضي وفقر عائلته اللاحق، فإنه يشير أيضاً إلى أنه استهل مغامراته العاطفية وهو بعد في العاشرة، مع زميلة له في الدراسة تكبره بسنوات ثلاث. ولعل من أكثر المفارقات غرابة هو انخراطه في السلك الكهنوتي، نزولاً عند رغبة بطريرك البندقية. على أنه لم يكتف بالدور الجديد الذي أنيط به، بل أضاف إليه دور الواعظ، ليلقي على الملأ خطباً دينيةً تحث على الفضيلة والتقوى.
الأرجح أن قبول كازانوفا القيام بمهمة رجل الدين لم يكن انصياعاً محضاً لرغبة البطريرك، بقدر ما كان استجابة لنوازعه النفسية الدفينة التي تجعل منه ساحة للعراك الضاري بين المقدس والمدنس، وبين الجسدي والروحي. والأدل على ذلك هو مسارعته إلى إقامة علاقة غرامية مع ابنة أخ القسيس المشرف على تدريبه، وإلى إقامة علاقة متزامنة بين شقيقتين، إضافة إلى علاقته بامرأة متزوجة سببت له مرضاً تناسلياً، كما تسببت بصرفه من السلك الكهنوتي. وفي معرض عدم تمييزه بين امرأة وأخرى، إلا من حيث الجاذبية، يكتب كازانوفا في مذكراته أنه التقى بمغنية مشهورة وبرفقتها خادمة سمراء، ليضيف قائلاً «ومع أن المغنية كانت فتية وجميلة، فهي لم تثر في نفسي أي رغبة، حيث كانت حسناء أكثر مما يجب وبدينة أكثر مما يجب. ولأن خادمتها كانت على العكس من ذلك، سمراء وساحرة ذات قد ممشوق وعينين وضاءتين، فقد وقعت في حبها على الأثر».
أما قصة الحب التي جمعت بين كازانوفا ومجدالا، إحدى راهبات البندقية الجميلات، فقد تكون واحدة من أكثر القصص التي عاشها غرابة وإثارة للدهشة، الأمر الذي دفع الكاتب الفرنسي برتران دي نورفان إلى جعلها محوراً لروايته «كازانوفا»، التي تدور وقائعها في عام 1757، والتي تجمع بين السرد المشوق والحبكة الغنية بالمفاجآت. وفيها يعرض المؤلف لانغماس كازانوفا في عوالم البندقية الباذخة، بخاصة عالمها الليلي، بما يضمه من أوكار الجنس وأندية اللهو والقمار، التي يؤمها القناصل والسفراء وفاحشو الثراء، وصولاً إلى زجه بتهمة القتل في سجن «الرصاص»، وهروبه اللاحق بحيلة ماكرة.
كما يظهر كازانوفا مزاوجة ناجحة بين نظرته الأبيقورية إلى الحياة، ورشاقة اللغة ومهارة الأسلوب السردي، فيكتب في مذكراته «إن الحب هو أكثر الأشياء مكراً ودهاء، وأكثر ما تتجلى عبقريته وسط الصعاب. ولما كان مجرد وجوده يتوقف على إمتاع الذين يتفانون في عبادته، فإنه ينتزع النجاح من أعماق الحالات المحفوفة باليأس. لا بل إنه يخلق بنفسه المناسبات والملابسات التي تحقق هذا النجاح».
ولأن كازانوفا كان يضيق ذرعاً بكل أرض يقف فوقها أو ثروة ينولها أو امرأة تطولها يداه، فقد آثر مغادرة البندقية بحثاً عن مغامرات مثيرة ونساء جديدات وملذات غير مألوفة، فيمّم وجهه شطر لندن، ثم غادرها قاصداً برلين، وصولاً إلى روسيا، حيث تمكن بمساعدة الأمير العابث كارل فون كورلاند من الانغماس في مجتمعها المخملي. وحيث راح يتنقل بعد ذلك بين بولونيا والنمسا وباريس وإسبانيا، كان صيته كفاتن للنساء، يسبقه إلى كل مدينة يزورها، ويقوده إلى الكثير من المزالق.
على أن ثمة انشطاراً في شخصية كازانوفا تتسع دائرته لتطول كل جوانب حياته التي توزعت بين قمم العيش وسفوحه. فهو من جهة جوّاب الأمصار الذي يمتطي أثمن الخيول وينزل في أفخم الفنادق، ويجالس ملوك عصره وفلاسفته الكبار، من أمثال لويس الخامس عشر وفردريك الكبير وبابا روما وكاترين الثانية وفولتير، وهو من جهة ثانية المتشرد البائس ونزيل السجون والمقامر بكل شيء حتى بحياته نفسها. ومع وقوفنا ذاهلين إزاء تهالك كازانوفا المفرط على المتع الحسية، تستوقفنا الإشارات الدالة على وهنه المبكر، التي بدأ بإطلاقها قبل بلوغه الأربعين. فهو يعلن إثر قدومه إلى لندن بأن المؤثرات الساحرة لشخصيته، التي أوقعت في حبائله مئات النساء، قد أوشكت على البطلان، فيكتب حرفيته «لقد سجلت تاريخ سبتمبر 1763، باعتباره لعنة من لعنات حياتي، ولقد شعرت أن تيار الكهولة يحملني، مع أنني كنت في الثامنة والثلاثين من عمري».
وإذا كان البعض يرد هذا الشعور المبكر بوطأة الزمن إلى تجربة كازانوفا الفاشلة في لندن، حيث المجتمع الإنجليزي الرصين لا يُغزى بسهولة، وحيث الطباع الباردة لهذا المجتمع لا تتلاءم مع الدم الحار للعاشق الايطالي، فإنه لا يلبث أن يكتب في الخمسين «لقد فكرت في أيامي الخالية، ورثيت مسلكي ولعنت الخمسين التي شارفتُ بلوغها، والتي قضت على جميع أحلامي. ولقد حز في نفسي ألا أرى أمامي سوى بؤس الشيخوخة والبطالة والفاقة، وألا تغذيني سوى شهرة مريبة وحسرات عقيمة». وقد يكون الإنفاق السريع لرصيده من الشهوة واندفاعة الدم، هو السبب الأبرز لشعوره المبكر بأعراض الكهولة والسأم والإشباع.
وإثر عودة كازانوفا موهناً ومهيضاً إلى مدينته الأم، عينته محكمة التحقيق مخبراً سرياً يعمل لحسابها. ولعل أكثر ما آلمه في تلك الفترة، لم يكن راتبه الزهيد فحسب، بل تكليفه بكتابة تقارير مفصلة عن الفساق والخلعاء والملحدين، في واحدة من أكثر سخريات القدر مدعاة للدهشة والضحك المر. وبعد أن قطعت السلطة مرتبه نظراً لسوء أدائه الوظيفي، راودته رغبته القديمة في المغامرة فغادر البندقية باتجاه فيينا، ومن ثم أمستردام وباريس وصولاً إلى بوهيميا، حيث استطاع بمساعدة الكونت فون فالدشتاين أن يسترد بعض ما فاته من مباهج العيش وملذاته. كما اعتراه حينها شغف بالغ بالقراءة والتحصيل المعرفي، وانصرف إلى الكتابة والتأليف، لينجز أعمالاً عدة وبحوثاً في الفلسفة والأخلاق والدين، وصولاً إلى مذكراته الشهيرة التي اعتبرها النقاد أفضل أعماله، وأكثرها دلالة على لغته المتوهجة وسرده المشوق.
ورغم أن حياة كازانوفا كانت غنية بالمفارقات والألغاز التي أثارت حيرة نقاده وقرائه على امتداد العصور، فإن موته لم يكن أقل مثاراً للحيرة من حياته. لأن المؤرخين لم يجمعوا على المكان الحقيقي الذي تم دفنه فيه، بحيث تحول موته كحياته إلى متاهة، فكان شريداً لسطح الأرض وباطنها في الآن ذاته.