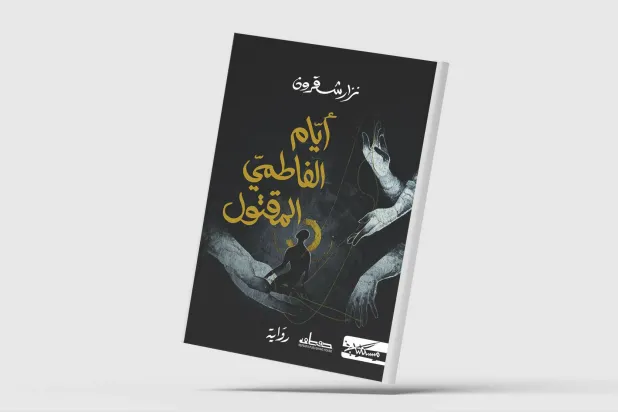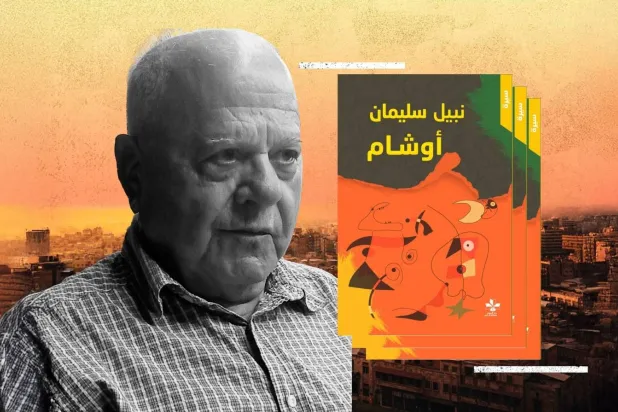من يستطيع أن ينسى الحب الأول؟ ليس أبو تمام طبعاً؛ ما الحب إلا للحبيب الأول... وليس جان جاك روسو أيضاً؛ أي ليس ذلك الشخص الذي ظلّ يحن إلى حبيبته الأولى «مدام دو فارين» ويتوجع عليها ويتفجع. فبعد مرور خمسين عاماً على بداية لقائه بها نجده ينفث نفثات الصبّ الموله لدى ذكراها. ومعلوم أنها المرأة التي غيّرت مجرى حياته، فانتقل لأجلها من البروتستانتية إلى الكاثوليكية، قائلاً: «إن مذهباً يعتنقه مبشرون من أمثالها سوف يقود حتماً إلى الجنة».
في شتاء العمر، عندما يتهيأ المرء للرحيل الأبدي وينسى كل شيء، كان آخر نصّ كتبه ناقصاً، وكان موجهاً إليها؛ إلى تلك المرأة الخالدة. كان موجهاً إلى تلك المرأة التي أنقذته يوماً ما والتقطته من الشارع تقريباً. كان موجهاً إلى تلك المرأة التي آوته واحتضنته عندما كان ضائعاً مشرداً على الطرقات والدروب...
ينبغي أن يقرأ المرء تلك الصفحات «القاتلة» التي كرّسها روسو لهذه المرأة على مدار اعترافاته أو مذكراته. وربما توقف القارئ أو تسمَّر بصره عند ذلك الموقف العجيب والأخّاذ حيث رآها روسو لأول مرة. من يستطيع أن يصف اللقاء الأول للحبّ؟ من يستطيع أن يسترجعه ويتذكر الشرارة الأولى؟ أي متعة في ذلك، وأي حسرة؟! أين هي السينما أو الكاميرا التي تستطيع أن تصور الحادثة مثلما صوّرها روسو عندما ناداها من الخلف، فاستدارت، فرأى وجهها لأول مرة؟ وردة الوردات، شمسٌ ساطعة... كانت آنذاك في عزّ شبابها.
لم يحبّ جان جاك روسو «مدام دو فارين»، وإنما قدسها؛ كانت أكبر من أن تُحبّ أو تُشتهى. لأجلها غيّر مذهبه وطائفته، لأجل «سواد عيونها»... ومعلوم أن تغيير المذهب في ذلك الوقت كان أصعب عليك من تجرع السم الزعاف. نقول ذلك وخاصة أن المذهب الكاثوليكي كان يعدّ بمثابة العدو اللدود للمذهب البروتستانتي الذي تربى عليه روسو في جنيف، والعكس صحيح أيضاً. لكن لنستمع إليه يتحدث عنها في كتاب «الاعترافات» الشهير:
«لن أنتهي من الحديث عنها مهما طال إذا ما دخلت في تفاصيل كل الحماقات والأعمال الجنونية التي كنت أرتكبها عندما لم أكن تحت بصرها وعندما كانت ذكراها تعمر قلبي. كم من المرات رحت أقبّل السرير لأني أعرف أنها كانت قد نامت فيه قبلي؟ وكم قبلت الستائر وأثاث الغرفة لعلمي أنها كانت تشغلها قبل لحظات وأن أناملها الناعمة قد لمست كل أشيائها؟ بل كم هويت لكي أقبل الأرض التي مشت عليها؟»...
أرجو من القارئ أن يعود إلى اعترافات جان جاك روسو فيختار منها تلك الصفحات العديدة المتبعثرة هنا أو هناك، والمتعلقة فقط بتلك السيدة الرائعة المدعوة؛ مدام دو فارين. وأرجو منه أن يتوقف عند آخر لقاء حصل بينه وبينها بعد سنوات طويلة من القطيعة والهجران. وكانت قد كبرت وتشوهت وغيَّرت السنون ملامح وجهها. وأرجوه أن يقرأ بخشوع هاتيك السطور...
كان آخر نصّ كتبه قبل أن يرحل عن هذا العالم ناقصاً. وكان مكرساً لها ولها وحدها. وقد توقف في منتصف العبارة، لأن الموت داهمه فلم يستطع أن يكمله. لم يقل كلمة واحدة عن زوجته «تيريز لوفاسير» التي كانت تعيش معه منذ أكثر من ثلاثين سنة، والتي كانت تعدّ ظاهريّاً بمثابة قرينته، ولكنها عملياً كانت متعايشة معه مثل أخ وأخته؛ كل واحد في غرفته ما عدا السنوات الأولى. ولكنه كان يشفق عليها ويحترمها ويتحمل مسؤولية نفقتها وإعالتها. وكانت تخدمه وترعاه وتوفر له الظروف المناسبة لكي يكتب ما كتب ويفعل ما فعل. ألم نقل لكم إن الحب في جهة، والزواج في جهة أخرى؟ قصة كلاسيكية... ولهذا الموضوع كرّس روايته الشهيرة التي دوّخت فرنسا.

لم تصدق مدام دو فارين أن هذا «الولد» الذي جاءها يوماً ما شريداً جائعاً، والذي تعرف كل نقاط ضعفه واحدة واحدة، قد أصبح جان جاك روسو؛ أي نبي العصور الحديثة. لم تصدق أنه أصبح النجم الساطع للآداب الفرنسية والفكر العالمي. ولذلك عندما التقيا لأول مرة بعد الفراق الطويل هوت على يديه لكي تقبلهما فتلقفها هو واحتضنها واختلطت دموعه بدموعها...
من المعلوم أن شهرة روسو كانت أسطورية. كانت الناس في مقاهي باريس تصعد على الكراسي والطاولات عندما يمر في الشارع فقط لكي تلمح وجهه، صورته، شكله. هذه الشهرة الهائلة هي التي جرّت عليه المتاعب والويلات والملاحقات الضاريات. ومعلوم أنه مات مطارداً مرعوباً مغيراً عنوانه باستمرار، بل مختفياً عن الأنظار. ستون جهة كانت تلاحقه دفعة واحدة. يريدون أن يقتلوه، أن يصفوه، أن يمصوا دمه مصّاً. كان يقول هذه العبارة البليغة: «للسقف فوق رأسي عيون وللجدران آذان». كان يعرف أنه مراقب في كل حركاته وسكناته. ممنوع أن يتنفس تنفساً. وكان يقول ما معناه؛ هناك يد تلاحقني في الظلام تريد أن تصل إليّ، أن تلسعني بأي شكل، ولا أعرف كيف أتحاشاها. كلما هربت منها لحقتني، كلما تحاشيت الحفرة وقعت فيها. ولكن لماذا يستغرب جان جاك روسو كل ذلك؟ هل يعتقد أنهم سيلاقونه بالورود والرياحين والأهازيج بعد كل ما فعل؟ ألا يعلم أنهم قرأوا كتاباته حرفاً حرفاً؟ قنابل موقوتة، حرائق مشتعلة... لقد فكّك في مؤلفاته كل التصورات العتيقة البالية وكل المفاهيم الأصولية التقليدية - بل التكفيرية - للدين المسيحي. وهي مفاهيم وتصورات كانت راسخة في العقلية الجماعية كحقيقة مطلقة لا تقبل النقاش. لقد فتح الآفاق لمفهوم آخر للدين، مفهوم منعش ومحرر، غير مفهوم القساوسة والمطارنة وبقية رجال الدين. كل العالم القديم أصبح يتهاوى تحت ضربات جان جاك روسو. كل الفكر القديم الراسخ رسوخ الجبال منذ أكثر من ألف سنة فقد مشروعيته ومصداقيته. لقد أخرج فرنسا – بل أوروبا كلها - من عصر الظلمات إلى عصر الأنوار. كيف يمكن أن يغفروا له فعلته تلك؟ لهذا السبب قال عنه غوته: «فولتير أغلق العالم القديم، وجان جاك روسو دشن العالم الجديد». وقد صدق. والدليل على ذلك أنه بعد موته بعشر سنوات فقط اندلعت الثورة الفرنسية وملأت صوره شوارع باريس، وأصبحت مؤلفاته إنجيلاً لها. بل أصبحت أفكاره المادة الأساسية لذلك الإعلان الشهير؛ إعلان حقوق الإنسان والمواطن. بعد اليوم لا طائفية في فرنسا ولا مذهبية، ولا أقليات ولا أكثريات. بعد اليوم لا يوجد إلا مواطنون ومواطنات متساوون في الحقوق والواجبات. بعد اليوم، لا يوجد ابن ستّ وابن جارية، ابن الإقطاعيين الأرستقراطيين وابن الفلاحين المحتقرين. ولمن يعود الفضل في ذلك؟ إلى جان جاك روسو وفولتير ومونتسكيو وبقية فلاسفة الأنوار الكبار. أما أساطين الأصولية الكاثوليكية والظلامية المسيحية فقد نزلوا تحت الأرض واختفوا عن الأنظار. هذه هي الثورة الكبرى التي دشّنت العصور الحديثة. هذه هي الثورة التي صفق لها كانط بكلتا يديه، وكذلك هيغل وهولدرلين وبقية العباقرة والعظماء...
.