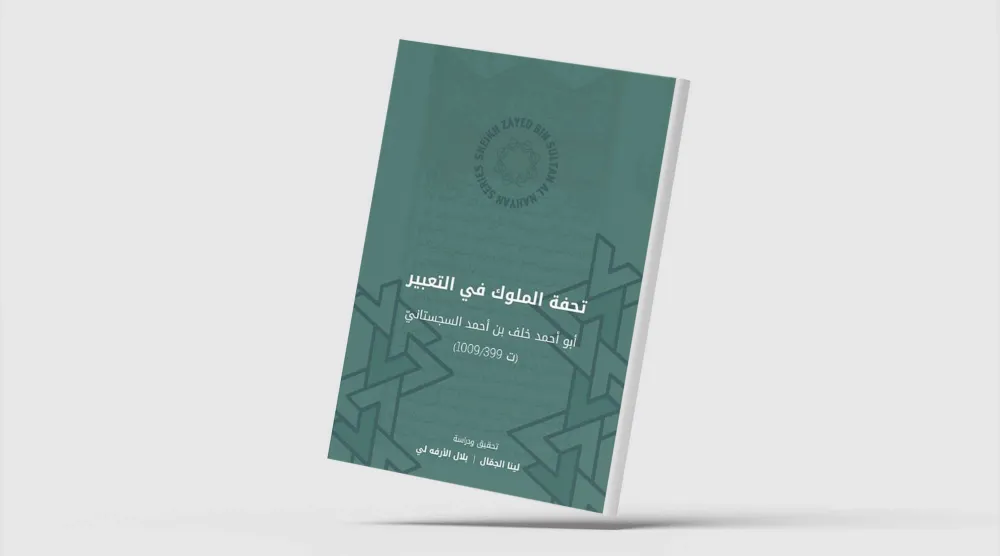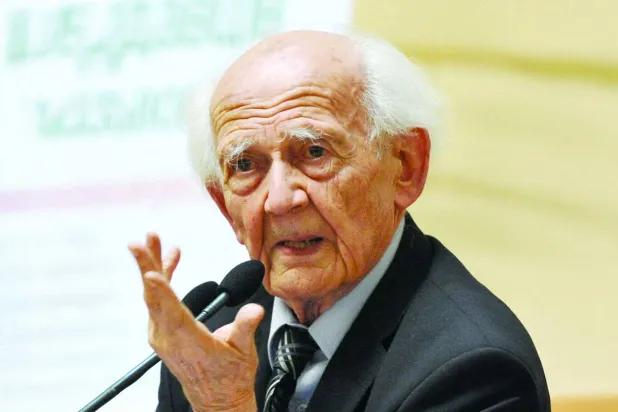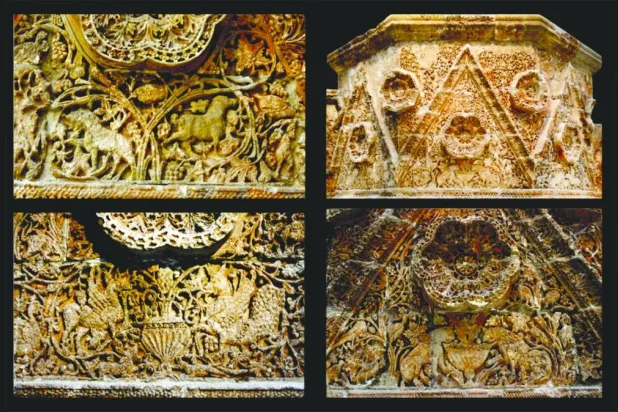في الثامن والعشرين من مايو (أيار) 2025. أسدل الستار على حياة أحد أعظم رموز الأدب والمقاومة الثقافية في أفريقيا والجنوب العالمي: الكيني نغوجي واثيونغو، الذي رحل عن عمر ناهز 87 عاماً في مدينة بوفورد، بولاية جورجيا، بالولايات المتحدة. لم يكن الراحل مجرد روائي أو كاتب مسرحي أو أستاذ جامعي، بل كان مشروعاً تحررياً متكاملاً، جعل من اللّغة ساحة اشتباك، ومن الأدب معركة لتحرير العقول من الاستعمار، ومن الكلمة فعل مقاومة، وألهمت أعماله أجيالاً متعاقبة من الكتاب الأفارقة، جنباً إلى جنب مع معاصره العملاق الآخر (النيجيري) وويل سوينكا.
وُلد نغوجي عام 1938 في بلدة ليمورو بشمال نيروبي، في كينيا، حين كان شرق أفريقيا يرزح تحت الاحتلال البريطاني، ونشأ في أسرة كبيرة من 4 زوجات و28 ابناً، وتعلّم في مدارس الإرساليات البريطانية، في الوقت الذي كان فيه إخوته يقاتلون ضمن ثورة «الماو ماو» ضد المستعمر، رفض نغوجي دائماً وصف «الماو ماو»، وأصرّ على التسمية الحقيقيّة للثائرين باللغة المحليّة، التي تعني جيش الأرض والحريّة.
تعرّضت أسرته للانقسام؛ إذ وقف بعضهم مع المستعمر، فيما قاتل آخرون من أجل التحرر، وعن ذلك كانت روايته الأولى «لا تبك، أيّها الطفل» (1964)، التي وصفها النقاد بـ«أول رواية مهمة باللغة الإنجليزية من قبل مؤلف في شرق أفريقيا». وفي مذكراته عن تلك الفترة يروي لحظة عودته إلى قريته ليجد منزل والدته قد دُمّر، والقرية تحوّلت إلى معسكر محصّن تحت قبضة الإدارة الاستعمارية. كانت تلك اللّحظة بذرة وعيه بأن الاستعمار لا يدمر الحجر فقط، بل الذّاكرة، واللّغة، والخيال.
في عام 1977، شارك نغوجي في كتابة مسرحية «سأتزوج عندما أريد»، بلغة الكيكويو المحلية، وعُرضت في قرية كينية أمام جمهور من الفلاحين. كانت المسرحية لاذعة، تسخر من فساد النّخب، وتحالف رجال الدين مع رأس المال، فأزعجت السلطات، التي اقتحمت المسرح، وأوقفت العرض، واعتقلته طوال عام دون محاكمة. في السجن، وتحديداً في زنزانة يُحتجز فيها 23 ساعة في اليوم، كتب روايته «الشيطان على الصليب» (1980)، على ورق التواليت، بلغة الكيكويو. كانت تلك بمثابة لحظة ميلاد مشروعه حياته الكبير: الكتابة بلغة الشعب، لا بلغة المستعمِر.
في أهم كتبه النظريّة «تفكيك استعمار العقل» (1986)، هاجم نغوجي الهيمنة اللغوية التي تمارسها الإمبريالية عبر النظام التعليمي والإعلام والدين؛ حيث لا تكتفي بنهب الموارد، بل تسرق الفكر والخيال، وتفرض لغتها كـ«ثقافة» و«تحضّر». وقد رأى أن اللغة ليست وسيلة اتصال فقط، بل حاملة للهوية والتاريخ، وأن فرض الإنجليزية أو الفرنسية على شعوب أفريقيا هو مجرد امتداد للاستعمار بوسائل ناعمة، واعتبر الكتابة بلغة المستعمِر شكلاً من الاغتراب الثقافي وإعادة إنتاج للتبعية حتى بعد رحيل المحتل.
ومن هنا جاء قراره الحاسم: «لن أكتب بالإنجليزية مجدداً». واختار أن يكتب بلغة الكيكويو، ويترجم منها أعماله بنفسه، مخاطباً القاعدة الشعبية التي همّشها النخبويون، ومنادياً الكتاب الأفارقة بأن يكتبوا بلغات شعوبهم الأصلية مقدمةً لتحرُّر حقيقي من الإرث الاستعماري، ولإعادة ربط الأدب بالجماهير الشعبية كأداة لإثارة الوعي السياسي والاجتماعي.
أمضى نغوجي أكثر من 4 عقود في المنفى، متنقلاً بين بريطانيا وأميركا؛ حيث استقر في جامعة كاليفورنيا - إيرفين أستاذاً للأدب المقارن، وبنى هناك مركزاً دولياً للإبداع والترجمة. لكن الغربة لم توقف اندفاعه للكتابة والدفاع عن قضايا أفريقيا: الهوية، والعدالة، والتحرر الثقافي، مشدداً على أن مستقبل القارة السوداء لا يُبنى إلا باستعادة ثقتها بذاتها، وبتفكيك البنى الفكرية التي رسّخها الاستعمار في الذهنية الجماعية، وأصبح أكثر شراسة في انتقاده لحكومات ما بعد الاستقلال التي تواطأت مع النهب النيوليبرالي للبلاد.
في عام 2004، بعد عودته القصيرة إلى كينيا، تعرّض لهجوم وحشي في مقر إقامته؛ حيث أُصيب بجروح، وتعرّضت زوجته نجيري للاغتصاب. قال لاحقاً: «لم يكن ذاك سطواً. إنها رسالة بألا أعود».
كان نغوجي صوتاً فريداً لا يهادن. حين سُئل (في مقابلة صحافية) عن المصطلح المتداول عن «الإنجليزية الكينية» أو «الإنجليزية النيجيرية»، قال إنها مثل «الاستعباد الذاتي»، وإن احتفاء الشعوب المستعمَرة بلغات مستعمريها ذروة نجاح المشروع الاستعماري. كان يؤمن بأن لا استعمار جيد: «لا يهم إن كان المستعمر يحمل مسدساً أو إنجيلاً؛ فالمحتل هو المحتل»، وأن «اللغة بنك الذاكرة الجماعية. من دون لغتنا، نخسر أنفسنا». وكتب في «تحريك المركز» (1993): إن المطلوب هو تفكيك المركزية الغربية من داخلها، وإعادة توزيع السلطة الرمزية للعالم عبر اللغات والثقافات.
رغم عدم فوزه بجائزة نوبل، ظل نغوجي مرشحاً دائماً لها، وأيقونة فكرية عالمية. ألّف روايات كبرى مثل «حبة قمح» (1967)، و«بتلات الدم» (1977)، و«ساحر الغراب» (2006)، و«ماتيغاري» (1986)، و«التسعة الكاملون» (2021)، إضافة إلى يوميات ونصوص تأملية ونظرية تركت أثراً كبيراً في دراسات ما بعد الاستعمار.
لقد كانت حياته سلسلة من التمرّدات، تبدأ من اسمه: فقد ولد باسم جيمس نغوجي، ثم تخلّى عنه في السبعينات ليصبح نغوجي واثيونغو، مستعيداً إرثه الوطني الجيكويوي، ومعلناً أن الحرية تبدأ من الاسم، وأن «المقاومة أفضل طريقة للبقاء على قيد الحياة. حتى قولة (لا) صغيرة للظلم، قد تكون كافية لتبقى إنساناً».
في رثائه قالت ابنته وانجيكو: «عاش أبي حياة كاملة، وخاض معركة بطولية». لقد رحل نغوجي، لكن معركته لم تنتهِ. فسيبقى هذا المناضل الصلب في ذاكرة كل شعوب الجنوب كقائد مغوار جعل من اللّغة ساحة نضال، ومن السرد مقاومة، ومن الأدب خندقاً لتحرير العقول. وسيظل حياً في كلمات كل من يكتب بلغته الأم، وفي غضب كل من يرفض الصمت على الظلم، وفي قلب كل من يرى أن الكرامة تبدأ من الحرف.