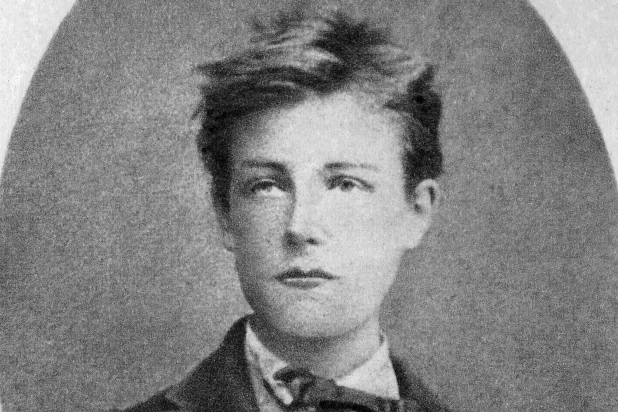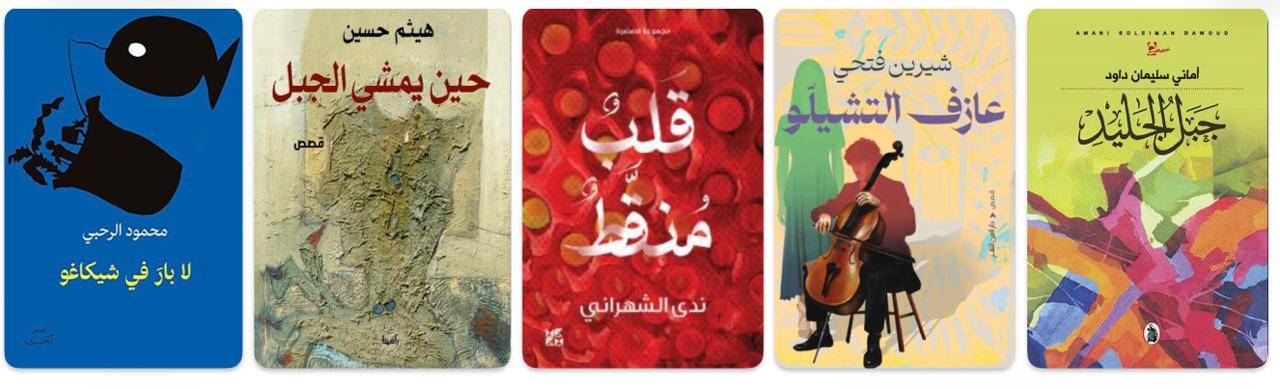قد تكون قصة تريستان وإيزولد (أو إيزولده) العاطفية التي ظهرت في فرنسا في القرن الثاني عشر إحدى أكثر الأساطير تعبيراً عن روح القرون الوسطى، وعن حاجة الغربيين الذين أدمتهم الحروب الصليبية والأهلية إلى جرعة من الحب تربطهم بمعنى للحياة مغاير للعنف الدموي والأحقاد القاتلة. ومع ذلك فإن هذه الأسطورة التي غذتها روافد متعددة تراوحت بين الحب الأفلاطوني والعفة المسيحية والتراث الغنوصي الصوفي، وصولاً إلى الحب العربي العذري، التي بدأ بكتابتها الشاعر الألماني غوتفريد فون ستراسبورغ في أوائل القرن الثالث عشر قد شكلت مصدراً لإلهام العديد من شعراء الغرب وموسيقييه، بدءاً من بارزيفال أشينباخ وليس انتهاء بالعمل الأوبرالي المتميز لريتشارد فاغنر.
أما أحداث القصة فتتلخص بأن مارك، ملك بلاد كرنواي الذي يتعرض لهجمة عنيفة من أعدائه، لا يجد من يهبّ لنجدته سوى ريفلان، ملك بلاد لونُوا، الأمر الذي يدفعه إلى مكافأته بتزويجه من أخته بلانشفلاور. إلا أن الأخيرة لا تهنأ طويلاً بهذا الزواج، حيث يقضي ريفلان نحبه في إحدى معارك الدفاع عن مملكته، قبل أن تنجب بلانشفلاور ولدها تريستان، ويعني اسمه الشخص الحزين. وبعد أن يفقد تريستان أمه في يفاعته يتبناه الملك ويقوم بتدريبه على فنون القتال، حتى إذا تعرضت مملكة كرنواي لهجوم كاسح من الآيرلنديين لم يجد مارك من يواجه موهورلت الفارس الآيرلندي العملاق سوى تريستان، الذي ينجح في قتل موهورلت، إلا أنه يتلقى منه إصابة بسيف مسموم.
إثر ذلك يغادر تريستان بلاده بحثاً عن دواء، لتضعه المصادفات في طريق إيزولد، أميرة آيرلندا الفاتنة وشقيقة موهورلت التي تقوم بإعطائه دواءً سحرياً دون أن تعلم بأنه قاتل أخيها. وبعدها بسنوات يضع طائر شعرة ذهبية طويلة عند نافذة الملك مارك الذي أرسل تريستان للبحث عن صاحبتها بهدف الزواج منها. وتتولى الصدف بحمل تريستان مجدداً إلى شواطئ آيرلندا، فيقوم بقتل تنين هائل كان يهدد عاصمتها. لكنه يتعرض لبعض الجروح التي تقوم إيزولد مرة أخرى بعلاجها. تهم الأميرة بقتله لدى معرفتها بأنه قاتل أخيها، لكن بعد أن قام تريستان بإبلاغها أنها هي بالذات صاحبة الشعرة الذهبية التي عزم الملك على الزواج من صاحبتها، قررت العفو عنه، ووافقت على الزواج من الملك.
وإذ تعمد أم الأميرة إلى إعطاء خادمة ابنتها المبحرة برفقة تريستان لتتزوج من الملك دواءً سحرياً يؤجج الحب بينها وبين زوجها المنتظر لسنوات ثلاث، تقوم الخادمة عن طريق الخطأ بإعطاء الدواء لإيزولد وتريستان الذي لم تثنه خيانته للملك بفعل الشراب السحري الذي تناوله مع إيزولد عن الوفاء بالعهد الذي قطعه له. ولكي لا يكتشف مارك فعلة عروسه، تعمد الخادمة إلى الحلول مكانها ليلة لزفاف.
إلا أن قيام بعض الوشاة بتحريض الملك ضد تريستان، وتقديم البراهين على خيانته، تدفع مارك إلى معاقبته بالنفي، حتى إذا عمد تريستان إلى الاختلاء بحبيبته قبل رحيله أطلع القزم الماكر فورسين الملك المخدوع على اللقاء. ومع ضبط العاشقيْن متلبسين بفعل الخيانة سلّمت إيزولد إلى قوم من البرص وحُكم على تريستان بالموت. ومع ذلك فقد استطاع تريستان تخليص حبيبته والهرب معها إلى غابة بعيدة حيث كابدا الكثير من المشاق. وحين اهتدى الملك إلى مخبأ العاشقين الهاربين وجدهما نائمين وبينهما سيف صقيل كان تريستان قد وضعه بينهما بالصدفة، فاعتبر ذلك علامة براءتهما ونجيا من القتل.
وعند نهاية السنوات الثلاث وبطلان مفعول الشراب السحري، قام تريستان بإعادة إيزولد إلى الملك، دون أن يتوقف الاثنان عن اللقاء. إلا أن بعض الأحداث اللاحقة دفعت تريستان إلى الظن بأن إيزولد لم تعد تحبه، فعمد إلى الزواج من فتاة أخرى اسمها «إيزولد، ذات الأيدي البيضاء»، دون أن يلمسها لأنه كان لا يزال متولهاً بالأولى. وبعد أن أصيب تريستان مجدداً بجرح مسموم، أرسل في طلب الشفاء من حبيبته الملكة فسارعت إلى نجدته رافعة شراعاً أبيض كعلامة على الأمل. إلا أن الغيرة التي استبدت بإيزولد البيضاء دفعتها إلى إبلاغه بأن لون الشراع أسود، فقضى تريستان نحبه متأثراً بالنبأ المشؤوم، حتى إذا وصلت إيزولد الملكة إلى منزل حبيبها وجدته قد مات، فلفظت أنفاسها على الفور.
وإذا كانت هذه القصة المؤثرة قد تركت خلفها أصداء عميقة وواسعة في بلاد الغرب، بحيث أعاد كتابتها العديد من الشعراء والكتاب، وحوّلها ريتشارد فاغنر إلى عمل موسيقي أوبرالي من ثلاثة فصول، فإنها دفعت الباحثين في الوقت ذاته إلى طرح الكثير من الأسئلة حول طبيعتها وظروف تكوّنها ومرجعياتها الفكرية والثقافية. ففي تقديمه للأسطورة التي أعاد صياغتها جوزف بيديه، عضو الأكاديمية الفرنسية، يقول غاستون باريس إن القصة التي طهّرها الألم وقدّسها الموت، قد خرجت من أعماق المخيلة السلتية المترعة بعوالم السحر وطقوسه الغرائبية، وامتزج فيها العنصر البربري بروح الفروسية الغربية.
أما الباحث الفرنسي دينيس دي رجمون فيرى فيها نوعاً من التصعيد الدلالي لظاهرة التروبادور، وارتقاء بالحب الفروسي التراجيدي إلى خانة الأسطورة. وإذ يعدُّ أنه «ليس للحب السعيد قصة بل للحب المميت»، يؤكد انعكاس التقاليد السلتية في العديد من وقائع القصة، وبينها أن الفتيان في سن البلوغ لا يحصلون على حقهم بالمرأة إلا بعد اجتيازهم لامتحان القوة، الذي اجتازه تريستان بامتياز. كما يرى أن مأساة تريستان كانت تكمن في تحوله إلى ساحة للعراك العنيف بين موجبات الهوى التي تدفعه إلى الاحتفاظ بحبيبته، وبين موجبات التقاليد الإقطاعية التي تلزمه بإعادة إيزولد إلى زوجها.
وإذا كان بعض المتشددين قد أدرجوا العلاقة في خانة الزنى والهوس الشهواني، فإن ثمة من دفع عن العاشقين مثل هذه التهم، باعتبار أن ما فعلاه لم يكن بإرادتهما الواعية، بل تسببت به قوة قاهرة اتخذت شكل الشراب السحري. ورأى آخرون أن حرص تريستان على إعادة حبيبته إلى عهدة الملك لم يكن بدافع الواجب الأخلاقي وحده، بل لاعتقاده بأن الآخر ينبغي أن يظل بعيداً عن الامتلاك الكامل، الأمر الذي يجد تفسيره في حادثة السيف الفاصل بين جسدي العاشقين. ولأن كلاً من الهوى والزواج يتغذى من منابت مختلفة، فقد حرص البطل العاشق على إبقاء حبيبته في فضاء الشغف واللهفة لأن تحوُّلها إلى «مدام تريستان» سينزل بها من سماء الأسطورة إلى الأرض المستهلكة للرتابة والنسيان.
قصة حب مؤثرة حوّلها ريتشارد فاغنر إلى عمل موسيقي أوبرالي
وبصرف النظر عن انقسام الدارسين بشأن تأثر الحب الغربي آنذاك بقصص الحب العربية التي لم تواجه أي صعوبة تُذكر في عبور الأندلس باتجاه الشمال الشرقي، فإن البحث المضني عن جذور محلية وصافية النسب لقصة تريستان وإيزولد لم يكن هدفه العثور على الحقيقة، بل كانت مسوغاته الأبرز تنقسم بين التعصب الإثني والآيديولوجي من جهة، وبين العداء للعرب الفاتحين من جهة أخرى. ومع أن قصة تريستان وإيزولد لا تتطابق على نحو تام مع أي من قصص الحب العربية التي سبقتها في الزمن، فإن فيها أطيافاً متفاوتة المقادير من قصص قيس بن الملوح، وجميل بن معمّر، وقيس بن ذريح وعروة بن حزام، التي انتهت جميعها بموت الحبيبين، كما كان شأن البطلين الغربيين.
وإذا كان الجانب الفروسي من شخصية تريستان لا يتطابق مع كوكبة العذريين الذين أداروا ظهورهم لميادين الحروب، فإن شجاعته الأسطورية الخارقة تحيلنا إلى الشخصية المماثلة لعنترة بن شداد الذي كان عليه للفوز بحبيبته عبلة، أن ينجح في امتحان الشجاعة القاسي، قبل أن تتولى الذاكرة العربية الجمعية كتابة سيرته، وتحويله إلى بطل قومي ملحمي.
وسواء كانت الرياح العاطفية القادمة من الشرق هي التي لفحت بأرجوانها الناري قلوب العشاق الغربيين، أو كان وجيب تلك القلوب يتغذى من رياح محلية المنشأ، فإن عهد الهوس بالحب الجنوني والبعيد عن التحقق ما لبث أن تراجع إلى مربعه الضيق بفعل الضربات القاصمة للمؤسسة الكنسية الحاثة على الزواج. ولم تكن رواية «دون كيشوت» التي كتبها سرفانتس في القرن الخامس عشر سوى مرثية مضحكة مبكية لزمن الفروسية الآفل، واستطلاع بلغة السرد لعصر النهضة القادم، حيث بدأ الجسد يحل محل الروح، وحيث أخلت الأساطير الرومانسية مكانها للتفكير العقلاني وكشوفه العلمية المتسارعة.