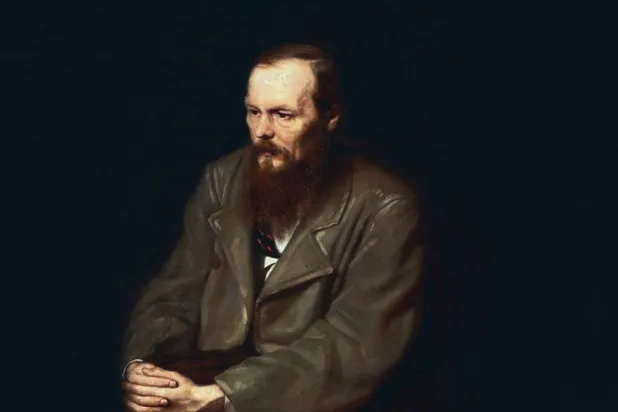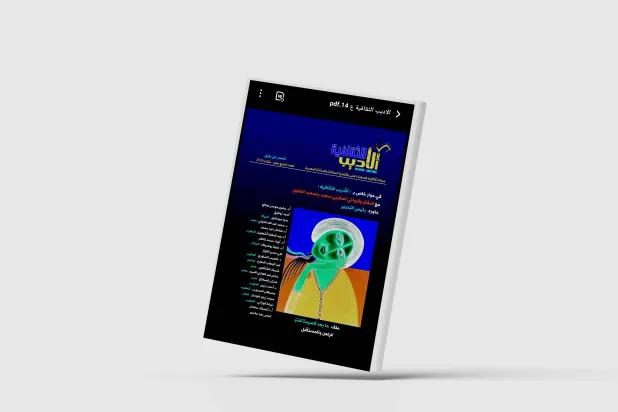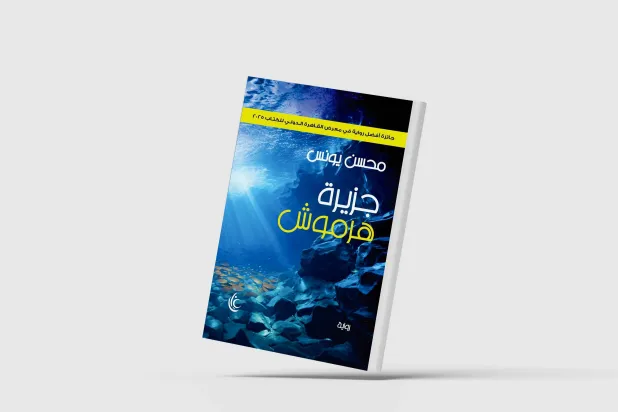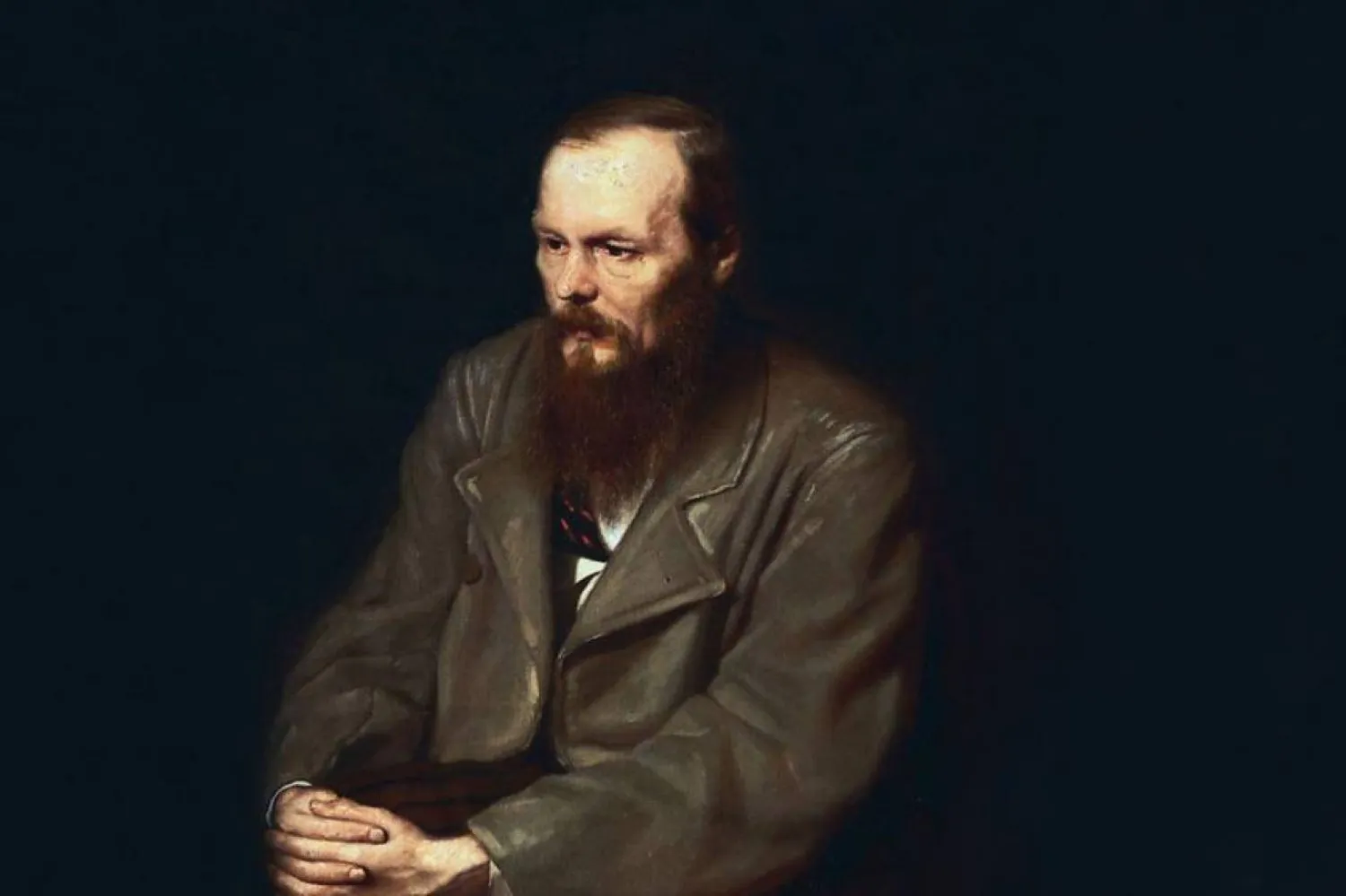دأبت الدراسات الفكرية عامة، والنقدية خاصة، على أن تخاطب قارئاً متخصصاً، مستخدمة لغة ممعنة في التجريد والانغلاق، ومتكئة على جهاز اصطلاحي يصعب على القارئ العام فهمه أو التواصل معه وفك شفراته، وهذا ما يجعلها محدودة المقروئية، ومن ثم التأثير في قطاع واسع من المتلقين، وربما هذا ما كان يعيه تماماً الباحث المصري الدكتور محمد عبد الباسط عيد، وهو يؤلف كتابه «عمائم وطرابيش وكلمات: قراءات في العلامة»؛ فقد حرص على أن يتفادى هذا الانغلاق، ويُخرِج كتابه إلى آفاق أكثر اتساعاً، ليكون صالحاً للقارئ العام. ورغم أن الكتاب يمثل ممارسة قرائية تنتمي إلى علم السيموطيقا، بما له من ترسانة اصطلاحية قد تُثقِل كاهل القارئ، فقد تمكن المؤلف من «تقديم مقاربة للعلامات تنزل بها من فضاء التجريد الأكاديمي إلى فضاء المعرفة الحية».
صدر الكتاب حديثاً عن «دار العين» بالقاهرة. ومنذ عنوانه الذي لا يسير على نمط العنونة الأكاديمي، إنما اتخذ لنفسه مساراً تداولياً، بداية من هذا العنوان التبسيطي الجذاب، مروراً باللغة الخالية من أي تقعُّر أو اصطلاحات صعبة، التي كان واضحاً فيها نهج مخاطبة القارئ دائماً، بصيغة المخاطب، بما يجعله أقرب إلى حوار بين المؤلف والقارئ، أو يقترب به من الطابع الشفاهي، وكأن الكتاب محض «دردشة» بين شخصين، عبر صفحاته (176 صفحة)، لكنها دردشة مسكونة بكثير من الحمولات الفكرية والسياسية والآيديولوجية، التي يحاول القارئ فيها أن يخفي مواقفه وانحيازاته قدر الإمكان، لكنها تنسرب منه إلى القارئ على مهل، وبعيداً عن أي خطاب فوقي، فهي محض دردشة، وكثيراً ما يخاطب القارئ في تفصيلة هنا أو هناك قائلاً: «كما تعلم»، وكأنه يضع الأرضية المشتركة التي يقف فيها مع القارئ، بوصفها أساساً للحوار الذي ينطلقان فيه.
إلى جوار هذه اللغة التداولية، هناك مستوى آخر يمنح هذا الكتاب جاذبيته، وهو أنه يناقش حزمة من العلامات شديدة الحضور في الواقع المعيش؛ فهو ينقسم إلى فصلين كبيرين، يناقش كل منهما نمطاً من العلامات، محاولاً تفسير دلالاتها ومرجعياتها والسياق الذي أنتجها. وبدا أن الكتاب مجموعة مقالات كُتِبَت بشكل متفرِّق، وهو ما يدل عليه قصر هذه المقالات ولغتها الأقرب إلى اللغة الصحافية التي يمكن للجميع فهمها، لكن كان ثمة خيط يجمعها في عقل المؤلف وهو يكتبها منجَّمة، فبدت غير متنافرة، كحبات عقد كل منها له استقلاله، لكنها تنتظم معاً في هذا الخيط مكونة عقداً مهماً من قراءة الواقع وعلاماته وحركيتها، سواء في السياق الاجتماعي والسياسي الذي أنتجها، أو في عمقها التاريخي وبُعدها التراثي الذي يبدو مطموراً تحت هذه العلامة الراهنة، محاولاً تفكيك العلامة وفهم كيفية تشكلها وطرائق عملها واشتغالها، ومن ثم تأثيرها في الواقع المعيش وتأثرها به.
في الفصل الأول: «تقشر الكلام»، يناقش مجموعة من العلامات التي تصادف المرء يومياً، مثل «الزينة، الباب، العين، الأصول، الرقبة، البلاغة البيضاء، أسماء وألقاب»، مقلباً بين كل الحمولات الممكنة لكل علامة، وما تحمله من تقاطعات مع علامات أخرى، فعند قراءة علامة الزينة مثلاً، يناقش زينة البيوت، معرجاً على فنون العمارة، والزينة بمعناها الديني (خذوا زينتكم عند كل مسجد)، والفروقات الدينية بين زينة الرجال وزينة النساء، فضلاً عن مرور على زينة الكلام في المحسنات البديعية، وتمثيلاتها الشعرية لدى أبي تمام وغيره من الشعراء، بما يجعل ظلال المفردة أكبر وأعمق كثيراً مما تبدو في سطحها المخادع.

في الفصل الثاني: «الأزياء... الأشكال والدلالات»، وهو الأصغر حجماً، لكنه ربما الأكثر جاذبية، منطلقاً من حقيقة أن «ملابسنا أكبر من مجرد أغطية للجسد؛ إنها رسائلنا لأنفسنا وللآخرين، هي كذلك حتى حين نرتديها ببساطة ودون تفكير واعٍ». ومن ثم، فإنه يحاول قراءة الملابس ليس بما تبدو عليه من بساطة على السطح، ولكن بوصفها «نتيجة تفاعل أنساق أعمق»، متوقفاً عند حمولاتها السياسية أحياناً، والطبقية والجندرية أحياناً أخرى، مؤكداً أن «الجانب الديني فيها لا يدل على التقوى، بقدر ما يشير إلى حضور هذا الطرف أو ذاك من أطراف الصراع في الفضاء العام».
يتوقف المؤلف أولاً عند طربوش المفكر الراحل عباس محمود العقاد، مختزلاً ركاماً من الكتابات الفكرية والرطانة الأكاديمية عن ثنائيات «الحداثة والتراث» أو «الأصالة والمعاصرة»، فيحاول مقاربة نمط الأزياء التي كانت سائدة مطلع القرن الماضي، بوصفها علامات على الموقف من الحضارة الغربية، بين أصحاب القبعة المنتمين كلياً للثقافة القادمة لنا من شمال البحر المتوسط، وأصحاب «العمامة» الذين يتخذون موقفاً رافضاً لكل ما ينتمي للحضارة الغربية معتصمين بكل ما هو ديني وتراثي للزود عن الذات، وأخيراً أصحاب «الطربوش»، الذين يحاولون التوسّط بين تراث الذات العربية والثقافة الغربية الحديثة، لصناعة مزيج معتدل لا يرفض الآخر وثقافته، وفي الوقت نفسه لا يسمح بأن يستلبه هذا الآخر تماماً، ولا أن تذوب ذاته بجذورها العميقة في ثقافته، فيرى المؤلف أن الطربوش أصبح «علامة على خطاب ثقافي يسعى للتوسط بين القبعة والعمامة، وتمثل الأخيرتان علامتين على خطابين آخرين متناقضين». في حين أن هذا الطربوش ذاته يمثل لنا، نحن الآن، في عشرينات القرن الحادي والعشرين «علامة على مرحلة زمنية ماضية، وما يرتبط بها من أنساق ثقافية تضم القيم والمعتقدات والقضايا السياسية والاجتماعية التي ترتبط بعصر الطربوش والمطربشين».
وينتقل الكاتب من طربوش العقاد إلى طاقية الشيخ محمد متولي الشعراوي وجلبابه؛ فقد أصبح الشيخ الراحل بزيه الشهير وملامحه المميزة رمزاً كبيراً يمارس حضوره اليومي في الشارع المصري، رغم رحيله منذ نحو ربع قرن، لكن حضور صورته بكل حمولاتها الرمزية يبدو واضحاً «فحين يضع أحدنا صورة الشيخ على جدار صفحته على (فيسبوك)، فهو لا يضع مجرد صورة، وإنما يعلن عن انتماء فكري وثقافي لمنظومة محددة من القيم والأفكار».
ويسعى المؤلف إلى قراءة صورة الشيخ الراحل، بوصف هذه الصورة علامة ثقافية، وكيفية صناعة هذه العلامة وأبعادها، سواء ما يتعلق منها بالمظهر الخارجي، متجسداً في التماثل بين الطاقية البيضاء و«الجلابية» الريفية، واللغة العامية البسيطة التي يستخدمها في تفسير الآيات القرآنية، فكلتاهما - الملابس واللغة - تحرص على الاقتراب من عموم الناس والفقراء، فهذا كله يمثل خطاباً ورسالة بأن الشيخ واحد من البسطاء، وفي الوقت نفسه يتوقف المؤلف عند أهمية السياق الثقافي والسياسي في تعميق العلامة في الوعي العام؛ فقد تزامن هذا مع تحولات السياق الاجتماعي السياسي، بانتهاء المد الاشتراكي مع مطلع السبعينات وتولي الرئيس المصري الأسبق أنور السادات؛ فالعلامة لا تنمو وتصبح رمزاً متجذراً إلا في بيئة مواتية وسياق يسمح لها بالنمو والازدهار؛ فهي بنت سياقها السياسي والاجتماعي، فخطاب الإنتاج يحتاج لحظة تلقي مواتية، وهذه اللحظة جاءت مع هيمنة العلمانية ومركزية العلم في الغرب، في مقابل إزاحة الدين إلى داخل جدران الكنائس، وهو ما جعل المواطن العربي المسلم يخشى تكرار هذا النموذج الغربي، وصار أكثر رغبة في الاعتصام بكل ما هو ديني، فكان الشعراوي بصورته وطاقيته وجلبابه رمزاً لهذا الاعتصام بالدين في مواجهة العلمانية الغربية التي بدت للبعض متطرفة.
رغم ما يبدو عليه الكتاب من بساطة خادعة، في لغته وموضوعاته، فإن ثقافة المؤلف الموسوعية تعلن عن نفسها، وتطل برأسها بين السطور، فتتبدى معرفته العميقة بالشعر العربي القديم والبلاغة التي تبدو واضحة في استشهاداته المتعددة، وكذا ثقافته الدينية والفقهية في استشهاداته بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وصولاً إلى وعيه بالواقع وما يمور به من تيارات سياسية وتحولات آيديولوجية، وما تحمله العولمة من هيمنة نمط استهلاكي، فنجده يراوح بين الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا وعالم اللغة السويسري دي سوسير، والجاحظ وامرئ القيس ومقولات فقهاء قدامى، كل هذه المعارف وغيرها يوظفها الكاتب في قراءة علامة تبدو شديدة البساطة، مثل «طربوش العقاد» أو «طاقية الشيخ الشعراوي».