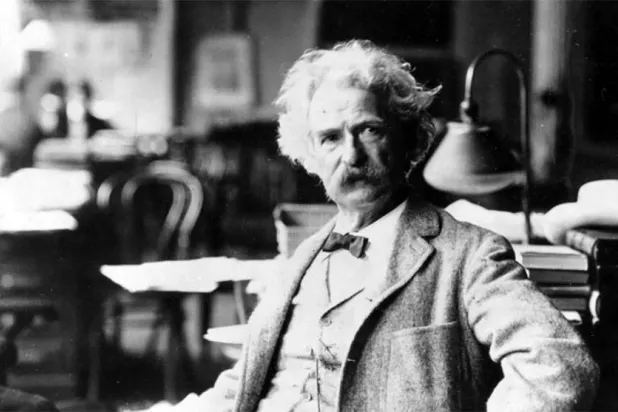كلٌّ منّا يكتب عن المواضيع التي تفرض نفسها عليه. في يريفان، عاصمة أرمينيا، كانت التّحضيرات تجري قبل أسبوع من موعد ليلة رأس السّنة. عند منتصف السّاحة العامّة انتصبت شجرة ميلاد هائلة، والشوارع المؤديّة راحت ترفرف في سمائها الشّرائط الصفراء والحمراء والزّرقاء، وهناك خيامٌ مبهرجة، وبابا نويل يلاقيك بثيابه الثّلجية والحمراء في كلّ درب.
ثمّ حلّ اليوم الأخير من السنة، وحسمتُ أمري على أن أقضيه، بنوع من العَنَد والإصرار على الابتعاد عن كلّ ما يمتّ إلى الواقع بِصلة، في القراءة والكتابة. يقول مارسيل بروست: «الحياة الواقعية، هي آخر ما يُكتشف ويُنوَّر، والحياة الوحيدة التي تعاش بكاملها، هي الأدب».
كانت السماء في نافذة الفندق رصاصيّة، ضوء شاحب في الشّارع كشف لي عن حقيقةٍ مفادها أن تجربة السفر تشبه الحلم، وعندما تنتقل من شارع إلى آخر كأنك تذهب في منام جديد، وعالم جديد. لهذا السّبب قال كالفينو: «لا أحسب أني مسافر إن لم أكن وحيداً، فلا يوجد منام يشترك فيه اثنان».
بعد الفطور قصدتُ المقهى الذي أجلس فيه كلّ يوم. مقهى يقع وسط غابة قريبة من المدينة، وعلى شجرة عمرها مئة عام، رأيت زهرةً حياتها يوم واحد. كيف كانت حياة الإنسان والحيوان وبقية الكائنات في ذلك العهد؟ إن وظيفة الأدب ليست توثيقية، أي تدوين ما يجري من أحداث، وإنما هي تسجيليّة. إنها دليل حاسم على الحيوات التي عيشت في عصر معيّن، وهذه ميزة الأدب الحيّ عن الكلام الذي يُكتب لكي يُنسى. تُدفِّئنا الحياة بطراوتها وحُسنها، وبخشونتها ودمامتها وقُبحها، وكل هذا سوف يكون جميلاً عندما يُنقَل على الورق، لأن فيه سحر الفن.
دوّنتُ هذه الملاحظات بينما كنت في المقهى، وأتممتُ قراءة ثلاثين صفحة من كتاب «السياسة» لأرسطو، وفي تمام الثانية عشرة غادرتُ المقهى، وأنا أفكّر في ملاحظات المعلّم الأول حول أهمّ مقوّمات بناء الدولة، وهي في رأيه المواطنون، إن كان عددهم قليلاً لن يستطيع بلدهم تحقيق الاكتفاء الذاتي، وسوف يستورد بشراً من الخارج، فيحصل عند تفاعلهم مع أهل البلد خليط غير منسجم يؤدي بالتالي إلى تشويه مفهوم الأمة.
عندما جنحت شمس يريفان إلى الغروب أخذت الموسيقى تصدح في الساحة الكبرى في المدينة، وصارت قنانيّ النبيذ تُراق على أرض الشارع والحديقة والساحة. لكنك عدتَ مسرعاً إلى غرفتك في الفندق، وعادت إليك الطمأنينة والراحة، بعد أن استمعت لإحدى معزوفات جواد معروفي على البيانو. ساعة، وقمتَ بتوديع لون الغروب الليموني البارد الشفّاف من آخر يوم في 2024، مع جارك في الغرفة المجاورة، وكان جالساً في شرفته هو الآخر؛ كهلٌ إيطاليّ اختار أن يأتي بنبيذه وطعام العشاء على مائدة صغيرة، وكان يقرأ كتاباً ويدخّن، ويُصغي إلى الموسيقى تصدح من هاتفي النقّال، ويواكب الألحان بأصابعه على المائدة. التقت نظراتي مع نظراته في لحظة، وقال لي باللغة الإنجليزيّة وعلى شفتيه ابتسامة مطفأة: «سنة سعيدة يا صديقي»، وأجبته بالكلام نفسه، وبقي وجهانا يبحثان لبرهة عن كلمات لا وجود لها في لغتي أو لغته، مغزاها أن أيّام العمر سوف تمتدّ بنا، ونكتشف فيها كثيراً من الوجود الفارغ في الأشياء والأشخاص والكتب. في اليوم التالي كلّ شيء سيعود إلى طبيعته السابقة، كل شيء سيكون طبيعياً تماماً؛ الساحة والشارع والناس. وحدها المعرفة التي تأتينا عن طريق قراءة الكتب المدمّرة العظيمة، تَعِدنا بنوع من القوة والحريّة، يحتاج إليها المرء في سبيل اكتشاف العالم. رأيتُ هذا مطبوعاً في وجه جاري الإيطالي، وكنتُ كمن ينظر إلى صورته معكوسة في المرآة.
أليس من الغريب أن الجميع يرقصون ويغنون في الشوارع القريبة، وأنا منكبٌّ في مجلسي عند الشرفة على قراءة كتاب «السياسة»؟ مما لا مرية فيه أن ما فعلته لا يدلّ على مزاج منحرف أو طبع لا ينسجم مع المألوف، كما أنه لم يكن مجرد ترف بورجوازيّ، مثلما كان يقول أهل السياسة سابقاً، لكنه «إرضاء للحسّ العميق بالواجب»، (التعبير لفان غوخ)، من أجل الحفاظ على الهويّة. إنه تجسيد حيّ لفكرة الالتزام الذي يفرضه الفنان على نفسه، ويؤديه بأحسن صورة عندما يكون واثقاً من أنه يؤدي دوراً ليس غرضه المتعة الجمالية فحسب، بل هو أقرب إلى ما يقوم به الشامان؛ الوريث الفعلي للوليّ الصالح بمفهوم الدين. حين تقدّم فيكتور هوغو في السن أصبح شاماناً، وكان يشعر بأن الرسالة التي أدَّاها بواسطة الأدب لم تكن موجهة إلى فرنسا فحسب، وإنما إلى البشر جميعاً. هذا هو سرّ القيمة شبه الدينيّة التي نسبغها على الأدب، وفي مرحلة معينة من حياة الكاتب، يصبح هذا النوع من التفكير هاجساً بالنسبة إليه، لا يمكنه التفريط فيه، لأنه المحكّ الذي سوف تنجلي طبيعته في نقطة منه، مع مرور السنين.
في الفجر الأول من السنة الجديدة، كنتُ أسيرُ فوق النبيذ الذي تجمّد في الشوارع وصار هو الأرض. لا أعرف كيف أحسستُ فجأة بما يمكن أن أدعوه دواراً معنويّاً سببه السعادة، بلغتني كما لو كنتُ أمضيتُ السهرة مع المحتفلين بعيد رأس السنة، ودخّنتُ سجائرهم وشربتُ أنهار خمرهم جميعاً. تحضر هنا عبارة لجورج باتاي: «رفض التواصل هو وسيلة للتواصل أكثر عدائيّة، ولكنها الأكثر قدرة». هناك مسافة متدرّجة تفصل بين الشاعر والعالم الخارجي، مسافة حقيقية وليست من لِدات تصوّراته، عندما يشغلها ما هو غريب يحدث فرق جهد يشبه ذلك الذي درسناه في الفيزياء، يؤدي إلى شحنة من الوعي الإضافي تُعيد الأمور إلى نصابها.
كان المحتفلون يغادرون الحانات في تلك الساعة، شباب وشابات يغنون ويرقصون، يُكملون قصفهم الذي بدأوه في الليل، وينظرون إلى العالم بعيون غلّفها السُّكْر. ثم أشرقت الشمس في مشهد غريب أعاد إليّ الماضي بقوة حتى إنني شعرت كأن سماء يريفان هي سماء مدينتي، والمحتفلون هم إخوتي وبناتي وأحفادي. كلّ بلد أحطّ فيه الرحال، بقوّة الإدراك لإنسانيتنا المشتركة، أشعر فيه بأنه وطني، بإمكانه أن يمدّ جذوره في أعماقي بثبات، وهذا هو التفسير الحقيقي لعبارة فان غوخ: «الحسّ العميق بالواجب» يقوم به الشامان تجاه الآخرين في كلّ مكان، ما دام كان يقدّم عمله للجميع، وليس لنفسه أو لشخص واحد أو بلد أو أمة. بهذه الصورة يفتحُ لنا الأدب (والفنّ عموماً) نافذةً على حياة ذات معنى أعمق، كي نراها طريقاً واسعاً يسع الوجود كلَّه، ويمكّننا من التعاطف والعيش مع جميع الشعوب رغم الاختلافات بيننا وبينهم.
تناولت فطوري سريعاً في مطعم طائر على الرصيف، وأمضيتُ الصباح في زيارة كنائس المدينة، ودراسة قسمات الناس الذين جاؤوا من بقاع الأرض للاحتفال بالسنة الجديدة، وكنت أفكّر إن كانت نظرية أرسطو تصحّ في الزمن الحاضر.
الأمة؟ ألا يبدو هذا المفهوم غريباً الآن؟
عندما تتغيّر قوانين الرياضيات والفيزياء، يكون علم الاجتماع مختلفاً بالضرورة، وعند ذلك تكون المعايير والاعتقادات والأحكام القديمة الراسخة، والمكرّسة عبر قرون، غافلة ومنسية بحكم الضرورة، بل إننا نحتاج إلى مجهر بقوة مئة حصانٍ لتمييز حروفها، وكلّ شيء يمضي به الزمن والساعة، كما يقول شكسبير. حتى الوطن، تلك المفردة التي كانت مشحونة بالقوّة ذات يوم، غدت لفظاً خادعاً وهشّاً في بلدان تسود فيها ظروف القهر والفساد والظلم، وأبناؤها على استعداد لركوب البحر الهائج، على خطر الموت في سبيل الخلاص. كأننا نعيش وسط حالة جديدة من ارتقاء الأنواع وصراعها. عاجلاً أم آجلاً، سوف تنتقي الطبيعة النوع الأفضل والأرقى.
لقد أدّى التطور العلمي والنظرة العلمانية للوجود إلى نشوء مشروع انعتاق بشري كوني سوف تنقسم الأمم بموجبه إلى متحضرة ومتخلفة وبدائية، تعم السعادة والطمأنينة الشعوب التي يكون نصيبها الخانتان الأولى والثالثة، والعذاب والقهر وسوء الحال هو حظّ الأمم المتخلفة، تنتشر وتتوزع مثل حطام مهيب في أغلب جهات المعمورة، تناظرها في المقابل يوتوبيات يسعى فيها الإنسان إلى جعل الحياة على الدوام أفضل من أي وقت مضى.
مَن قال هذه الحكمة الخالدة: «الشعوب السعيدة لا تمتلك تاريخاً مجيداً»؟ إنهم سليلو أجداد مغمورين ومهجّنين وعاديين وفقراء أحياناً، من الأعراق والأديان والمذاهب كافة. الناس قد يعيشون في مكان واحد غرباء بعضهم عن بعض، بخليط من الدّم وخليط من الثّقافات لكنهم أكثر وحدة من أبناء البلد الواحد، تجمعهم هواجس القوّة والحريّة (الأخلاقية والسياسية) أكثر من تلك التي يسبّبها الشّعور بالضّعف والعبوديّة؛ الأولى تهبهم الحيويّة والعنفوان، والأخيرة تأتيهم بما يؤدّي إلى عكس ذلك. هذه سمة العصر الذي نعيش فيه، وليست لديّ القدرة على التّنبّؤ بما ستؤول إليه الأمور في المستقبل، وكيف سيكون شكل الزّهور التي تحملها أشجار الغابة، حيث يقع مقهاي الذي قصدته للبدء بيوم عمل جديد.