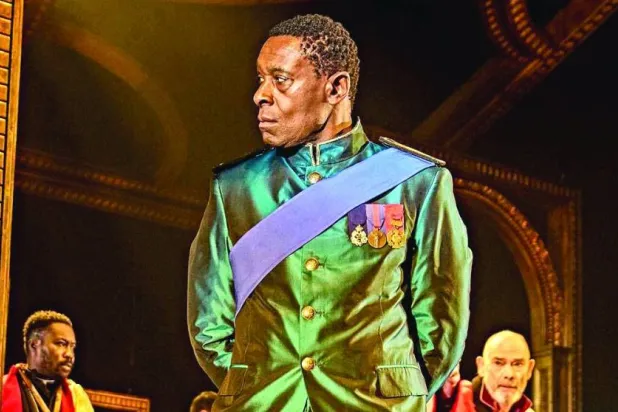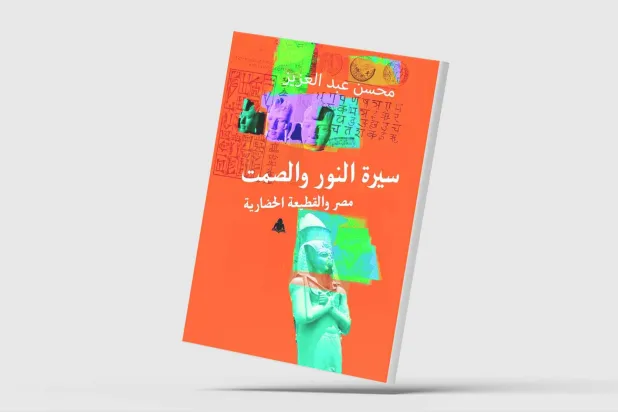لو وُجِد دوستويفسكي أو تولستوي أو ملفيل أو ستاندال أو جين أوستن في عصرنا هذا فهل كانوا سيكتبون روائعهم الروائية بالطريقة ذاتها التي جعلت منها كلاسيكيات عظيمة؟
ربما تكون جائزة البوكر العالمية للرواية هي الجائزة الأعلى مقاماً بين الجوائز الروائية التي نعرف، ولعلَّ من فضائلها أنَّها الوسيلة غير المصرَّح بها لتعريف القارئ العالمي بما يُفتّرّضُ فيه أن يكون نتاجاً روائياً يتوفَّرُ على الجدة والأصالة. ستكون معايير اللجنة المانحة للجائزة موضع جدالات ساخنة بالتأكيد، وهو ما يحصل كلّ عام؛ لكنْ ليس في استطاعة القارئ العام أو المتخصّص غضُّ الطرف عن إعلانات هذه الجائزة وبخاصة أنّه يعيشُ حالة تفجّر في النشر الروائي تجعل منه عاجزاً عن متابعة ما يُنشرُ في كل أنحاء عالمنا. المرء ليس أخطبوطاً بألف عقل وعين لكي يتابع حتى البعض اليسير مما يُنشرُ في الرواية وفي غير حقل الرواية.

وطّنتُ نفسي كلَّ سنة منذ عقود عدّة، وبدفعٍ من الأطروحة التسويغية السابقة، على قراءة - أو محاولة قراءة - العمل الروائي الفائز بجائزة البوكر العالمية السنوية. أعترفُ منذ البدء أنّ خيبة كبرى باتت تملأ نفسي بعد كلّ قراءة، وما انفكّت هذه الخيبة تتعاظم مثل كرة ثلجية عاماً بعد عام. أظنُّ أنّ (مارغريت آتوود) هي آخر روائية بوكرية استأنسْتُ قراءتها بشغف حقيقي.
عندما شرعتُ في قراءة الرواية البوكرية الفائزة لعام 2024. وهي رواية عنوانها «مداري Orbital» - لعلَّ عبارة «في المدار» ستكون الترجمة الأكثر أناقة - للروائية سامانثا هارفي Samantha Harvey، وهي غير مترجمة إلى العربية بعدُ كما أعرف، لم أتعاطف كثيراً مع أجواء الرواية أو تفاصيلها التقنية أو سياقها السردي. التجربة الغريبة والمثيرة التي حصلت معي أنَّ قراءتي للرواية البوكرية تزامنت مع قراءتي - أو إعادة قراءتي بالأصحّ - لرواية «الإخوة كارامازوف» التي هي بعضُ روائع كلاسيكيّات دوستويفسكي. دفعني هذا الأمر للتفكّر الحثيث في هذا الأمر: لماذا نجدُ شغفاً أعظم عند قراءة الكلاسيكيات الروائية بالمقارنة مع الأعمال الروائية المعاصرة أو الحداثية أو ما بعد الحداثية؟ سبق لكّتّابٍ عديدين تناولُ أمر أهمية الكلاسيكيات الروائية، ومن هؤلاء مثلاً إيتالو كالفينو، الذي كتب كتاباً كاملاً عنوانُهُ «لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي؟»، وهو مترجمٌ إلى العربية وسبق لي كتابة عرض له.
لدي أطروحة شخصية في هذا الشأن. قبل عرض تفاصيل هذه الأطروحة لا بدَّ من توضيح موضوعات إشكالية محدّدة. أوّلُ هذه الإشكاليات هي معضلة التعميم: سيجادلُ بعضُ القرّاء كيف لنا أن نتوثّق من أنّ هناك توقاً عولمياً لقراءة الكلاسيكيات الروائية؟ الجواب يكمنُ في إعادة طبعاتها بعشرات وربما مئات الطبعات، وكونها تحتلُ عناوين شاخصة في المعتمدات الأدبية العالمية. ثمّ هناك الاستشهادات الكثيرة بها في الصحافة الثقافية العالمية بما يشي باستمرارية تأثيرها وكونها عموداً أساسياً في تشكيل الذائقة الروائية العالمية بعيداً عن مؤثرات الزمان والمكان والجغرافيات المحلية. الإشكالية الثانية نفسية الطابع ومفادُها أنّ الكلاسيكيات الروائية، وربَّما لأسباب مدرسية أو بسبب تقاليد القراءة المنزلية سابقاً، شكّلت جزءاً من قراءاتنا المقترنة بالطفولة، وهذا ما يدفعها إلى أن تصبح ميراثاً أدبياً راسخاً في عقولنا، وغالباً عندما نسترجع هذا الميراث فلن يخلو الأمر من عنصر نوستالجي يدفعنا للتحيّز النفسي لتلك الكلاسيكيات، فضلاً عن أنّه يصوّرُ لنا الأمر بالفائقية المحسومة لهذه الروايات على ما سواها. أظنّني أمتلكُ قدراً من الخبرة والحصانة النفسية تجاه مفاعيل النوستالجيا الطفولية والشبابية إلى حدّ أعرفُ معه أنّنا إزاء ظاهرة أدبية حقيقية عالمية الأبعاد وليست بعض ما ترسمه لنا تصوّراتنا المحلية أو تحيزاتنا العقلية.
قبل أن أبدأ في تفاصيل الأطروحة أجدُ من المناسب والضروري تشخيص أي الأعمال هي المقصودة بأنها «كلاسيكية». كلاسيكيات الرواية هنا ليست إشارة تصنيفية إلى المدرسة الكلاسيكية في الرواية، كما أنّها بعيدة عن المفهوم التقني الذي يصنّفُ عملاً مهمَّاً وشائعاً بأنّه من كلاسيكيات المبحث المعرفي الذي يتناوله. مثالُ هذا كتاب «مختصر تاريخ الزمان»، الذي كتبه ستيفن هوكنغ الذي صار من كلاسيكيات الفيزياء، أو كتاب «الجين الأناني»، الذي ألّفه ريتشارد دوكنز الذي صار من كلاسيكيات فلسفة العلم والبيولوجيا التطوّرية. الكلاسيكيات الروائية التي أعنيها بالتحديد هي تلك التي كُتِبَتْ قبل مطلع القرن العشرين على وجه التقريب وحيث لم تكن مفاهيم الحداثة الروائية قد شاعت بعدُ.
أهمّ أسباب توقنا الممض لقراءة الكلاسيكيات الروائية ذات الجانب الوجودي الذي يختصُّ بحجم وتعدّدية المصادر الضوضائية التي نعيشُ في خضمّها. لو تابعنا الخطّ التطوّري للإنسان لرأيناه في كلّ قفزة تطورية يصطنعُ مصادر جديدة للمعرفة تتفوّقُ نوعياً على تلك التي سادت قبلها، ومن الطبيعي أن نشعر بالامتنان لهذا التطوّر المعرفي؛ لكنّ هذا التفجّر المعلوماتي هو بمثابة عناصر تشويش تشاغلُ أدمغتنا. لو حسبنا أدمغتنا وسائل معالجة معلوماتية فكلّ قفزة تطوّرية ستأتي بكمّ جديد من البيانات والمعلومات والمعرفة الجديدة، وهذا ما يشكّلُ عبئاً على الدماغ البشري ويدفعه إلى إسقاط - أو التخفيف - من عبء هذا الدفق المتفجّر، وإلّا فإنّه سينتهي إلى حالة من العطالة غير المنتجة أو التبلّد الكامل. يبدو هذا اللون من التفكير غريباً بعض الشيء. أعرف هذا؛ لكن دعوني أوظّفه في مثال تطبيقي. المرء يتعلّم بالأمثلة التطبيقية جيّدة التشخيص أكثر مما يفعل من الإنشاءات النظرية. دعونا نتساءل: لو وُجِد دوستويفسكي أو تولستوي أو ملفيل أو ستاندال أو جين أوستن في عصرنا هذا فهل كانوا سيكتبون روائعهم الروائية بالطريقة ذاتها التي جعلت منها كلاسيكيات عظيمة؟ الجواب: لا؛ لأنّ عقولهم المعاصرة لن تعمل كما عملت عقولهم عندما كتبوا تلك الكلاسيكيات. كانت لهم حينها أزمانٌ ممتدّة وقدرة على التأمّل المديد غير المنقطع في معضلات الوجود البشري. حينذاك كانت الإصابة بالتايفويد أو السل - مثلاً - حكماً نهائياً بالموت. كيف لنا أن نتصوّر هذا الحال مع عصر صار فيه السلّ أو التايفويد من ذكريات الماضي البعيد؛ لكنّ جوانب مستجدة من التهديد الوجودي انبثقت فيه. مثالٌ آخر: كان نقص السعرات الحرارية التي يتناولها المرء قبل قرن من اليوم حالة طبيعية رغم أنّ عدد سكّان الأرض حينها لم يتجاوز سُدْس عددهم اليوم؛ لذا كان الجوع والتقاتل على الطعام ثيمة روائية سائدة. لم تكن الثيمات الروائية الكلاسيكية كلها أحزاناً وتذكيراً بنقص الإمكانات وقلّة حيلة البشر؛ بل قدّمت لنا أيضاً أمثلة نقية غير ملوّثة عن الحبّ والتعاطف والروابط الإنسانية بين البشر باعتبارها قيماً عالمية. هذا أمرٌ نادرٌ اليوم ولم يعُدْ يشكّلُ عنصراً جاذباً في الرواية. صارت الخصائص البشرية النبيلة تُصنعُ في سياقات روائية معقّدة بعيدة عن أجواء النقاء الخالص.
لو شئتُ مقارنة رواية دوستويفسكي الكلاسيكية «الإخوة كارامازوف» مع الرواية البوكرية الفائزة «مداري» لسامانثا هارفي لوجدنا أنّ رواية دوستويفسكي تعدُّ من المطوّلات الروائية، وتحكي عن جوانب محدّدة من السلوك البشري الجمعي غير المحدّد بضوابط الزمان والمكان والبيئة، ويفترضُ الكاتبُ أنّ القارئ سيتطوّرُ لديه مع استمرارية القراءة نمطٌ من التماهي مع شخوص الرواية؛ فهُمْ في النهاية كائنات بشرية يمكن أن نجدها بين عوائلنا أو أصدقائنا. أمّا هارفي وسائر كّتّاب الرواية المعاصرة، فصاروا مسكونين بهاجس أدب الاستنزاف Exhaustion Literature والخوف المَرَضي من أنّ كلّ الحقائق الوجودية المهمّة قد قيلت وكُتِبَتْ ولم يعُدْ مناسباً تكرارُها؛ لذا صاروا يتصارعون في محاولة تخليق بيئات فنتازية أو مواقف غرائبية شاذة أو نادرة أو مستبعدة في المعيش اليومي. نحن عندما نقرأ رواية هارفي فإنّما نقرأ عن بيئة تتسمُ بأعلى أشكال المحدودية الوجودية والاستعصاء على إمكانية تعميم الخبرة البشرية: ستّة أشخاص يعيشون في محطّة الفضاء الدولية التي تبعدُ أربعمائة كيلومتر عن الأرض!!. أراني في هذا الموضع مدفوعة للقول إنّ التمظهرات انتهازية أو الغرائبية أو النادرة ليست مثلبة؛ بل القدرة الروائية منوطة بكيفية توظيفها بما يجعلها قريبة من الانشغالات الوجودية البشرية. في رواية «مكتبة منتصف الليل» للكاتب مات هيغ Matt Haig مثلاً إشارة إلى العوالم المتعدّدة؛ لكنّ الروائي جعل العلاقات البشرية في سياق وجودي حقيقي هي الخصيصة المميزة للرواية ولم يكن مسكوناً بحمّى أدب الاستنزاف ومحاولة تخليق عوالم تخييلية غير مفيدة بأي ثمن كان. الأمر ذاته ينسحب على رواية «موبي دك» لهرمان ملفل.
إهمالُ قراءة الكلاسيكيات الروائية خسارة لمنجم هائل من الخبرات العظيمة، ويبدو لي أنّ المقاربة الفضلى في قراءة الأعمال الروائية هي عدمُ إهمال الكلاسيكيات أو الروايات المعاصرة وما بينهما من أعمال حداثية أو ما بعد حداثية. المعضلة تتحدّدُ في أنّ الكلاسيكيات الروائية العظيمة مشخّصة وقليلة العدد بالمقارنة النسبية مع سواها؛ في حين أنّ الأعمال الروائية المعاصرة وروايات الحداثة وما بعد الحداثة كبيرة الكمّ وغير متّفق على فرادتها وتميّزها، وهذه المعضلة ستتفاقم كلّما عبرنا من حقبة زمنية نحو أخرى.
المحزن في الأمر أنّ الجائزة البوكرية العالمية لن تكون معيناً لنا في هذا الشأن. الأمر كله منوطٌ بالقارئ أن يقرأ ويكتشف بين الأعمال الروائية الكثيرة ما يتوافق مع ذائقته وخبراته وترسيماته الذهنية والنفسية، وهذا جهد ملحمي ليس يسيراً أبداً إلَّا لمن أوقف حياته على الرواية وحدها.
أظنّ أنّ قراءة واحدة من الكلاسيكيات الروائية كلّ عام ستكون تجربة رائعة، وهذا ما اختبرته بنفسي وتلمّستُ ثماره العظيمة في شعور الغبطة والانشراح وانفتاح الزمان والمكان ولجم الضوضاء التي تحاصرنا أنّى ذهبنا.