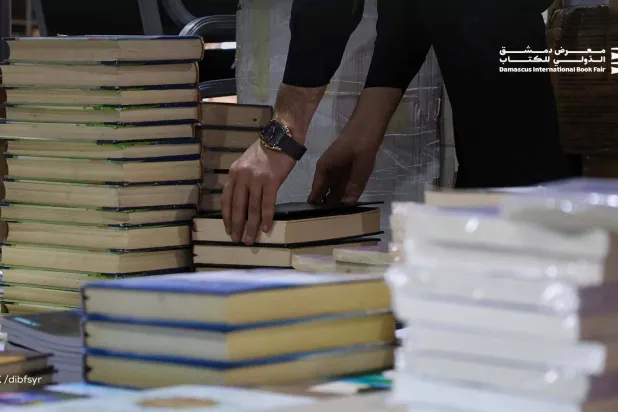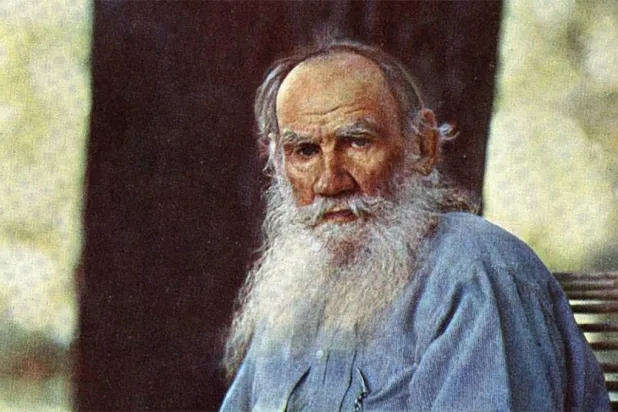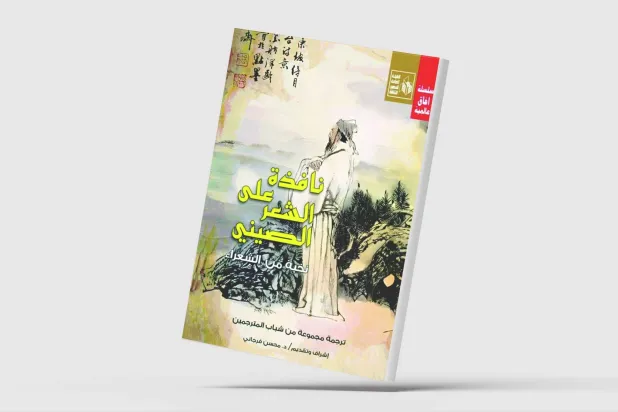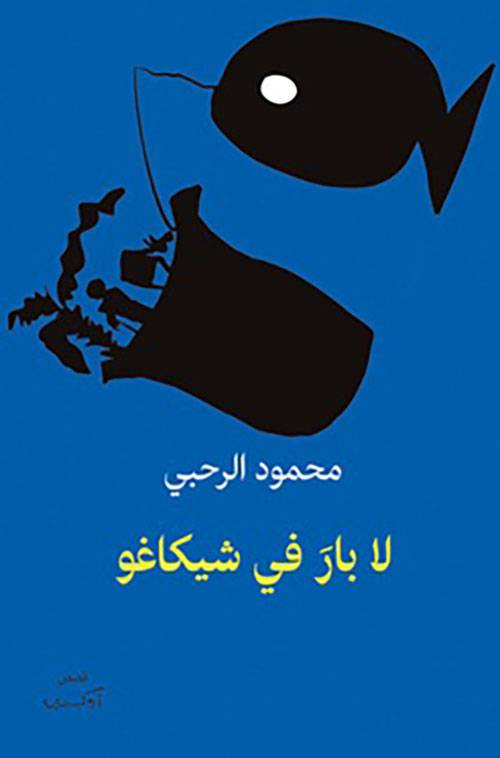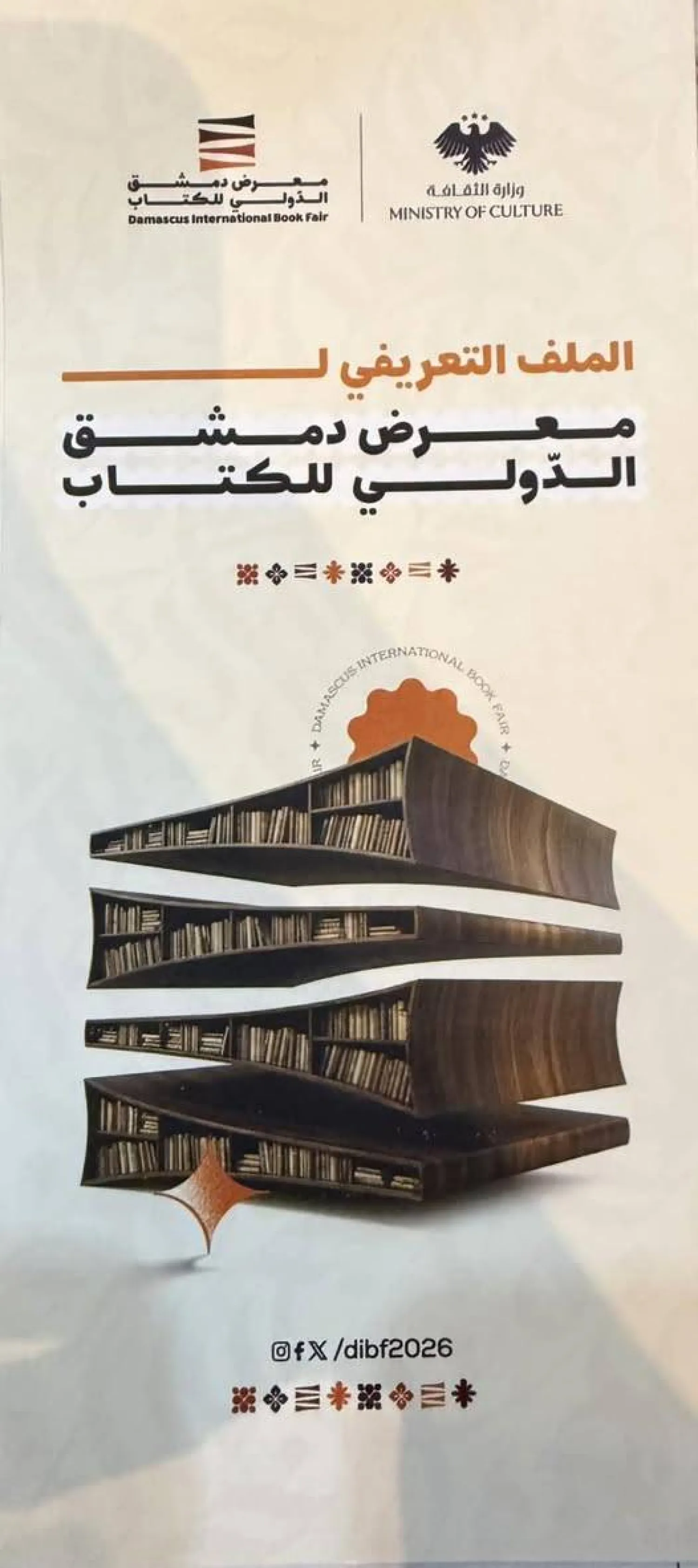في مجموعته القصصية «العاقرات يُنجبن أحياناً»، يُجري الكاتب المصري أحمد إيمان زكريا مفاوضات ضمنية بين المُمكن والمستحيل بما يُشبه لعبة الشدّ والجذب، التي تعكس تخبطات أبطاله اليائسة بين الأحلام والهزائم.
صدرت المجموعة أخيراً عن دار «المرايا» للنشر بالقاهرة، ويبدو أبطالها في نزاع مُستمر مع واقع مجهول يعيشون مُدجنين تحت مظلته، رغم تجاهلهم إحباطاته، وتفانيهم في يوميات لقمة العيش، لكن مارد هذا الواقع يظل يُلاحقهم، ويفرض عليهم كوابيسه وكوارثه، كما فعل مع بطل قصة «سعد الساعاتي» المهووس بعالَمه المُسالِم في إصلاح الساعات. ويبدو استعداده للزواج هو الحدث المركزي الجديد في حياته، إلا أن انهيار سقف توقعاته من السعادة المرجوّة من هذا الزواج يكون أكثر قسوة من وقع «الزلزال» الذي ضرب البلاد بالتزامن مع عُرسه الجديد، فيتحوّل من «جرّاح يُعالج التروس» يتحرك عالمه مثل دقة ساعات «السايكو» و«الرولكس»، إلى عالم عبثي وفوضوي تبدو فيه مانشيتات الصحف، وتحركات الحكومة من أجل تعقب ضحايا الزلزال هي صاحبة الكلمة العليا في حياته، رغم محاولاته الطويلة تجاهل هذا العالم وأبواقه غرقاً في عالم ساعاته وتروسها.
أحداث مركزية
يجعل الكاتب من الأحداث التي تُمثل محطات مفصلية في التاريخ المصري، مثل زلزال أكتوبر (تشرين الأول) عام 1992، وأحداث الأمن المركزي التي وقعت في فترة الثمانينات بمصر، يجعلها بمثابة أرضية زمنية تؤطّر عالم قصصه وتمنحها كثيراً من شُحناتها المتوترة لتتفاعل مع التحديات الشخصية لأبطالها، فبطلة قصة «العاقرات يُنجبن أحياناً» تفشل في الاتصال بزوجها المسافر خارج مصر بعد قطعها مسافة طويلة إلى «السنترال» لإجراء مكالمة دولية له، وذلك بسبب حظر التجوال الذي بدأ يُفرض في البلاد بسبب ما بات يُعرف بأحداث تمرد الأمن المركزي، ورغم الهرج والمرج الذي بات يسود الشوارع في هذا الوقت كانت «أمينة في وسط كل هذا لا تُفكر سوى في أهمية المكالمة التي قد تُغيّر حياتها، وجاءت هذه الأحداث المُفاجئة لتؤجل انتظارها أكثر».
يُصعّد هذا التقاطع بين الحدثين العام والشخصي لبطلة القصة أمينة كثيراً من التوتر الذي يتصاعد بمأساوية تعصف بها من النقيض إلى النقيض؛ ومن قمة الرجاء إلى فرط اليأس، لتبدو خطوات البطلة «العاقرة» الملهوفة على الإنجاب والاحتفاظ برضا الزوج وأسرته، وكأنها تركض بها صوب الهاوية، في حين يبدو الموت، الذي يُخيّم على الأجواء، وتعميم مناطق حظر التجوال الذي يذيع أخباره الراديو، وكأنه يشوّش على صوتها ونزاعها الأخير مع أمل لحظة ولادة جنين.
ويمنح الكاتب وسائل الإعلام التقليدية؛ من نشرات أخبار الراديو وأغنياته، والصحف المطبوعة وعناوينها، حضوراً سردياً في متن نصوصه القصصية بشكل لافت، فلا يبدو ظهورها هامشياً بقدر ما تشتبك بوعي مع أصوات أبطال القصص ومساراتهم، كما تبدو مجازاً للمسافة التي تفصل بينهم وبين السُّلطة، فكما يظهر هروب بعضهم من تلك الوسائل وعدم تصديقهم إياها، يبدو هناك من يلوذون بها بوصفها بوصلة وحيدة لهم على الطريق.
يبدو أبطال هذه المجموعة في نزاع مستمر مع واقع مجهول يعيشون مُدجنين تحت مظلته، رغم تجاهلهم إحباطاته وتفانيهم في يوميات لقمة العيش.
رعب نفسي
يُجرّد الكاتب بعض القصص من السياق الزمني التقليدي، فيُغلق جدران البيوت على بعض أبطال قصصه، ليبتلعهم الوقت وهم يواجهون علاقات كابوسية مع شركاء بيوتهم، التي وصلت ذروتها في قصة «نار هادئة»، التي صاغ بها الكاتب توليفة من مشاعر الحب والكراهية والانتقام، مستعيراً «التركيبات الكيميائية»، و«الهوس بالمعادلات»، لبناء عالم تلك القصة، حيث تبدأ بصوت البطلة وهي تعترف بقتل زوجها، دون أدنى شعور بذنب، وتبدو البطلة التي لا تضع الحب ضمن حساباتها، تتصرّف بمنطق قاتلة محترفة، حتى بدا هذا المنطق من فرط قسوته وسيطرتها عليه، أقرب للكابوسية التي تُقارب قصص الرعب النفسي وتستدعي أفلام الجريمة، وتبدو السينما حاضرة في صيغة أخرى بالمجموعة، كما في قصة «عندما وجد توماس باتمان مقتولاً في إناء خزفي» فيما يشبه التناص مع عالم أبطال السينما الخارقين، فتبدأ القصة برسالة يكتبها توماس لصديقه يوصيه بمشاهدة فيلم «فارس الظلام» للمخرج الشهير كريستوفر نولان، ويخبره بأنه أحب باتمان أكثر مما أحب «الجوكر» في الفيلم، وتدور مفارقات القصة في فلك هؤلاء الأبطال الخارقين التي تتماسّ مع لحظات شخصية في حياة بطل القصة المأخوذ والمسحور تماماً بهذا العالم السينمائي الخرافي.
وتظهر العبثية في زمن آخر يستدعي أجواء الحكايات التراثية، وساحات الأسواق الشعبية القديمة، كما في قصة «ساحة ميمونة» التي تقود فيه «قردة» زمام الأمور فتستولي على انتباه المارة وهي تؤدي فقرات استعراضية وتتكلم، فتجلب لصاحبها «القرداتي» الحظ والدراهم، حتى ذاع صيت القردة المُتكلمة في أرجاء المدينة، ليكون ذلك سبباً في سلسلة من التحوّلات العبثية التي تقودها للمُلك والعرش وحُكم البلاد والعباد، في حين تجلب الفقر واللعنة لصاحبها بعدما تتركه، وهي قصة يجعلها الكاتب احتفاءً بالعجيب في سبره أغوار النفوس، وتقلبات الأقدار.