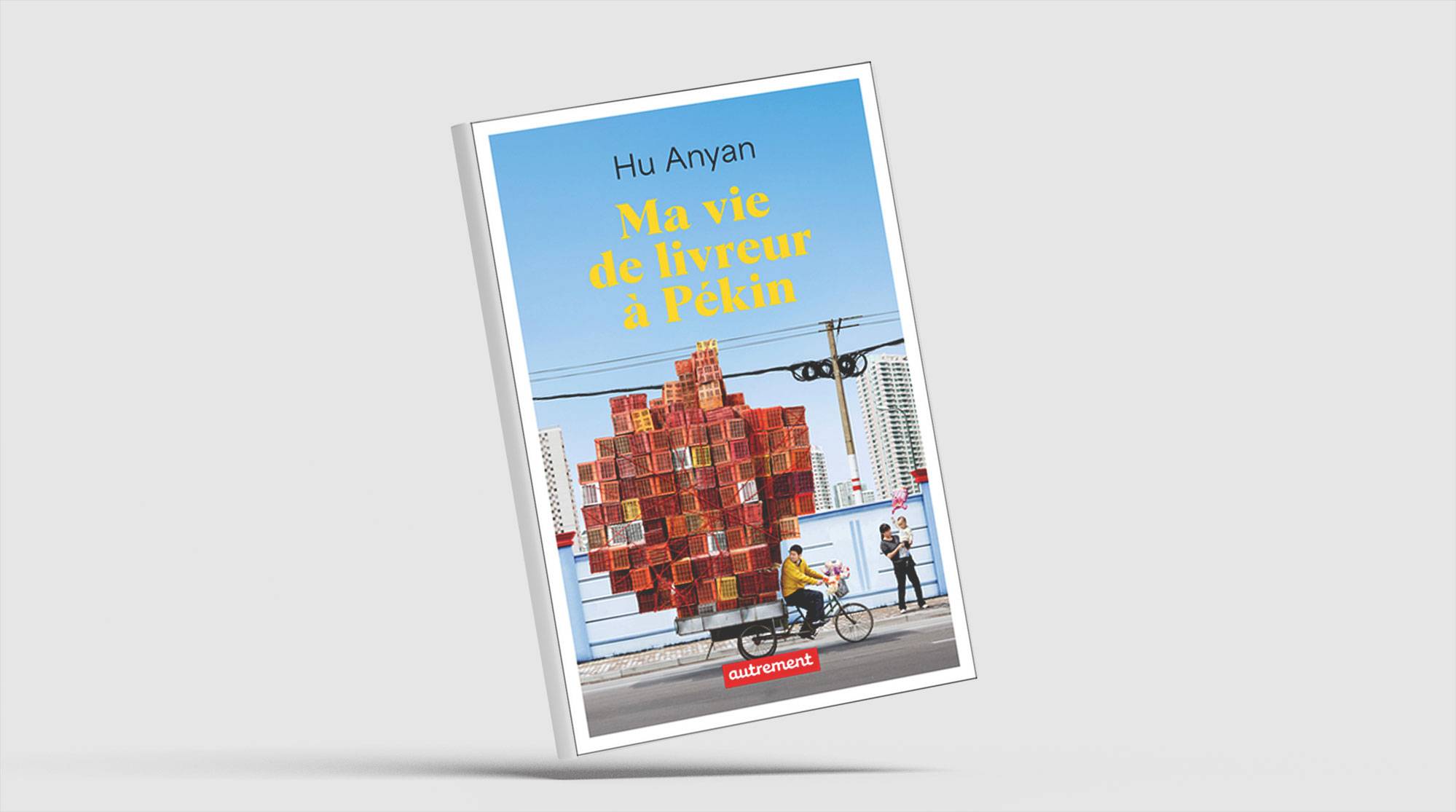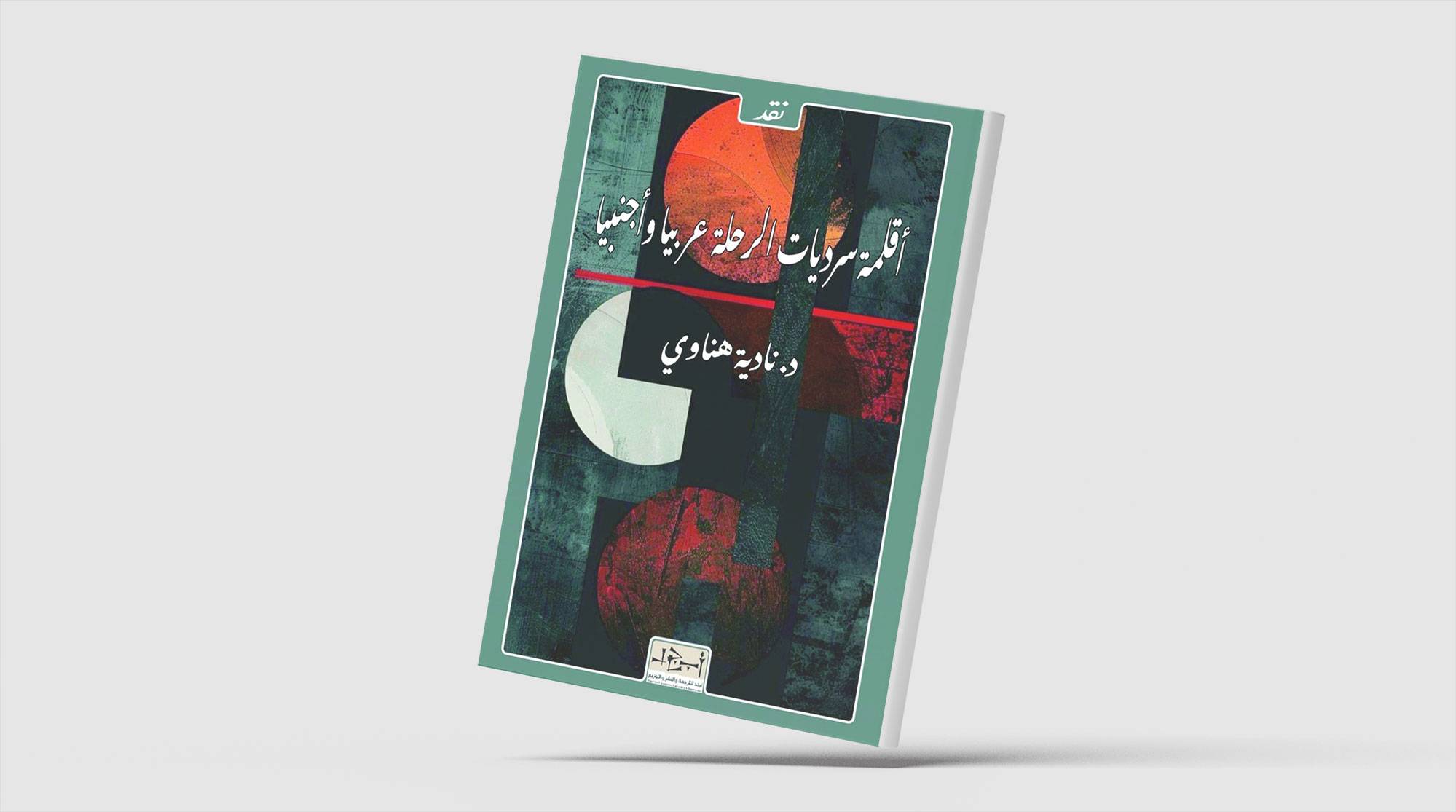كنتُ أحسبُ أنّ العبارة الأيقونية الشائعة التي سادتْ في عقود سابقة بصيغة تساؤل: هل الفن للفن أم الفن للحياة؟ قد ماتت وتلاشى ذكرُها في لجج هذا العصر الذي تعاظمت فيه الفردانية بدفعٍ مباشر من المنجزات التقنية غير المسبوقة؛ لكنْ يحصل أحياناً أن تقرأ في بعض وسائل التواصل نقاشات قد تستحيلُ معارك سجالية يبدو أطرافها وكأنّهم لم يغادروا بعدُ أجواء الحرب الثقافية الباردة التي كانت جزءاً فاعلاً في الحرب بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي.
ربما من المهم الإشارةُ إلى أنّ مفردة «الفن» في التساؤل الإشكالي تعني كلّ الضروب الإبداعية المتصوّرة من كتابة (تخييلية أو غير تخييلية) وشعر وفنون تشكيلية. أعتقدُ أنّ التساؤل السابق فاسدٌ في أساسه المفاهيمي لأنّه يُخفي رغبة مضمرة في تأكيد قناعة مسبقة سعى المعسكر الاشتراكي إلى ترسيخها ومفادُها أنّ الشيوعية تتناغم مع تطلعات الإنسان على العكس من الرأسمالية التي تعظّم فردانيته وجشعه ونزوعه الشخصي.
التبنّي الآيديولوجي لأمثولة والترويج لها في سياق مقاسات محدّدة لنتاج أدبي هو وصفة مضمونة للرداءة الأدبية
علّمتْنا تجاربُ كثيرة أنّ التبنّي الآيديولوجي لأمثولة والترويج لها في سياق مقاسات محدّدة لنتاج أدبي هو وصفة مضمونة للرداءة الأدبية، ولستُ في حاجة إلى إيراد أمثلة عن أعمال كُتِبت في ظلّ «الواقعية الاشتراكية»، وكانت غاية في السخف والرداءة. ما سأسعى إليه في الفقرات التالية هو محاولة تفكيك الأساس الفلسفي الدافع للإبداع في حقل الأدب على وجه التخصيص رغم أنّ المقايسة يمكن تعميمها على جميع ضروب الإبداع الفني.
إلهاءات تستحيل معها الفلسلفة
الحياة مشقّة رغم كلّ اللذّات الممكنة والمتاحة فيها، وخبراتنا في الحياة لم تعُدْ تُستَحْصلُ إلا بمشقّة باتت تتزايد مناسيبها مع تعقّد الحياة وتطوّرها. قارن نفسك مع أفلاطون مثلاً: بوسعك اليوم أن تحوز خبرات تقنية أعظم ممّا عرفها أفلاطون وكلّ فلاسفة الإغريق؛ لكنْ هل بمستطاعنا كتابة «مأدبة» حوارية فلسفية تتناغم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين؟ أشكّ في ذلك كثيراً؛ فهذا جهد أقرب إلى الاستحالة لأنّ الإلهاءات في حياتنا باتت كثيرة، وجعلت ملاحقة القضايا الوجودية الأساسية ووضعها في مقايسة فلسفية مناسبة - مثلما فعل أفلاطون - مهمّة مستعصية.
ربما سيتساءل سائل: ولماذا لا نكبحُ هذه الإلهاءات من حياتنا ونعيش بعيداً عنها لكي نكون قادرين على امتلاك الإحساس الفلسفي اللازم لكتابة أفلاطونية بثياب معاصرة؟ لا يمكننا هذا لأنّه يعني - بالضرورة - العيش في جزيرة مهجورة. دعونا نتذكّر ما كتبه الشاعر اللاهوتي الإنجليزي جون دَنْ (John Donne): «ما مِنْ إنسانٍ جزيرةٌ لوحده». من غير هذه الإلهاءات تبدو الحياة وكأنّها تفكّرٌ طويل لا ينقطع في موضوعات الموت والشيخوخة والمآلات النهائية للوجود البشري المقترن بحسّ مأساوي. لا حياة بشرية تسودها متعة كاملة.
الإلهاءات تتّخذ في العادة شكليْن: شكل اختياري، نحن من يختاره (لعب، مشي، سفر، تجوال ليلي في الشوارع المضاءة...)، وشكل يتخذ صفة المواضعات القانونية (دراسة، عمل...). نفهم من هذا أنّ الإلهاءات مفيدة لأنها تبعدُنا عن الجلوس المستكين والتفكّر في ثنائيات الموت والحياة، والبدايات والنهايات، والطفولة والشيخوخة... إلى جانب تمكيننا من إدامة زخم متطلبات عيشنا اليومي.
أسباب لتفادي الغرق في الإلهاءات
الغوص في لجّة الإلهاءات اليومية حدّ الغرق فيها ليس بالأمر الطيب متى ما صار ممارسة روتينية نفعلها من غير تدبّر أو مساءلة. أظنّ أنّ أسباباً كثيرة تدفعنا لخرق هذه الممارسة أحياناً:
أولاً: الغرق في بحر إلهاءات المعيش اليومي يحيلُنا إلى الشعور البديهي بأنّنا كائناتٌ محلية مآلها الفناء، وقتية الوجود، محكومة بقوانين المحدودية الزمانية والمكانية. قد نكون كذلك في التوصيفات الواقعية؛ لكنّ أحد شروط العيش الطيب هو الطَرْقُ على هذه المحدودية بمطرقة ثقيلة بغية تكسير قشرتها السميكة التي تحيط بنا حتى لو تمّ الأمر في النطاق الذهني. أظنّ أنّ المسعى الغلغامشي في طلب الخلود حاضرٌ في كلّ منّا بقدر صَغُرَ أم كَبُرَ. العيش بغير ملامسة المثال الغلغامشي يبدو عيشاً باعثاً على أعلى أشكال الملل والشعور بخسارة الزمن والعبثية المطلقة لتجربة العيش البشري.
ثانياً: تقترن الإلهاءات اليومية للعيش بمناسيب متصاعدة من الضوضاء حتى بات الكائن البشري يوصف بالكائن الصانع للضوضاء. نتحدثُ اليوم عن بصمة كاربونية لكلّ فرد منّا، وهي مؤشر عن مدى ما يطرحه الواحد منّا في الجو من غازات مؤذية للبيئة. أظنُّ أنّ من المناسب أيضاً الحديث عن بصمة ضوضائية للفرد: كم تعملُ من ضوضاء في محيطك؟
نحنُ كائنات ضوضائية بدافع الحاجة أو التسلية أو الضجر. نصنع الضوضاء بشكل أو بآخر وبمناسيب متفاوتة. ثمة دراسات متخصصة ومعمّقة في علم النفس التطوري تؤكدُ أنّ البصمة الضوضائية يمكنُ أن تكون مقياساً تطورياً للأفراد. كلّما تعاظمت البصمة الضوضائية للفرد كانت قدراته العقلية والتخييلية أدنى من نظرائه ذوي البصمة الضوضائية الأدنى. ربما التسويغ الأقرب لهذه النتيجة أنّ مَنْ يتكلمُ أكثر يفكرُ أقل.
ثالثاً: هذا التسويغ يعتمد مقاربة غريبة توظّفُ ما يسمّى مبرهنة غودل في اللااكتمال، وهي مبرهنة معروفة في علوم الحاسوب والرياضيات، وأقرب إلى أن تكون رؤية فلسفية قابلة للتعميم، وهو ما سأفعله هنا. جوهرُ هذه المبرهنة أنك لن تستطيع البرهنة على صحة نظام شكلي باللجوء إلى عبارات من داخل نطاق النظام دوماً. لا بدّ أن يحصل خطأ ما في مكان ما. يبدو لي التعميم على نطاق العيش اليومي البشري ممكناً: لن تستطيع عيش حياة طيبة إذا ما اكتفيت بالقوانين السائدة والمعروفة للعيش. لا بدّ من نوافذ إضافية تتيحُ لك الارتقاء بنمط عيشك، وهذه النوافذ هي بالضرورة ميتافيزيقية الطابع تتعالى على الواقع اليومي.
رابعاً: العيش اليومي فعالية شهدت نمواً مضطرداً في مناسيب العقلنة حتى لامست تخوم العقلنة الصارمة المحكومة بخوارزميات حاسوبية. العقلنة مطلوبة في الحياة بالتأكيد؛ لكننا نتوق إلى كبح سطوة قوانين هذه العقلنة والتفكير في نطاقات غير معقلنة. اللاعقلنة هنا تعني عدم التأكّد اليقيني المسبق ممّا سيحصل انتظاراً لمكافأة الدهشة والمفاجأة بدلاً من الحدس الرتيب بالإمكانية الوحيدة للتحقق.
خامساً: العيش اليومي يقترن في العادة مع مناسيب عالية من المأزومية العقلية والنفسية. عندما لا تعيش بحكم الضرورة وحدك فأنت تتفاعل مع آخرين، وهذا التفاعل قد يكون هادئاً أو مشحوناً بقدر من الصراع الوجودي. لا ترياق لهذا النمط الصراعي المحتوم إلّا بكتابته وتحويله إلى مغذيات إبداعية أولية للكاتب. تحدّث كثيرٌ من الكتّاب عن أنّ الكتابة أضحت لهم مثل تناول حبة الضغط اليومية اللازمة لعلاج ارتفاع الضغط الدموي لديهم. إنّهم صادقون تماماً. من غير الكتابة يصبحون أقرب لكائنات شيزوفرينية يكاد يقتلها الألم والعذاب.
يجعلنا الإبداع الفني كائناتٍ تدركُ قيمة الموازنة الدقيقة بين مناسيب العقلنة واللاعقلنة في الحياة
الأدب الجيّد مفتاحاً للتوازن
الأدب الجيّد بكلّ تلاوينه، مثلما كلّ فعالية إبداعية أخرى، ترياقٌ ناجع للتعامل مع الإفرازات السيئة المتلازمة مع وجودنا البشري. يخرجُنا الفن المبدع غير المأسور بمحدّدات الآيديولوجيا من محليتنا الضيقة ومحدّدات الزمان والمكان، ويؤجج جذوة المسعى الغلغامشي فينا طلباً لخلود افتراضي نعرف أنه لن يتحقق، ويكبح سطوة الإلهاءات في حياتنا ولو إلى أمد محدود كلّ يوم، مثلما يكبحُ مفاعيل الضوضاء البشرية فينا ويجعلنا نصغي بشهوة وتلذّذ إلى أصوات أعماقنا التي تقمعها الانشغالات البديهية والروتينية، ويفتح أمامنا نوافذ ميتافيزيقية تتيحُ لنا رؤية عوالم تخييلية ليس بمستطاعنا بلوغها من غير معونة الإبداع الفني.
بعد كل هذا يجعلنا الإبداع الفني كائناتٍ تدركُ قيمة الموازنة الدقيقة بين مناسيب العقلنة واللاعقلنة في الحياة.
تترتب على هذه المقايسات نتائج مدهشة أحياناً وغير متوقعة، يمكن أن تجيب عن بعض تساؤلاتنا الممضّة. منها مثلاً: لماذا تمتلك الأعمال الأدبية والفلسفية الإغريقية خاصية الراهنية والاستمرارية في التأثير والتفوق على كثير من نظيراتها المعاصرة؟ يبدو لي أنّ الفلاسفة والأدباء الإغريق كانوا عرضة لتشتت أقلّ من حيث طبيعة وحجم الإلهاءات؛ لذا جاءت مقارباتهم أقرب للتناغم مع تطلعات الإنسان وقلقه الوجودي؛ في حين تغرق الأعمال المعاصرة في التفاصيل الجزئية ذات الطبيعة التقنية، وهي في عمومها تقدّمُ المعرفة التقنية في فرعيات دقيقة عوضاً عن التأكيد على الرؤية الإنسانية الشاملة.
أظنها متعة كبيرة لو دقّقنا في الأعمال الأدبية العظيمة، ورأينا كم تتفق سياقاتها مع معايير الوظيفة الإبداعية كما ذكرتها أعلاه. أظننا سنكتشف أنّ هذه الأعمال لم تكن مستعبدة لنسق آيديولوجي باستثناء إذا أردنا وضع الإنسان في مرتبة الاهتمام الآيديولوجي الأعلى مقاماً من كلّ ما سواه. ثمّ إنها أبعدتنا عن الإلهاءات اليومية الروتينية، وفتحت لنا نافذة في قشرة الوجود البشري الصلبة، وأنقذتنا من تسونامي الصراعات اليومية.
الفن للفرد الذي يعرف كيف يجعل الفن وسيلة للارتقاء بمعيشه اليومي، ومن ثمّ تحويله لخبرة جمعية منتجة. ربما قد يكون حاسوبٌ، وكوبُ شاي أو قهوة، وشيءٌ من طعام بسيط في مكان بعيد عن ضوضاء العالم لبعض الوقت الذي نستقطعه من زحمة انشغالاتنا اليومية هو كلّ ما نحتاجه لنصنع أدباً جيداً، وقبل هذا لنعيش حياة طيبة يبدو أنّ كثيرين يغادرون هذه الحياة وهم لم يتذوّقوا ولو القليل من لذّتها الكبرى.