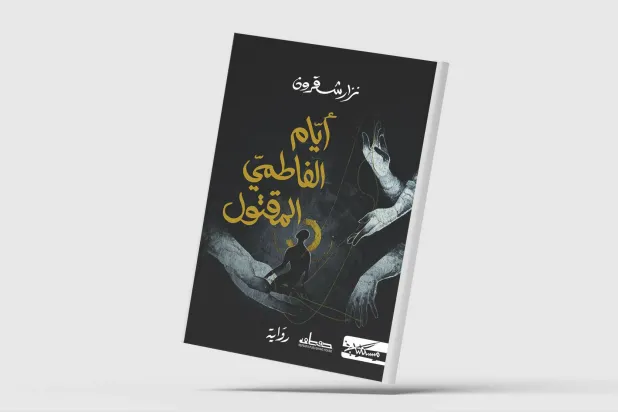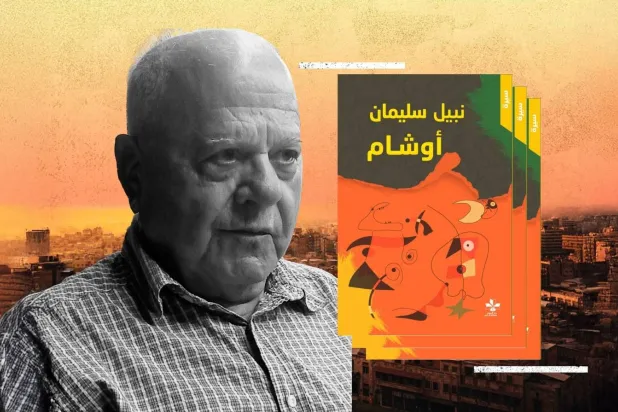تتوزع كتابات بول أوستر، الذي رحل أول من أمس عن 77 عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بين ثيمتين كبريين في أعماله الروائية وغير الروائية؛ هما الوحدة والعنف، اللذان يترابطان معاً، ويقود أحدهما للآخر، ويتبادلان أدوارهما ونتائجهما.
هذان الموضوعان انغرسا فيه منذ انطلاقته الأولى، شاعراً، ثم كاتب سيناريو، ومترجماً، وأخيراً روائياً؛ حيث وجد نفسه أكثر: «لم يكن أمامي أي خيار آخر، سوى أن أكتب، وأن أكرّس كل حياتي للكتابة»، كما قال مرة في إحدى المقابلات معه. كانت الكتابة متعته الكبرى، وربما وسيلة هربه الوحيدة من تهميش المجتمع الأميركي، ومن شعوره الدائم بالوحدة. لكن الكتابة هي أيضاً لعنته، كما يقول في الحوار نفسه.
من هنا اكتسب أوستر شعوراً مأساوياً بالحياة، ومن هنا أيضاً يمكن أن نطلق عليه «الضمير المأساوي للمجتمع الأميركي»، كما عبّر عن ذلك في أعماله، التي تجاوزت الثلاثين عملاً.
كاتب حياة
يصنف بعض النقاد أوستر ضمن روائيي «ما بعد الحداثة»، وآخرون يدرجونه تحت تيار التفكيكية، ويتحدثون عن أثر جاك دريدا علية فكرياً بعدما عاش أوستر بعض السنوات في فرنسا واطلع من كثب على كتابات دريدا. ويذهب البعض الآخر إلى تصنيف رواياته على أنها «روايات بوليسية». لكن أوستر ليس معنياً بذلك، بل على العكس يتحدث عن تأثير لويس بورخيس وديكنز وأميلي برونتي وتولستوي عليه، إضافة إلى الحكايات الأميركية الشعبية.
لا تنظير «ولا صفحات ذهنية أو فكرية» نعثر عليها في كتاباته، وإذا وردت هنا وهناك فهي تأتي ضمن نسيجه الروائي المحكم. صحيح أن هناك عناصر في بعض رواياته يمكن نسبتها إلى «الرواية البوليسية»، لكنها ليست العنصر الرئيسي، بل هي شكل روائي يقود إلى أبعد منه. أوستر كاتب حياة أولاً وأخيراً، كأي روائي كبير آخر..

في مذكراته «اختراع العزلة»، الصادرة عام 1982، وهي أول كتبه في هذا المجال، يتحدث أوستر عن بداية حياته بوصفه ابناً لأب غائب دائماً. والكتاب مليء بذلك الشعور الذي سينعكس في كل أعماله الروائية وغير الروائية: الحزن، والشعور بالفقدان، والوحدة، والضمير الشقي.
غصة الثلاثية
ولعل ثلاثيته، المكونة من «مدينة الزجاج» و«الأشباح» و«الغرفة الموصدة»، التي ارتبط اسمه بها، أكثر من أي عمل آخر، هي أكثر أعماله التي تعكس الثيمتين اللتين شغلتاه طوال حياته، وهما كما أشرنا: الوحدة والعنف.
عمل أوستر على الجزء الأول من الثلاثية عام 1981 ثم أعاد كتابة مسرحية له أنجزها قبل سنوات، ليحولها إلى جزء ثانٍ، ليلحقهما بجزء ثالث. ويبرر ذلك بقوله إن موضوع المسرحية الأولى والقسمين اللاحقين، هو موضوع واحد: الغموض، وكيفية تعلم العيش مع الغموض وعدم اليقين، وهذا هو جوهر «الثلاثية» كلها.
لماذا اعتبرت هذه الثلاثية أهم أعماله واشتهرت أكثر من غيرها، حتى إن خبر رحيله في أغلب الصحف العالمية ورد مقروناً بها؟
يشعر أوستر، كما يشعر كثيرون حين تقترن أسماؤهم بعمل واحد، بالغصة، وهو لا يعرف كيف يفسر ذلك، ويلقي اللوم على الصحافيين الذين يسارعون إلى وصف العمل الذي عرف اهتماماً ما من القراء بأنه أهم عمل للكاتب.

في عمله الثاني «قصر القمر»، الصادر عام 1989، يعود أوستر إلى ما طرحه في كتابه «اختراع العزلة»: شخصية منعزلة يبحث عن أب غائب، وكل محاولاته مصيرها الفشل؛ إذ يهاجر ستانلي فوغ من نيويورك ليتعقب ماضي عائلة في رحلة ذات مواقف كوميدية لا تفضي إلى شيء.
تتكرر ثيمة الوحدة والعزلة والبحث عن المجهول في رواية «كتاب الأوهام»، الصادرة عام 2002، بل إن شخصية ديفيد زيمر، التي كانت قد ظهرت في رواية «قصر القمر» وإن بشكل سريع، تعاود الظهور في الرواية الجديدة بوصفها شخصية رئيسية. إنه يعاني الوحدة، ونوعاً من التدمير الذاتي بعدما فقد عائلته في تحطم طائرة. ثم يصبح ممسوساً بشخصية هكتور مان، وهو ممثل اختفى قبل عقود، واعتبر ميتاً. ولكن بعدما كتب عنه، تسلم زيمر رسالة تفيد بأن بطله لا يزال حياً يرزق، وهكذا يتهاوى عالمه كله.
أما رواية «حمقى بروكلين»، الصادرة عام 2005، فتأتي كأنها نبوءة لمصير أوستر نفسه: رجل مصاب بالسرطان، يبحث عن مكان هادئ ليموت فيه، حتى يلتقي شخصاً يسبب له أزمة وجودية شديدة.
«4321»... رواية التتويج
وفي عام 2017، أصدر أوستر رواية «4321»، التي يمكن عدّها تتويجاً لمعظم أعماله. وهي رواية مركبة، خلط فيها أوستر أشكالاً سردية عدة بحرفية عالية، ولغة ظل طوال حياته يصقلها ويصفيها، فقد كانت اللغة عنصراً جوهرياً في أي عمل أدبي، وأحد مشاغله الأساسية، وينبغي أن تكون محل اهتمام أي روائي يريد أن يقدم أعمالاً جديرة بالبقاء.
وكان كتاب أوستر الأخير عملاً غير روائي، حول العنف في أميركا وقد صدر عام 2021 بعنوان «الشعب الدموي». وكان الزميل الدكتور سعد البازعي قد استعرض هذا الكتاب في هذه الصفحة حين صدوره، وترجم الكتاب لاحقاً أيضاً، وهو «توثيق للعنف وتأملات تحليلية حول جذوره وأسبابه ومآلاته»، وحلّل «أبعاد النزاع الدموي الذي ظلل التاريخ الأميركي منذ بداية الاستيطان حتى أيامنا هذه».
والحقيقة، أن أوستر قد دخل ذلك النفق الرهيب قبل سنتين من رحيله، وحينها كتبت زوجته:
«أعتقد أنه سيكون أمراً فظيعاً أن تكون وحيداً في (أرض السرطان)، العيش مع شخص مصاب بالسرطان يتعاطى العلاج الكيميائي والمناعي، هو مغامرة في القرب والابتعاد. يجب أن يكون الشخص قريباً بما فيه الكفاية ليشعر بالعلاجات التي تنهك جسد المريض كما لو أنه هو المعني بتعاطيها، وفي الوقت نفسه يكون بعيداً بما فيه الكفاية ليتمكن من تقديم المساعدة الحقيقية. فالشفقة الزائدة قد تشعر المريض بأنه عديم الفائدة! ليس من السهل دائماً القيام بهذه المهمة الحساسة».