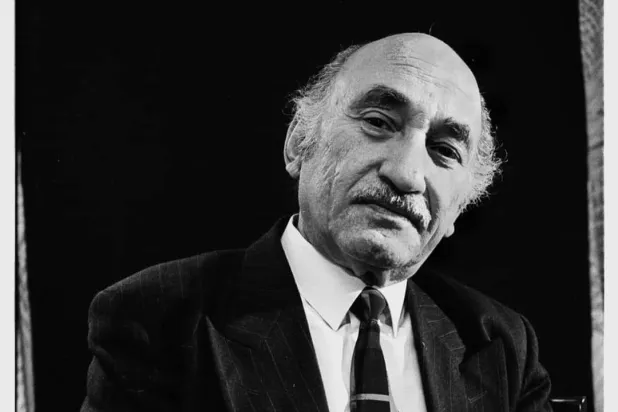غالبا ما ينظر الباحثون في قضية الاستشراق نظرتهم في أصعب المسائل وأشدها إرباكاً، ذلك بأن هذه القضية تتعلق مباشرة بإشكالية الهوية الذاتية الجماعية التي يعتصم بها أبناء المجتمعات العربية، وفي يقينهم أنها تقيهم انحرافات الانحلال الحضاري، والضياع الثقافي، والوهن السياسي. لذلك آثر معظم أهل الاختصاص أن يغلقوا على الاستشراق في محنة التنازع بين ضربين من التطرف: فإما أن يغالي الاستشراق في رسم الآخر الشرقي على صورة الذات الغربية، وهذا ما يحصل في أغلب الأحيان، وإما أن يكتفي برسم الذات الغربية على صورة الآخر الشرقي، من بعد أن يهيم المستشرق بسحر الشرق وعجائبه. لا بد، والحال هذه، من البحث عن الحل الوسطي الذي ينتقد الاستشراق من غير أن يكفره، ويمدحه من غير أن يمجده.
أعتقد أن أفضل السبل يقتضي الشروع في ثلاث خطوات منهجية أساسية: ينبغي للمرء أولاً أن يتفحص الخلفيات الثقافية والسياسية التي دفعت بعلماء الغرب إلى الاعتناء بالشرق العربي على تنوع منبسطاته الجغرافية وتباين تجلياته الحضارية، ويجب عليه ثانياً أن يميز تمييزاً حصيفاً بين منابت الاستشراق وأصنافه؛ إذ إن الاستشراق مذاهب وتيارات وتوجهات؛ ويتعين عليه ثالثاً أن يتحرى الآثار السلبية والإيجابية التي خلفها الاستشراق في وعي المجتمعات الشرقية، لا سيما العربية منها، ويستقصي الأبعاد التفاعلية التثاقفية التي استولدها التقابس الحضاري بين الغرب والشرق.

أبدأ أولاً بالخلفيات الثقافية والسياسية. من الواضح أن أزمة الاستشراق تقترن بأسباب سياسية ومعرفية. إذا اكتفى المرء بالأسباب السياسية، اتضح له أن عوامل الفساد المعرفي في بعض الاجتهادات الاستشراقية ترتبط بالخلفيات الثقافية التي ينتسب إليها المستشرق، وبالتصورات الآيديولوجية التي يبايعها، وبالأنظومات والهيئات السياسية التي تدعم مشروعه الاستشراقي وتموله. أما إذا تناول المرء الأسباب المعرفية، فإن البحث يضحي أشد استنهاضاً للعقل المستنير؛ إذ يحثنا على استجلاء العوامل المعرفية المحض التي تجعلنا نرتاب من عملية الاستشراق في مقتضياتها المعرفية. ذلك بأن فهم الشرق العربي فهماً غربياً يختلف عن فهم الشرق العربي فهماً شرقياً عربياً. من جراء الاختلاف الخطير في الأنظومات الثقافية السائدة في الغرب وفي الشرق العربي، يستحيل على المستشرق أن يدرك خصوصية الفرادة الذاتية التي ينطوي عليها تراث الآخر.
أمضي ثانياً إلى التمييز الضروري بين منابت الاستشراق وأصنافه. يعلم الجميع أن البلدان الأوروبية التي توسعت توسع الاستعمار، ومنها على سبيل المثال بريطانيا وفرنسا وروسيا، ناصرت استشراقاً خاضعاً في بعض الأحيان لمصالح السياسات الخارجية الاستعمارية. أما البلدان الأوروبية التي لم تختبر إرادة الاستعمار في أقصى اندفاعاتها التوسعية، ومنها على سبيل المثال ألمانيا غير النازية والنمسا وهولندا، فإن استشراق علمائها استطاع أن ينعتق من خلفيات المصالح التوسعية، فاتسمت مبادراته الفردية بالوداعة المعرفية والانفتاح الرضي والرغبة الصريحة في التعلم والاستمتاع بإنجازات الحضارة العربية وفتوحاتها الثقافية وأمثولاتها الروحية. لا ريب في أن مثل هذا التصنيف لا يعني أن جميع الاجتهادات الاستشراقية المقترنة بمشيئة البلدان الاستعمارية كانت انحيازية تضليلية مؤذية، وأن الاجتهادات الأخرى كانت كلها موضوعية منزهة هادية. أعتقد أن في الاستشراق الثقافي المحض بعضاً من النزعة الاستعمارية الدفينة، وفي الاستشراق الاستعماري الصريح بعضاً من الحكمة المعرفية الحميدة.
زدْ على ذلك أن الاستشراق الأدبي غير الاستشراق العلمي، وكلاهما غير الاجتماعي والسياسي. ذكرت هذه الأصناف لأبين أن استشراق الأدباء الأوروبيين، لا سيما الرحالة من أمثال الرحالة البريطاني سير ويليام جونز (1746 - 1794) صاحب البحث الشهير في الشعر الشرقي ومترجم المعلقات العربية السبع، والفرنسي أنطوان - سيلڤستر دساسي (1758 - 1838) صاحب الأبحاث التاريخية في فقه اللغة العربية ومترجم نصوص فريد الدين العطار، والألماني المختص بالأدب العربي المسيحي غيورغ غراف (1875 - 1955)، ساهم مساهمة جليلة في استكشاف كنوز الأدب العربي القديم.
من الضروري في هذا السياق أن أخص الاستشراق الألماني بذكر طيب؛ إذ انفرد بميله الأكاديمي الصِّرف ورغبته الصادقة في الانعتاق من سطوة السلطان السياسي. صحيح أنه من العلوم الدخيلة في ألمانيا، ولكنه ما عتّم أن اندمج في النظام البحثي الجامعي الألماني، وقد آزرته العوامل السياسية المتعلقة بانكفاء المقاطعات الألمانية وإعراضها عن التوسع الاستعماري الجامح. فاكتفى المستشرقون الألمان بفضيلة البحث العلمي المحض، ولو أن الجيل الرومانسي من الاستشراق الألماني عاد فاستثمر لاحقاً الأبحاث المنجزة في توطيد التصورات القومية الجرمانية. بفضل جهود المستشرق الألماني هاينريش فلايشر (1801 - 1888) الذي اعتنى بتحقيق نصوص أبي الفداء والزمخشري والقاضي البيضاوي، تأسست في مدينة لايبتسيش عام 1845 الجمعية المشرقية الألمانية، وغايتها احتضان الاستشراق الألماني في إطار المؤسسة البحثية المستقلة.
أما ما اتصف به الاستشراق الألماني فالاجتهاد في تطوير فقه اللغة المقارن، والاستناد إلى خلاصاته من أجل تعزيز الأبحاث المتعلقة بطبائع الأعراق والأقوام والسلالات. ترسخ هذا التوجه بالاستناد إلى أعمال الفيلسوف الألماني لايبنيتس (1646 - 1716) الذي كان يولي اللسانيات مقام الصدارة؛ إذ كان مقتنعاً بأن الكلمات التي تختزنها معاجم الشعوب تكشف لنا عن هوية هذه الأقوام وأصلها وصلات القربى المنعقدة بينها وترحالاتها المتعاقبة. فضلاً عن ذلك، اتصف الاستشراق الألماني بالاعتناء الدقيق بدراسة اللغات القديمة، لاسيما السنسكريتية والسومرية، وذلك بخلاف الاستشراق الفرنسي أو الإنجليزي الذي كان شديد الميْل إلى تناول مسائل السياسة والتجارة والإدارة في الشرق.
أختم ثالثاً باستجلاء الآثار التي وَلّدها الاستشراق، على تباين وجهيه السياسي والثقافي، في الوعي العربي الحديث والمعاصر. إذا أردنا أن ننصف الظاهرة الاستشراقية العالمية هذه، سارعنا إلى التذكير بأن التأثير كان متبادلاً، أي ناشطاً في الاتجاهين. ذلك بأن المجتمعات العربية أدركت بفضل الاستشراق مقدار الغنى الحضاري الذي يختزنه تاريخها الأثيل، وقد اكتنفته ظلال الجهل منذ انطفاء شعلة التألق الحضاري العربي في القرن الثالث عشر حتى اتقادها مجدداً في عصر النهضة العربية الأولى في القرن التاسع عشر. لا بد من امتداح الجهود الجبارة التي بذلها أهل الاستشراق الأوروبيون من أجل الكشف عن وثائق الوعي الثقافي العربي التي كان غبار الدهر يلفها في مكتبات العواصم العربية والغربية. أعرف أن هذا الجهد خضع في بعض الأحيان لتأويلات الوعي الحضاري الغربي. فكانت التسمية غربية، والمنهجية غربية، وكذلك طريقة التفكير وردود الفعل والأحكام والخلاصات.
ولكن كيف لنا أن نطلب من المستشرق الغربي أن يكف عن انتمائه الغربي، وأن يُجرّد وعْيه من ذاتيته الثقافية؟ الحقيقة أن الاستشراق فعل ثقافي خطير يُغني الذات حين تنظر في مرآة الآخر، يستفزها باختلافاته واستنهاضاته. لا يمكننا على الإطلاق أن نحرر الاستشراق من سحر الشرق، ولو أن أثر هذا السحر تجلى على وجوه شتى. لا ينجو المستشرق باستشراقه من شمس هذا الشرق ووهجها الحراق. فإذا به يرتد إما إلى ذاته يعيد النظر فيها، وإما إلى الشرق فيعتنق الإسلام أو الهندوسية أو البوذية أو المسيحية الشرقية كما فعل المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون (1883 - 1962).
كيف لنا أن نطلب من المستشرق الغربي أن يكفّ عن انتمائه الغربي وأن يجرّد وعْيه من ذاتيته الثقافية؟
أعتقد أن أزمة الاستشراق انبعثت حين انحرف المستشرقون في الحكم على قضيتين خطيرتين: مقام الإسلام في الوعي الحضاري الكوني، وصدارة الخصوصية الحضارية الأوروبية. يعلم الجميع أن بعض المستشرقين شيّعوا صورة قاتمة عن الدين الإسلامي، وقد استندوا إلى تأويلات قرآنية مجتزأة مبتورة. فأطلقوا الأحكام الظالمة المتعلقة بهوية الإسلام وتقويم مساره التاريخي ووظيفته الحضارية، فاختلط الاستشراق بمشكلات الحوار الديني اللاهوتي العسير المرْكَب. كذلك عمد بعضهم الآخر إلى البرهان على تفوق الحضارة الغربية الأوروبية، وفي مستندهم بعض الوقائع التي تدل على تفوق في المعرفة والعلم والاقتصاد.
أسوق مثالاً على عملية تسويغ التفوق الغربي، أستخرجه من اجتهادات بعض المستشرقين الرومانسيين الألمان الساعين إلى استثمار الأبحاث اللغوية المقارنة من أجل مناصرة الخصوصية الأوروبية. حاول رائد الرومانسية الألمانية مجدد النقد الأدبي فريدريش شليغل (1772 - 1829) أن يستند إلى أبحاثه اللسانية في نحو اللغة السنسكريتية لكي يبرهن في كتابه (في لغة أهل الهند وحكمتهم) أن السنسكريتية والفارسية من جهة، واليونانية والألمانية من جهة ثانية، لغات تشترك في خصائص لسانية أساسية لا تشترك فيها اللغات السامية والصينية والأمريكية والأفريقية. من جرّاء هذه المقارنة، خلص إلى إثبات وحدة الأقوام الأوروبية المنبثقة كلها من قوم أصلي افترض أنه عاش في الهند القديمة الممتدة بين منطقتي كشمير والتيبت وتكلم باللغة السنسكريتية. ومن ثم، استند شليغل إلى قاعدة الوحدة اللغوية المفترضة لكي يعارض الأقوام الهندو-أوروبية بالأقوام الأخرى، لا سيما السامية منها، ويستنتج أن اللغات التي يستخدمها غير الأوروبيين أدنى مرتبة في جماليتها التعبيرية.
خلاصة القول أن الاستشراق اجتهاد ثقافي يفصح عن طبيعة الذات المستشرقة قبل أن يكشف عن خصائص الشرق المنشود. واجب العقل المستنير أن يستثمر أبحاث الاستشراق من أجل إدراك خصوصية كل شعب على حدة، وفرادة شخصيته التاريخية، وقيمة مساهمته الحضارية.