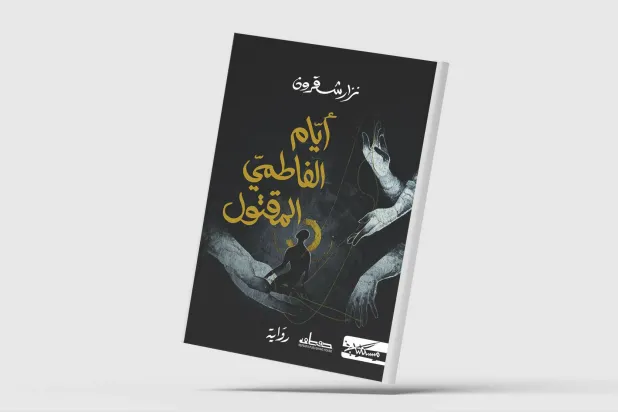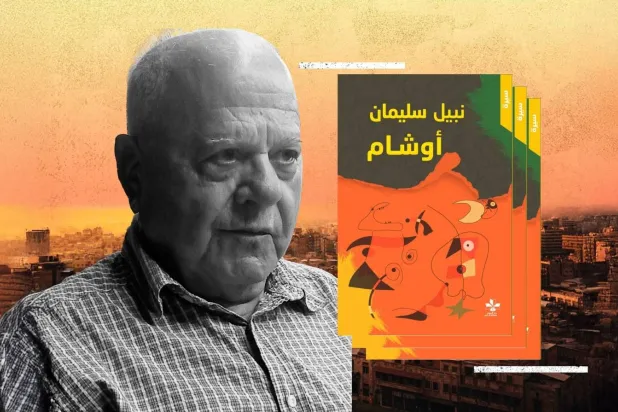كان أبي يأخذني إلى الدور الرابع من بيتنا القديم. وهناك تنتصف لحظة لها جناحان! فعلى يساري تتوهج غابة النخل ريشاً أخضر. وعلى اليمين تنبسط زرقة الخليج، لازوردية تتماوج في عيني الطفلة، بتشكيلات مثيرة من أجنحة النوارس البيضاء، وشباك الصيادين، وحوريات البحر.
استكمالاً لبناء الصورة الأسطورية في مخيلتي عن عالم البحر، بلآلئه وأسماكه وجنياته، بسفنه وصياديه وغواصيه، طفقت أرسم السؤال ملحاحاً في صدر أبي... عن البحرين... فيشير بيده الساطعة... إنها هناك. ويضيف وهو يحملني على كتفه: بإمكانك أن تراها، بمجرد أن تتبع خط سير السفن الشراعية، المحملة بالتمر والموز واللوز والليمون، وهي تمخر عباب البحر إلى المنامة.
سألت أبي ذات مرة: ألم تذهب إلى البحرين؟ فأجابني: بلى... لقد زرتها بقصد العلاج في مستشفى الإرسالية الأميركي!! وقد قضى فيها شهراً أو يزيد، كان خلالها ممتلئاً بصور مدهشة غريبة عن سياقه الاجتماعي. فهناك وجد الناس يرتدون أزياء «عولمية» بهيئة لم يألفها، ويتكلمون بألسن مختلفة، حتى أن الاقتراض اللغوي من الهندية والفارسية والإنجليزية كاد يؤثر على فصاحة أبنائها العربية. الطرق هناك نظيفة، والأسواق منظمة، والوجوه تفيض بالحيوية والتحدي، فالناس معظمهم متعلمون، أصحاب هوايات، ورياضات، يقرأون ويلعبون، يمتطون الحمير، و«حصان إبليس»، ويركبون السيارات! يجدون في أوقات الجد، ويهزلون في أوقات الهزل.

يوماً بعد يوم، وسنةً وراء سنة، كان اسم البحرين يكبر في رأسي، ويمتلئ بها وجداني، وأنا أنصت إلى الحكايا عنها، في البيت والسوق والمقهى، حتى استجد بعد ذلك عامل له الأثر الحاسم في بناء الصورة وتفكيك المخيلة.
إنه الصوت الآتي عبر المذياع، وهو يحمل فخامة الأداء في صوت إبراهيم كانو وأشعار إبراهيم العريّض، وآراء حسن جواد الجشي، وأحاديث محمد جابر الأنصاري، وبرنامج علوي الهاشمي وبهية الجشي الأدبي.
إذن... فالبحرين على عتبة الاستقلال الوطني.
وهنا قررت اختراق هذا العالم المتخيل، وكنت أتخطى السابعة عشرة... راكباً السفينة من ميناء الخبر، في منتصف نهار قائض، لأقضي ساعات أربع بين أقفاص الدجاج، وقلات التمر، مع مجموعة من المسافرين، بينهم فلاحون عجزة من القطيف، وشباب من عمال شركة «أرامكو»، وفد هؤلاء وغيرهم على البحرين لقضاء حاجاتهم أو إجازاتهم الصيفية أو الأسبوعية، بين أقاربهم أو معارفهم في هذه الجزيرة السحرية العجيبة. غير أن الرحلة مع بكارتها لم تكن رومانسية! فحين وصلنا ميناء المنامة، لم تأخذنا السفن الشراعية الصغيرة إلى «الفرضة» كما فعل الزمان قبل قرن بأمين الريحاني الشاعر والأديب والرحالة الذي فتن بالشيخ المستنير إبراهيم بن محمد آل خليفة، الذي فصل فيه القول د. الأنصاري... وكذلك المفكر الألمعي د. نادر كاظم في كتابيهما عن هذه الشخصية المتنورة... لكني سنة 1971 لم أجد تلك النجوم الرقراقة المنعكسة على صفحة البحر، التي وصفها في كتابه «ملوك العرب»، ولم أر الحمير والأتن التي كانت تملأ الطرق والأسواق.
لقد وجدتني وكأنني في القطيف! فسوق السمك في المنامة هو سوق السمك في حي الشريعة، وفلاحو جد حفص هم فلاحو القديح، ونخل سترة هو نخل أم الحمام، وعين عذاري هي عين داروش، وعمال المحرق هم عمال الدمام، وشارع الشيخ عبد الله هو سوق الصكة.

إذن ما الذي استلفت نظري. في ذلك الصيف المبهر؟ إنه سينما أوال، ونادي العروبة، والمكتبات، وأسرة الأدباء والكتاب، وتلك الكوكبة المشرقة بالحيوية والإبداع. علوي الهاشمي، وعلي عبد الله خليفة، وقاسم حداد، ومحمد عبد الملك، ومحمد الماجد.
كان هؤلاء شعراء وقصاصو الموجة الجديدة يحتلون موقعاً جيلياً واقعياً حداثياً، أشب من جيل حسن جواد الجشي، ومحمد جابر الأنصاري وعبد الله الشيخ جعفر القديحي وغازي القصيبي وعبدالرحمن رفيع... بينما كان إبراهيم العريّض يحتل موقعه الرومانسي والانطباعي مجدداً وحده في مجال الشعر والدراما والنقد.
هكذا وجدته وأنا أتردد عليه ضحى كل يوم في متجر أحد أصدقائه في شارع الشيخ عبد الله، محاطاً بهالة أسطورية.
لم لا؟!
وقد تخطت سمعته ناقداً أدبياً ومترجماً لرباعيات الخيام حدود البحرين إلى آفاق العالم العربي... لكن من افتقدته هو محمد جابر الأنصاري، وكان محاطاً بهالة رئاسته لدائرة الإعلام (أي وزيرها) قبل استقلال البحرين، وكذلك المعارك الأدبية التي خاضها في الصحافة، بعد عودته من الدراسة الجامعية في بيروت، بعد ابتعاثه لدراسة اللغة العربية والأدب في جامعتها الأميركية، حيث جرت معركة أدبية بين محمد جابر الأنصاري والصحافي محمود المردي، الذي زرته في مكتب جريدته «الأضواء»، وقد انتصر الأنصاري للشعراء والقاصين الجدد من الشباب، الذين وصفهم المردي بـ«المتأدبين»! راداً عليه الأنصاري، مؤكداً أنهم أدباء وشعراء لهم تجاربهم المميزة، داعياً المردي إلى أن يركز على الشؤون الصحافية الخاصة بارتفاع أسعار البصل والطماطم ومشكلات البلدية، ويترك الشؤون الأدبية للمختصين!

وقد أوضح علي الشروقي أنّ سعة الصدر التي تمتع بها الأستاذ محمود المردي كانت مميزة، فقد خصص ما يقارب ربع عدد صفحات الجريدة لهؤلاء الأدباء الشباب، وأصبح أكبر داعم لهم. بل إنه ملك من الشجاعة الأدبية بأنه كان ينشر المقالات التي كان فيها نقد شديد له شخصياً، من ضمنها المقال شديد اللهجة الذي كتبه الأنصاري، ينشرها كاملة بسعة صدر، دون أن يقتطع كلمة واحدة منها.
أما المعركة الأخرى فكانت بين الشاعر غازي القصيبي وأسرة الأدباء والكتاب. الذي ألغى عضويته فيها... وكان مثار هذه المعركة يتركز حول مفهوم الالتزام الذي روّجت له الأسرة. واحتج القصيبي في رده على القاص محمد الماجد على المعيارية السياسية التي تزن بها الأسرة الأدب، إذ إنها تهتم بأن يكون الأدب محملاً بالقضايا الوطنية والعربية والإنسانية، وإلا يصبح الأدب ترفاً. وكان غازي يكتب المقالات الساخرة الناقدة للشعارات الآيدولوجية، مذيّلة باسم «ابن عبد ربه». ثمّ أخذ يكتب مقالات أقل سخرية وحِدّة باسمه، ولم تعجب مثل هذه المقالات الساخرة مؤسسي الأسرة، على رأسهم الدكتور محمد جابر الأنصاري، فشنّوا هجوماً صحافياً نارياً على غازي القصيبي، عادين أنّ شعره مفتقد للحرارة - ربما بسبب وضعه الطبقي - تضامنوا للرد على كتابته الساخرة... هذا ما لمسته من حواري مع الشاعر علي عبد الله خليفة، الذي التقيته في تلك الزيارة، بدائرة الموانئ مرتدياً بذلته البحرية البيضاء... وحين سألته عن قاسم حداد، أخبرني ممتعضاً بأنه دخل في الغيبة الصغرى!
العجيب أنه بعد سنوات طويلة من هذه المساجلة بين د. محمد جابر الأنصاري وصديقه د. غازي القصيبي، أجرت مجلة «العربي» الكويتية سجالاً بين الصديقين، اللذين تعمقت علاقتهما الشخصية والفكرية كلما تقادم الزمن بهما، أن استمر الحوار بينهما حول «الالتزام»!
فهذا هو الأنصاري يستذكر ماضي معركته معه! فيقول لغازي:
في زمن الشباب الشعري والنقدي - عندما اختلفنا أنت وأنا حول مفهوم الالتزام وأهمية الشعر القصوى في حياة الشاعر - كنت تصر على أن الشعر جانب من جوانب حياتك، وأنك لا ترى أن الشاعر يتجرد كلياً للشعر أو يعتبره همه الأول، وأنه يمكن أن يكون أشياء أخرى في الحياة بالإضافة لكونه شاعراً. وخلال مسيرتك في الحياة أثبت هذا الرأي بالفعل، فكنت إدارياً وأكاديمياً ووزيراً وسفيراً بالإضافة إلى كونك شاعراً، ولكن تجربتك أثبتت أن الشاعر الذي جعلته يتعايش فيك مع الإداري والأكاديمي... إلخ، هو الذي كانت له الكلمة الفاصلة عندما برزت مسألة الأولويات في تقرير الهواية والمسيرة الحياتية، وأن الكلمة الشعرية كانت هي الكلمة. وأن الوجود الشعري كان هو الوجود. وأعني بالشعر هنا معناه الكياني كالتزام حياتي وكصفاء وقيمة وليس كفنٍّ محض. كيف تتفاعل مع زعمي هذا؟!
ويجيبه غازي:
لا يبدو أن نقاشنا المزمن حول «الالتزام»، ذلك الذي بدأ قبل ربع قرن سينتهي أبداً، رغم محاولاتك ومحاولاتي الدائمة للتقريب بين الموقفين. مشكلتي مع «الالتزام»، أني أراه صفة خارجة عن الشاعر، مسقطة عليه من طرف آخر (هو غالباً الناقد). عندما نقول إن شاعراً ما شاعر «ملتزم» فنحن نعني أنه «ملتزم» بما نعده نحن قِيماً ومُثُلاً يجب الالتزام بها. لا أتصور أن ناقداً يمينياً سيمجد «ملتزماً» شاعراً (يسارياً)، والأرجح أنه سيعتبره تخليّاً عن الالتزام الحقيق أو أن ناقداً يسارياً سيمجد التزام شاعر «يميني»، والأغلب أن يسمى «الالتزام» رجعية، أو بورجوازية. «الالتزام» منحة من النقاد الملتزمين - أو القراء الملتزمين - لذلك الإنتاج الذي يتواءم مع مواقفهم السياسية والدينية والفكرية.
عام 1976 جاء الأنصاري - ربما لأول مرة - إلى الرياض بدعوة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب... وفوجئت بمدير علاقاتها العامة علي آل علي يدعوني إلى عشاء خاص في بيته تكريماً لزائرهم، الذي بدأ ينشر مقالاته الأدبية والثقافية فوق صفحات مجلة «الدوحة» القطرية في بداية انطلاقتها برئاسة الأديب الأكاديمي السوداني محمد إبراهيم الشوش... ومنذ اللحظات الأولى حلت كيمياء قبول متبادل بيني وبين الأنصاري، الذي كان وقتها يعمل على إنهاء أطروحته للدكتوراه في النزعة التوفيقية في الفكر العربي المعاصر... التي قدمها للمناقشة سنة 1979.
بعدها بسنوات أربع، سنة 1983، دعوته للمشاركة في كتابة مقال أسبوعي في إصدار جريدة «الرياض الأسبوعي» تناول فيه عديداً من القضايا الأدبية والفكرية والسياسية... وكان من أوائل الكتاب العرب الذين دعوا إلى إعادة علاقة المملكة مع الاتحاد السوفياتي قبل انهياره.
وأتذكر من مقالاته، نقده الشديد للناقد الأدبي المصري د. لويس عوض، بعد إصدار كتابه المتحامل ضد جمال الدين الأفغاني، وقد نشرها مقالات مسلسلة في مجلة «التضامن» الصادرة في لندن وقتذاك، إذ ذهب د. الأنصاري إلى أن لويس عوض ومن هم على شاكلته لا يريدون بهذه المقالات رأس الأفغاني... بل يريدون الرؤوس الكبيرة في نهضتنا العربية كلها، من الإمام محمد عبده إلى عبد الرحمن الكواكبي إلى مصطفى عبد الرازق إلى ساطع الحصري... بل يريدون رأس الفكرة العربية والإسلامية كلها، وقد صورت مقالات لويس عوض، جمال الدين الأفغاني، بأنه رجل غامض مشوه الهوية والانتماء، مزعزع العقيدة مشتت الفكر ومزدوج السلوك، مشيراً إلى أن فكر النهضة العربية، الذي بدأ بعد غزو نابليون مصر، مؤسس على سلوك خاطئ وفكر مرتبك، مفيدًا - أي د. الأنصاري - من مقالات رجاء النقاش، الذي زامل الأنصاري في الكتابة الشهرية بمجلة «الدوحة»، مفنداً أطروحة لويس عوض، بمقالاته التي جمعها في كتابه «الانعزاليون في مصر» آخذاً على عوض انتصاره ليعقوب صنوع - اليهودي الديانة - الذي تعامل مع الغزو الفرنسي، مُسّهلاً للفرنسيين تنفيذ خططهم الثقافية في مصر والمشرق العربي، وقد تحمس صنوع لظاهرة كمال أتاتورك في تركيا، بعلمنة المجتمع الإسلامي التركي.