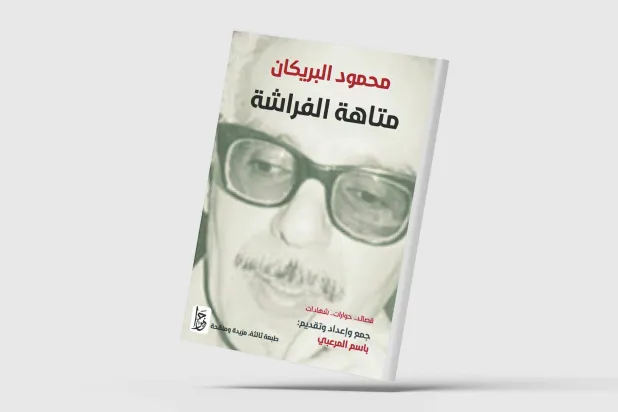إنَّ نقد المؤلفين والكُتاب، مِن قِبل الآخرين، عادة جارية منذ القِدم، وقد وقف عليها أصحاب الكُتب، فتوصلوا إلى حقيقة، أنه ليس مِن كتابٍ قط خرج مِن تحت يد مؤلفه مكتملاً، خالياً مِن الخطأ أو التَّصحيف، أو مِن زلةٍ في نقل المعلومة، وأعني هنا بالكتب التي تتطلب البحث والرفد بالرّوايات والأقوال، فالمؤلف الذي أنجز سبعمائة صفحة، وكتاباً بثمانين جزءاً، في طباعة اليوم، أو أقل أو أكثر، حتّى لو راجع كتابه سبعين مرة لغفل عن الخطأ، لأن النّص نصه، فيمر عليه، وفي ذهنه صورة، وقد كتب صورة أخرى، كالذي يتهجى حروف اسم ما، لكن ذهنه صورة معينة، تحتشد في ذهنه المترادفات، ولتقريب الصّورة، وهي مثال لا حصر، قد يقرأ الحروف (ب-ح-ر) «بحراً».
أمّا عن مراجعة الكتاب لـ70 مرة، ولا يخلو الكتاب مِن الخطأ، فهي مقالة إسماعيل بن يحيى المُزنيّ صاحب الإمام الشَّافعي (تـ: 364هـ): «لو عُورض كتابٌ سبعين مرة لوجد فيه خطأ، أبى الله أن يكون كتاباً صحيحاً غير كتابه» (الخطيب البغداديّ، موضح أوهام الجمع والتّفريق). فيا ترى مَنْ يقدر على التَّمام، وعلى ردّ نقد الجميع!

أقول: مع تكرار التَّصويب أو التَّصحيح، حتَّى أكثر مِن سبعين مراجعة، سيعثر القارئ على خطأ فيه، هكذا صرح بها الأولون مِن تجربةٍ. قال الأديب والكاتب إبراهيم بن العباس الصُّوليّ (تـ:243هـ): «المتصفح للكتاب أبصرُ بمواقع الخلل فيه مِن منشئه» (أبو منصور الثّعالبيّ، الإعجاز والإيجاز). ورويت بما لا يختلف: «والمتصفح للكتاب أبصرُ بمواضع الخلل مِن مبتدي تأليفه» (ياقوت الحَمويّ، معجم الأدباء/إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب).
لأنّ المتصفح قد أتاه الكتاب جاهزاً، لم يشغل ذهنه ما فيه مِن كلمات وحروف، وروايات وأسانيد، وعمل سنة أو سنتين، أو أكثر بكثير، فالمؤرخ العراقيّ جواد عليّ (تـ: 1987) شغله تأليف «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» أربعين عاماً متواصلة، ولم يعينه فيه أحد، مِن جمع مواده إلى كتابته إلى مراجعته ثم الإشراف على طبعه (كتب معاناته في مقدمة مفصلة). لكنّ المتصفح أو النّاقد يأخذ الخطأ الوارد فيه ويجعله فتحاً مبيناً له. وإذا توهم مصطفى جواد (تـ: 1969) ونسب كتاب الحوادث الجامعة لابن الفوطيّ الحنبليّ (تـ: 723هـ)، وهو لمؤلف مجهول، لم يلتفت النّقاد أو المتصفحون إلى اعتذاره، بعد حين، فظلوا متمسكين بالخطأ، لكن اكتشافاً اكتشفه جعله يتراجع ويعترف بتوهمه.
أكثرَ الكُتاب الأقدمون بشرح معاناتهم، حتّى صاغها عمرو بن بحر الجاحظ (تـ: 250 هـ) وصايا للمؤلفين، قائلاً: «ينبغي لمن يكتب كتاباً، ألا يكتبه إلا على أنَّ النَّاس كلّهم له أعداء، وكلُّهم عالم بالأمور، وكلُّهم متفرغ له، ثم لا يرضى بذلك حتَّى يدع كتابه غُفلاً، ولا يرضى بالرَّأي الفطير، فإن لابتداء الكتاب فتنةً وعجباً، فإذا سكنت الطَّبيعة، وهدأت الحركة، وتراجعت الأخلاط، وعادت النَّفس وافرة، أعاد النَّظر فيه، فيتوقف عند فصوله، توقف من يكون وزن طمعه في السَّلامة، أنقص مِن وزن خوفه مِن العيب» (الجاحظ، كتاب الحيوان). بأشد منها أوصى إبراهيم بن سيار النَّظام المعتزليّ (تـ: 231-231هـ) لمَنْ يُصنف الكتب ويشتغل بعلمٍ ما: «العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كُلَّك، فأنت مِن عطائه لك البعض على خطر» (البغداديّ، تاريخ بغداد)، بمعنى أن يُكرس المؤلف كل حياته لتأليفه في العلم الذي يفقهه، فهي حرفة ليست ككل الحِرف.
عبر ما نُسب للقاضي الفاضل عبد الرّحيم بن عليّ اللَّخْميّ (تـ: 596هـ)، قاضي وأديب دولة صلاح الدّين بمصر، أو لصاحبه الكاتب العماد محمَّد بن محمَّد الأصفهانيّ (تـ: 597هـ) مِن عبارة، تعكس قلق المؤلف، بعد خروج كتابه إلى القراء، ويأخذون بتداوله، فتنهال النّقود تباعاً عليه، مِن أتراب الحِرفة، ومِن غيرهم مِن ناقدين ومتصفحين، فليس هناك ما يؤكد أيهما كتب إلى الآخر، القاضي أم الكاتب: «إنَّه قد وقع لي شيء وما أدْرِي أوقعَ لك أم لا، وها أنا أُخبركَ به، وذلك أني رأيتُ أَنَّهُ لا يَكْتُب إنسانٌ كتاباً في يومه إلّا قال في غَدِه: لو غُيِّرَ هذا لكانَ أحْسَن ولو زِيْدَ لكانَ يُسْتَحْسَن ولو قُدِّم هذا لكانَ أفْضَل، ولو ترك هذا لكانَ أجْمَل وهذا من أعظم العِبَر، وهو دليلٌ على استيلاء النَّقص على جُملة البَشَر» (حاجي خليفة، كشف الظُّنون، مقدمة المؤلف).
مَن كتب مقالاً ولم يتحمل ردود الفعل ولم يوافق على سماع نصيحة محرر جريدة أو مجلة أو رأي مغاير فيه يبقى ذلك المقال يتيماً لا يكتب غيره
يبدو أول مَن ذكرها حاجي خليفة (تـ: 1609م) بأنها للقاضي الفاضل، وخليفة متأخر كثيراً، ولا يذكر أين وجدها، لكنّها قد شاعت للكاتب العماد، مع العلم أنَّ لا كتب القاضي ولا العماد قد حوت هذه العبارة، بينما نادراً ما تجد كتاباً لم يعتذر صاحبه بها، من احتمال الخطأ، ويجعلها الغالب منهم للعماد. أمَّا مَن اعتقد أنّ أول الناقلين له هو النّهرواني (تـ: 988هـ) في «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام»، فلا وجود لها في هذا الكتاب.
غير أنَّ للجاحظ قولاً مشابهاً سابقاً، على الفاضل والعماد، كتبه إلى أحد الوجهاء: «وهل فيك شيءٌ يفوق شيئاً، أو يفوقه شيء؟ أو يُقال: لو لم يكن كذا لكان أحسن، أو لو كان كذا لكان أتم» (الجاحظ، رسالة التّربيع والتَّدوير). فهل يكون هذا القول هو الأساس في ما سارت به الرّكبان مِن عبارة؟!
أقول: مَن كتب مقالاً، ولم يتحمل ردود الفعل، ولم يوافق على سماع نصيحة محرر جريدة أو مجلة، أو رأي مغاير فيه، يبقى ذلك المقال يتيماً لا يكتب غيره، أو ما يكتبه لا قيمة له، فإذا خير الكاتب أو الباحث بين القدح والمدح، عليه قبول الأول، فهو إمَّا أن يصدر مِن محبٍ حريصٍ لا يُجامل، أو مِن حسود حقود، والاثنان يبذلان الجهد لإظهار الخلل، لكن ما لا نغفله أنّ مجال النّقد مليءٌ بالمُحَبطِين، وعلى وجه الخصوص في عالم الأدب، فعلى الكاتب أو المؤلف أن يكون صبوراً إيجابياً مع ما يسمعه مِن تشجيع وخذلان، فعليه أن يُصدق ما ذهب إليه الأقدمون، وقالوها مِن تجربة وخبرة «المتصفح أبصر بمواضع الخلل» مِن مؤلف الكتاب وكاتب المقال. فما يخرج مِن يد المؤلف لا يبقى ملكه، إنما للمتصفحين حقٌ في قول كلمة وإعطاء رأيٍّ.
لكن ذلك لا يعني كلّ مَن سود يده بالحبر كاتباً، إنما مَن كانت الكتابة عنده مأساة لا ملهاة، مِن أنماط مَن تقدم ذِكرهم، واعترفوا بنقصهم، ولو راجعوا الكتاب سبعين مرة، واعترفوا للقارئ المتصفح بفضله في كشف الخلل، وهم يعانون بالكتابة معاناة الفرزدق (تـ: 110هـ) بالشّعر، يُنقل أنه اعترف، وهو المعدود مِن متقدمي الفحول: «أنا عند النَّاس أشعر النَّاس، وربَّما مرت عليَّ ساعة، ونزع ضرس أهون عليّ مِن أنْ أقولَ بيتاً واحداً» (الجاحظ، البيان والتّبيين).