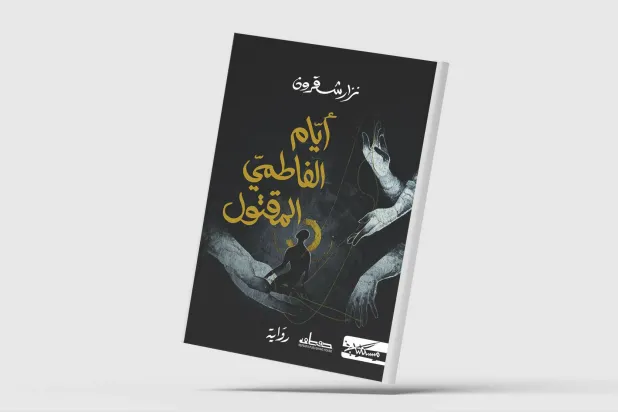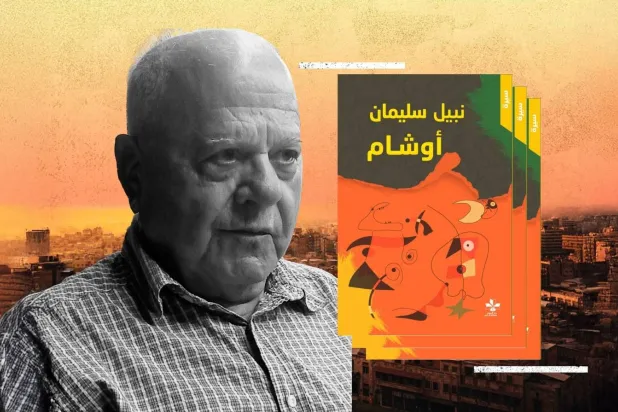يكرّس الكاتب الشهير ميلان كونديرا الفصل الأول من روايته التي تحمل عنوان «الجهل» للبحث عن جذور كلمة «الحنين للوطن» في مختلف لغات العالم. محاولاً أن يقف على أسرارها وبلاغتها وما تنطوي عليه من حكمة إنسانية. ويتوصل في النهاية إلى أن الحنين للوطن هو «الجهل» الذي اتخذه عنواناً لروايته عن المهاجرين.
يقول كونديرا: «يبدو الحنين كأنه مكابدة الجهل، أنا بعيد ولا أعرف كيف أصبح بلدي بعيداً ولا أعرف ما يحدث فيه». بمعنى أنه الجهل بما يحصل للأحبة والأهل والأصدقاء والعلاقات والأمكنة والأشياء في الوطن.
ولا يبدو أن المخرج والكاتب السوري فراس الراشد يبتعد كثيراً عن هذا المفهوم حينما قدم لنا لوحته، بالأسود والأبيض، عن الهجرة والجهل والانتظار في مسرحية «غياب مكتمل الحضور»، حيث يصرع الحنين للوطن، أو لنقل الجهل، بما حصل للحبيب المجهول، شخصيتي المسرحية وهما يمضيان العمر في المحطات.
يرجّح المرء وهو يشاهد مسرحية «غياب مكتمل الحضور» أن شخصيتي المسرحية، المرأة والرجل يعيشان غربة قاتلة خارج الوطن وينتظران حبيباً لن يلتحق بهما، لكنه من المرجح أيضاً، أنهما يعيشان الغربة ذاتها في الوطن بانتظار حبيب هاجر إلى الخارج بلا بوصلة وانقطعت أخباره.

تجري أحداث المسرحية في المحطات، حيث تبدأ حياة الشخصيتين تحت سقوفها وعلى أرصفتها، وتنتهي فيها أيضاً، بين صفير القطارات الرائحة والقادمة. ويظل السؤال معلقاً ما بين محطة وأخرى : لماذا لم يأت هذا الحبيب المجهول، ولماذا غاب كالشبح، وما الظروف التي أبقته في داخل (أو ربما خارج) الوطن. زيادة في الجهل (الحنين) وزيادة في التغريب لا تحمل الشخصيتان في المسرحية اسماً ولا يعرف المشاهد جنسيتيهما ولا اسم المحطة أو البلد الذي أتيا منه أو عاشا فيه، كأنهما في متاهة لا تنتهي.
يقدم لنا المخرج والكاتب المسرحي السوري فراس الراشد في مسرحيته لمحة من حياة السوريين في هجرتهم القسرية، إلا أنه يعرف عن وعي بأن ظروف الغربة متشابهة، وأن الانتظار هو سيد الموقف، ويحاول تبديد هذا الجهل المطبق، معالجاً موضوع الانتظار والغربة بطريقة لا فسحة فيها للأمل أو العودة. بل إن الهجرة، من وجهة نظره، كما يبدو، لا تكتفي بقتل الحنين والشوق وإنما تقتل الأمل والحب. وهو ما يختتم به المسرحية حينما يشتعل رأسا المرأة والرجل شيباً على كراسي المحطة ويكتشفان، بعد فوات الأوان، إنهما كانا ينتظران في الحقيقة بعضهما، وأن الحبيب المفترض ليس إلا «غودو» جديداً لن يظهر ولو كشبح. الشبح الذي أحبته المرأة حينما كانت شابة ولم يظهر في أي قطار.
لا يمكن تفسير قتامة الحالة في المسرحية إلا بالاعتراف بحقيقة أن البعض من المغتربين لم يأتلف مع المنفى أبداً، وغرق في أحزانه وإدمانه لها حتى الرمق الأخير. إنها «وحشة» و«صمت قبور»، بحسب حوار الشخصيتين. قطارات تأتي وترحل وهماً بانتظار الأمل، وبانتظار المجهول، وبانتظار القدر الذي حكم عليهما بحمل حقائب السفر.
لا مسرح بلا صراع وتناقض بين الشخصيات والظروف والبيئة المحيطة، لكن الصراع في هذه المسرحية يتمحور، لدي الشخصيتين، ضد عوامل الاغتراب والنفي. يقاتلان من أجل حياة أفضل في الخارج بعد أن أنهكما الوطن بحروبه الخارجية والداخلية، وقد كانا على انسجام فيما بينهما طوال فترة العرض المسرحي لولا زعيق القطارات الحزين.
يقول المخرج فراس الراشد متفكهاً: إن الصراع الحقيقي في العمل كان الصراع الجغرافي؛ لأنه كان عليهم التغلب على هذه المشكلة خلال أشهر من التمارين حتى يوم العرض. يعيش الراشد في مدينة هانوفر التي تبعد 350كم عن مدينة زولنغن، التي يعيش فيها الممثلان، وتم العرض الأول في مدينة كولون التي تبعد 40كم عن زولنغن. الأمر الذي يزيد من صعوبات العمل المسرحي في المنفى الذي مر به الراشد لأول مرة بعد هجرته. فالمسرح في المنفى، بحسب تصريحه، يعني العمل بلا جهة داعمة، وبخيارات قليلة من الممثلين، وبلا ورشات عمل وديكور. لكنه يؤكد أن لن يدع ذلك يحبط معنوياته، وسيسعى من أجل عمل جديد يتمنى أن يذلل فيها صعوبات العمل المسرحي في المنفى.
يستغرب المشاهد حينما يعرف أن الممثلين، لارا زنادري وأ ـ نور السيد يعتليان خشبة المسرح لأول مرة. ورغم ذلك كان أداؤهما جيداً يرتقي عن مستوى الهواة. من ثم، لا يمكن هنا إغفال حقيقة وجود موهبة كانت كامنة فيهما ولم تكتشف، لكنه يكشف أيضاً نجاح المخرج في صقل موهبتهما وتقديم عمل، صفق له الجمهور طويلاً، على مسرح بسيط وباستخدام إكسسوار وقطع ديكور بسيطة لا تتيح الكثير من الحركة.
رافق الفنان جمال البشعان العمل، الذي دام 50 دقيقة، بنغمات رقيقة من العود، كانت ترتفع وتنخفض مع إيقاع المشاهد وهدير القطارات.
عرضت المسرحية، برعاية الديوان الشرقي - الغربي، على مسرح «بيت كل العالم» في مدينة كولون على الراين في أيام كرنفال الراين الذي يستقطب مليون كرنفالي سنوياً. قبل العرض تمنى أحد إداريي «بيت كل العالم» للمسرحية أن تتحول غربة السوريين والعراقيين كرنفالاً ثانياً.
في الختام، قد يقتنع القارئ بالعلاقة بين الحنين للوطن والجهل التي يطرحها كونديرا في رواية «الجهل» بشكل مقنع، لكنه سيتساءل بخاصة حين يشاهد هذا العرض: هل سيتبدد الحنين للوطن إذا زال هذا «الجهل»؟