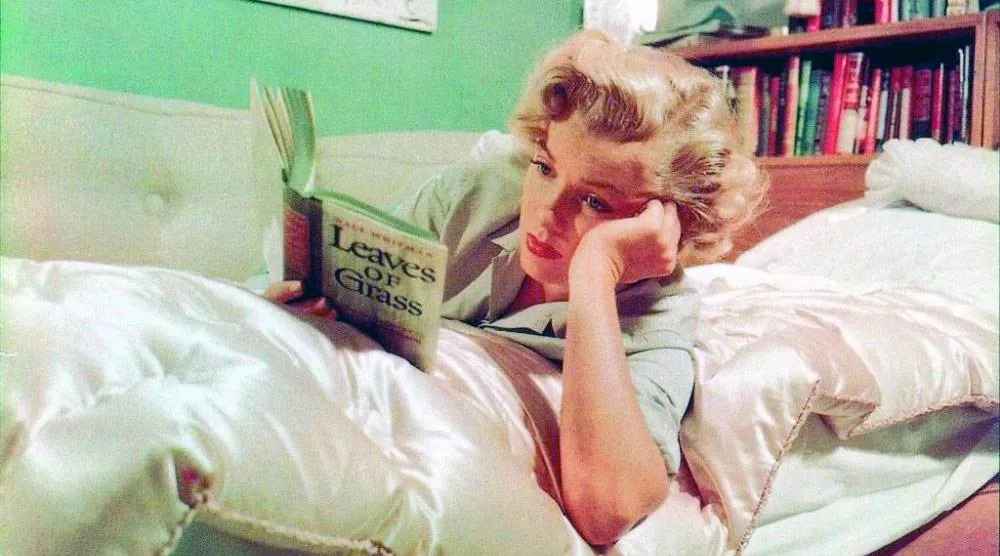مغامرة قصصية شيقة ومغوية، محفوفة بالمخاطر وبعناية معرفية ضافية، يطرحها الكاتب محمد رفيع في مجموعته «أساطير لم تحدث بعد». فنحن أمام نص قصصي يبدو وكأنه يدور في عالم افتراضي، حيث تعكس قصص المجموعة نفسها سردياً، على نظريات علمية لكوكبة من العلماء المعروفين، على مدار حقب زمنية مختلفة، وتبدو وكأنها هامش على متن، أو سرد على حكاية بنَت منطقها وفق قوانين العلم ورؤيته المحددة التي يشكل الواقع وعاءً لصيرورتها ومصداقيتها في الوقت نفسه. لذلك يظل القارئ يراوح ما بين الـ«مع» والـ«ضد»، في دائرة تعلو فيها نبرة الشك وعلامات الاستفهام، كما أن فعل الحكي يبدو همه الأساسي هو تفتيت نمطية الحكاية والتحرر من أطرها التقليدية. فالشيء هو نفسه ولا نفسه معاً، عارياً وهارباً من أي معنى يؤكد من خلاله حضوره أو غيابه.
يعي الكاتب ذلك ويقصده، بل إنه ينسج قماشته السردية وصراعات عالمه القصصي، ويدفعها دائماً لتبدو وكأنها الصوت الآخر المنسي، المسكوت عنه لما خلفته نظريات هؤلاء العلماء وقوانينهم في تفسير الكون وتقصي حركة الزمن في مفاصل الطبيعة واللغة والوجود كوعاء للعواطف والمشاعر الإنسانية، واصفاً العالم والحياة في إحدى القصص بأنها «العبث الأعظم»، وما دام العلماء لا يكفون عن اللعب داخل دوائر هذا العبث، فلِم لا يعبث هو الآخر، ويضع هذا العالم بحاضره وماضيه ومستقبله على طاولة تشريح أدبية، يحاول النص من خلالها، بقوة الأسطورة أن يصل هو الآخر إلى تفسير يخصه وحده، في تأويل هذا العالم وتفكيك أواصر الحياة وعلائقها المباشرة الملموسة، والقضية الكامنة فيما وراء النص وحركة الزمن واللغة والعناصر والأشياء.
ومن ثم، يبني الكاتب محمد رفيع عالمه القصصي على فكرة «استئناس الغرابة»، وما ينجم عنها من صراع مخاتل ما بين الخيال والواقع، من ناحية والعلم والأسطورة من ناحية أخرى. في غبار كل هذا تراوح شخصية (آدم) البطل المهيمن على مناخات قصص المجموعة الأربعة عشرة، ما بين الوهم والحقيقة، مسكوناً بوجود مادي واقعي، وممسوساً بمراياه التي تنداح في سراب الميتافيزيقا، يموت ويحترق لكنه ينهض من رماد موته في حياة أخرى، تجدد نفسها بالأسطورة، كأنه طائر الفينيق كما في الميثولوجيا الإغريقية.
اختناق مروري
يطالعنا هذا العالم منذ القصة الأولى في المجموعة «اختناق مروري نحو السماء»، حيث يوظف المؤلف أجواء جائحة «كورونا» المأساوية التي ضربت العالم منذ سنوات، ويتخذها ركيزة أساسية في تنمية الصراع درامياً، وخلق وشائج تبدو واقعية في التماهي ما بين الأسطورة والواقع، فمشهد الموتى المتلاحق من شتى أنحاء العالم واكتظاظهم المتصاعد في السماء، لم يخلق فقط اختناقاً مرورياً على الأرض، إنما في السماء أيضاً، حيث تصعد أراوحهم بالآلاف وتتلاحق، في إيقاع يصعب السيطرة عليه، وضع العلماء في اختبار مباغت ولاهث للوصول إلى مصل للوقاية والحماية من خطر هذا الوباء. في خضم هذا المشهد يطل الدكتور آدم، ويبدو مشغولاً بشفرة ما يمكن فكها، تتلخص في ذبذبات بكاء المواليد الجدد فهو بحسب النص «مؤمن بأن الأطفال الرضّع لهم لغة، ويريدون أن يقولوا لنا شيئاً».
طيلة خمس سنوات وهو يزور مستشفيات الولادة، ويسجل بكاء الوليد الجديد، ثم يعود إلى المنزل، ليحلل الأصوات ويحولها إلى رسم بياني، ويبحث في كتب الشفرات، ويملأ حوائط المكتب بصور الأطفال وبجوارها التحليل الصوتي لبكائها الأول. بيد أنه لم يستطع خلال هذه السنوات أن يتوصل أو يستند إلى نظرية حقيقية عن لغة مشتركة تفسر ذلك. فظل الأمر معلقاً ما بين الإمكانية والاحتمال، «فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يبكي بهذا الشكل حين يولد، أما باقي الحيوانات فلا وقت لديها، فالبرية لا تمنحها وقتاً كافياً».
نفس سردي رائق
تحافظ المجموعة علي توهجها وتدفع ما يهجس به إلى النمو والصعود في نفس سردي رائق، يبرز على نحو لافت في القصص الأولى، لكن هذا الصعود يخفت تدريجياً، ويختلط بتقريرية مباشرة مشوبة أحياناً بنظرة وعظية، بداية من صفحة «87» بخاصة في قصص (عيش وحلاوة - نرسيس الأعلى - نرسيس الجديد - موسيقى الفحيح - العنقاء تضرب من جديد - كيمياء الحب)، ففي هذه القصص، تتراجع إلى - حدٍ كبير - تلقائية الغرابة، وتصبح مجرد اصطناع لاصطياد دهشة ذابلة، تتحول إلى محض عبث بلعبة، كانت من قبل محببة وشيقة، ومحفزة للخيال، وجعل القارئ المتلقي يحس بأنه جزء منها، مشغوفاً بمتنها وهوامشها، وما ستؤول إليه حبكتها الدرامية، المفتوحة على نوافذ الحياة وأشواق الإنسان، بخاصة في الإمساك بخيوطها غير المرئية. حيث ينتقل الصراع من منطق القبول والمشاركة إلى منطق المتاهة والمباعدة. وهو ما يطالعنا على نحو لافت في قصة «نرسيس الأعلى»، التي يذيلها الكاتب بمقولة لنيتشة على لسان زرادشت تقول: «إنهم لا يفهمونني، لست الفمَ المناسب لهذه الآذان». وكأن المؤلف من دون أن يقصد يبرر من خلالها هذا الفتور والتراجع الذي اعترى هذه القصص.
تبرز المتاهة حين يقرر (آدم) البطل التلاعب بالنوع البشري، فالرجل وهو العالم الحاذق بعد أن تماهى مع شتى أساطير الأرض، من أوزوريس وإيزيس، حتى زرادشت قرر أن يبحث عن الحب والتماهي مع أسطورته الخالدة «روميو وجولييت»، فيلجأ إلى هذه التلاعب، مقرراً أن يحوِّل الكثير من الرجال إلى نساء والكثير من النساء إلى رجال، بل إنه أعاد المتحولين إلى نوعهم الأول حين طلبوا ذلك. يلجأ آدم - بحسب النص - إلى هذا التلاعب عن طريق الحقن المجهري للخلايا الجذعية والهرمونات وبعض الإشعاعات، ولم ينجُ هو نفسه من هذا التلاعب، فحول نفسه إلى أنثى، وأصبح هناك آدم الأول والثاني حتى العاشر، وكذلك حبيبته ليليت... وفي النهاية يجمعهما الموت، وتكتب فيروز سكرتيرته الوفية الغيورة المحبّة له على قبرهما «هنا يرقد آدم وليليت» تمسحاً بأسطورة العشق الخالدة «روميو وجولييت». يعلق الكاتب على كل هذا في نهاية قصة «العنقاء تضرب من جديد»، قائلاً في نبرة لا تخلو من التعالي: «عادت الأشباح تهمس من جديد، غير أنها هذه المرة تهمس في عقلك أنت. نعم أنت يا قارئ القصة: هل لو كنت أنت فيروز. هل تحمل ليليت في أحشائك؟ فكر. فكر. فبالله لم يكتبنا رفيع إلا لكي نفكر».
منطق الإنسان الكامل
يبقى من الأشياء المهمة في الفضاء السردي الشائك لهذه المجموعة أنه ثمة مواجهة صريحة تصل إلى نوع من التحدي ما بين منطق القصة القصيرة الذي يتوخى الدقة والوجازة والتكثيف، ومنطق العلم الذي يتوخى اليقين الصارم والحاسم. وكأننا أمام ميزان مشرّب بنوازع من أدب الخيال العلمي، في كفتيه يتسابق الخيال والواقع، ويتبادلان الأدوار والأقنعة؛ حول من يصل أو يشارف منطق الإنسان الكامل والمتكامل، الإنسان الأعلى، على غرار إنسان نيتشة «السوبرمان» الجامح الذي يمجد إرادة القوة، في صيرورة تبدو أعلى من منطق الوجود والعدم، تخترق الحياة وتكسر ترهلها الميتافيزيقي الضارب في المثالية الأفلاطونية، محققاً «العود الأبدي» الجذر الأساس في فلسفة نيتشة. حيث يرى أنه «ما دام كل موجود يتحرك داخل وعاء العالم، والعالم محكوم بحركة دائمة، فإن الإنسان نفسه منجرف في دورة لا نهائية».
هذه الدينامية النيتشوية التي تسعى لانتزاع الإنسان من تقوقعه وجموده ليلحق بعالم التحول والصيرورة، تنعكس بقوة في فضاء المجموعة، وتضمر نوعاً من التماهي الخفي بين شخصية آدم المركبة متعددة التناص، وشخصية زرادشت بخاصة في كتاب نيتشة الشهير «هكذا تحدث زرادشت»، الذي كشف فيه عن أبعاد هذه النظرية الفلسفية.
في الختام، نحن أمام بطل أحادي، يحركه المؤلف كما يشاء، وفق قوانين لعبة سردية برغم غرائبيتها، فإنها لعبة متفق عليها سلفاً وفق أطر وعلامات وإشارات محددة، لكنها مع ذلك قادرة على أن توحد الداخل بالخارج وفق نموها الدارمي الخاص، وفي رؤية تجعلك تختلف معها بحب.