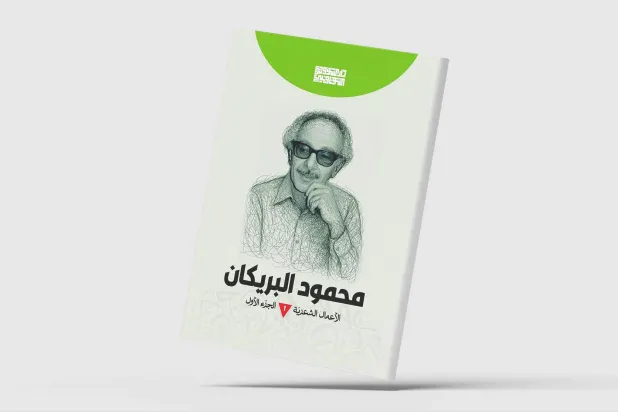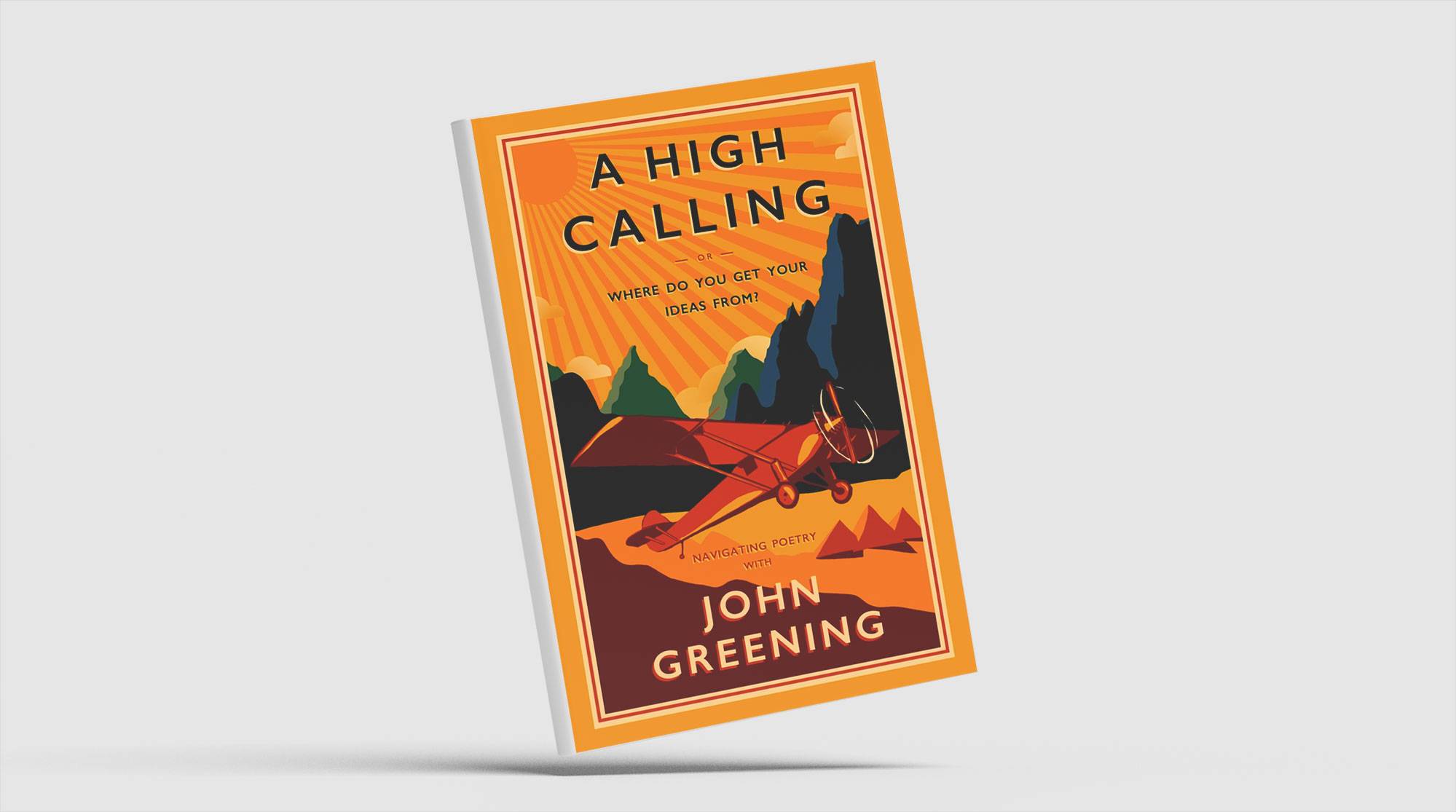على مدار مسيرته الشعرية، تحوَّل محمود درويش (1941- 2008) إلى أيقونة، إلى رمز ثقافي، وناطق شعري باسم الفلسطينيين، رغم العدد الكبير من الشعراء الذين أسهموا في تشكيل المشهد الشعري، على أرض فلسطين التاريخية أو في المنافي القريبة أو البعيدة. لقد تفرَّد درويش، وصار اسمه الشعري كناية عن فلسطين وقضيتها، رغم غنى التجربة الشعرية الفلسطينية، والتنوع والتعدد اللذين وسما هذه التجربة، حتى كثر الحديث عن حجب اسمه لعدد كبير من الأسماء الشعرية اللامعة في هذا المشهد الشعري المتعدد، الذي استهله شعراء فلسطينيون بارزون في ثلاثينيات القرن العشرين وأربعينياته، ونخصُّ بالذكر ابراهيم طوقان (1905- 1941) وأبو سلمى - عبد الكريم الكرمي (1909- 1980) اللذين دشَّنا التجربة الشعرية الفلسطينية المتطورة قبل حلول نكبة فلسطين عام 1948. ورغم أن البعض، من حاسدي درويش ، والغيارى من حضوره الشعري والإعلامي البارز والمستمر، يعيدون هذا الحضور إلى ارتباط اسمه بالفضية الفلسطينية، وقربه من قيادة منظمة التحرير، ومن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات شخصيًّا، إلا أن هذه الأصوات، التي ما زالت تبث في الإعلام، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، ما يسعى إلى تقويض مكانة درويش الشعرية، وتشويه صورته الإنسانية، وتلويث سمعته الأخلاقية، تضرب صفحًا عن حقيقة أساسية في تجربة هذا الشاعر العربي، والعالمي الكبير، وهي قدرته على التطور، والتحوُّل، وبناء عالم شعري يتصادى مع التجارب الشعرية الكبيرة في التراث، كما في الحاضر، وكذلك مع الشعريات العالمية، والمتعددة، الآتية من لغات مختلفة. إنه يبني من هذه التأثيرات، التي تسربَّت إلى تجربته، منذ أن نشر قصائده الأولى في فلسطين المحتلة، قبل خروجه منها، وعلى مدار مسيرته الشعرية، شعرًا مختلفًا، يمزج بين العمومي والشخصي، بين عذابات الفلسطينيين ورغبته في التعبير عن الوجود الإنساني، وهموم الشخص، والفرد فيه، في تجربة متفردة في الشعرية العربية المعاصرة.
لم يكن محمود درويش مجرد ناطق شعري باسم الفلسطينيين، أو صدى للحدث الفلسطيني اليومي، بل كان مهمومًا بتطوير تجربته الشعرية، وأخذها إلى مسارب جديدة، والتأمل في عذابات الكائن، فرحه وبؤسه، انتصاره وهزيمته، والبحث الشعري في تجربة الوجود البشري. ونحن نقع على هذا البحث، بصوره البدائية البسيطة، في قصائده الأولى، لكننا نشهد نضج هذا البحث في شعره الذي كتبه بعد خروجه من فلسطين، ووصول تجربته الشعرية إلى معانقة حقائق الوجود والحب والموت، والعدم والفناء، وتضافر الشخصي بالجماعي، والمحلي بالكوني، واليومي بالأسطوري، في مجموعاته "أحد عشر كوكبًا"، و"ورد أقل"، و"لماذا تركت الحصان وحيدًا"، و"سرير الغريبة"، و"جدارية"، وصولًا إلى مجموعته الأخيرة "لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي". ولعلَّ الواقعة المتكررة في أمسياته الشعرية، خلال السنوات العشرين الأخيرة من حياته، التي كان يعاند فيها جمهوره الذي يطالبه بقراءة قصيدته "سجل أنا عربي"، دلالة على رغبة الشاعر أن يغادر صورته النمطية التي حاول جمهوره المحبُّ سجنه في إطارها. كانت تلك القصيدة بنت زمانها، وأسيرة ظرفها الموضوعي، ورغبتها في مقارعة السجان، وإعلان الشاعر انتماءه لمحيط عربي واسع، وتجربة جماعية كبرى. وهي أيضًا نتاج تمارين كتابية أولى، ولم تعد صالحة للتعبير عن تطور تجربة درويش، وخبراته الثقافية، والوجودية، ورؤيته للعالم، في زمن شهدت فيه القضية الفلسطينية، كما التجربة الشخصية للشاعر، تعرجات، وانحناءات، وانكسارات، وآفاقًا مسدودة. ولقد أثبت درويش، في مجموعاته الشعرية التي نشرها بعد خروج الفلسطينيين من بيروت، قدرته على التعبير المركَّب عن تراجيديا الفلسطينيين، ورحيلهم الأبدي في عالم لم يعد يكترث بهم. في هذا الشعر الذي بدأنا نرى تباشيره الأولى في مجموعتيه "أحبك أو لا أحبك" (1972)، و"محاولة رقم 7" (1973)، نعثر على أعماق تجربة درويش، وقدرتها على التعبير عن الإنساني العميق، والكوني، في تجربة الفلسطينيين. ولعلَّ هذا ما يجعل تجربته متفردة في إطار المشهد الشعري الفلسطيني، وكذلك العربي، ويدفعها لتصطف إلى جانب شعريات عالمية عديدة، استطاعت أن تجتاز حدود اللغات والثقافات، لتصبَّ في نسيج الشعريَّات الكونيَّة، وتعبر عن تجارب الوجود الكبرى، متجاوزة محليَّتها، وسجنها اللغوي، لتصير تعبيرًا عن الإنسان، مطلق إنسان، ومأساة وجوده في هذا العالم.
لكن، إذا كان مستهجنَا النظر إلى شهرة درويش وانتشار شعره، وتحوله إلى رمز شعري لفلسطين، بوصفه نتاج الظرف السياسي، وقرب الشاعر من النخبة السياسية الفلسطينية العليا، فإن من المرفوض، من وجهة نظري، أن نفكَّ ارتباطه بالقضية الفلسطينية، والنظر إليه بوصفه شاعرًا متفردًا، هو نتاجُ اختباره للشكل الشعري، وإلحاقه بالشعريات العالمية، دون الاعتراف بأنه كتب في سياق أنساق شعرية طالعة من الشعرية العربية المعاصرة، ومن كونه فلسطينيًّا بالأساس يكتب عن عذابات شعبه المتواصلة مع عذابات الشعوب الأخرى في التاريخ وفي الحاضر. فالشاعر هو ابن زمانه، وثقافته ولغته، ونتاج المكان الذي طلع منه ونشأ فيه. ولو لم يكن درويش فلسطينيًّا، لقرأنا له شعرًا مختلفًا، وعاينَّا تجربة مغايرة لما كانت عليه تجربته.
كانت غاية درويش أن يكتب شعرًا يحكي عن الجرح الفلسطيني دون صخب؛ وكان حلمه أن يكتب شعرًا صافيًا لا ضجيج فيه ولا إيقاعات عالية. ويتمثَّل موقعه على خارطة الشعر العربي في قدرته على تزويج الإيقاع للمعاني والتجارب الوجودية العميقة، في تلقيح هذا الشعر بغبار طلع الكتابات الشعرية العالمية المميزة؛ بشعر فيدريكو غارسيا لوركا ووليم بتلر ييتس وبابلو نيرودا ويانيس ريتسوس، وغيرهم من الشعراء الكبار الذين تتألق قصائدهم في ذاكرة الشعر العالمي. ولأنه عرف كيف يطعِّم شعره بشعرهم، ويزوِّج التراجيديا الفلسطينية لتراجيديات البشرية وعذابات الإنسان في كل زمان ومكان، فقد أصبح، قبل وبعد رحيله، واحدًا من شعراء العالم الكبار.
ثمَّة في شعر محمود درويش علامات كبرى تدلُّ القارئ على تطور تجربته الشعرية، ونضوجه الثقافي والفكري والوجداني والسياسي، وعلى قدرته، كمبدع خلاق، على تحويل الفردي والشخصي، في حياته وحياة الفلسطينيين، إلى تجربة جماعية كبرى تضيء القضية الفلسطينية وتضعها في وجدان العرب المعاصرين، كما في ضمير العالم ووعيه. ففي رحلته من "سجِّل أنا عربي"، التي كانت صرخته للتعبير عن الهُويَّة الفلسطينية – العربية التي سعت الحركة الصهيونية والدولة العبرية إلى محوها، إلى قصائده التي كتبها في أيامه الأخيرة، نعثر على منحنى صاعدٍ، عمومًا، في هذه التجربة الشعرية الغنية التي أصبحت، سنةً بعد سنةً، دلالةً ساطعة على اسم فلسطين ومأساتها ومقاومتها، وتحولها إلى قضية إنسانية كبرى.
يبقى محمود درويش حاضرًا بقوة في المشهدين الشعري والعام، رغم مرور 15 سنة على غيابه. إنه حاضر من خلال ما أنجزه من كتابة شعرية، ورؤيةٍ للشعر ودوره منبثة في كتاباته النثرية، والحوارات التي أدلى بها. كما أنه حاضر في التأثير الشعري، على شعراء ينتمون إلى أجيال مختلفة، ومن ضمنهم جيله هو، ومن خلال الصخب الذي دار، وما زال يدور حول التأثيرات والمطابقات والتناصَّات التي ينطوي عليها شعره. كلُّ ذلك يجعل من درويش طاقة شعرية خلاقة تتجدد من خلال قوة تأثيرها، وعبر العودة إلى نصها الشعري على نحو دائم، كما يجعل منه عقبةً وتجاوزًا في آن، جدارًا يحجب التطور، ونافذة تطل على مستقبل يأتي؛ نهايةً وكذلك بداية.