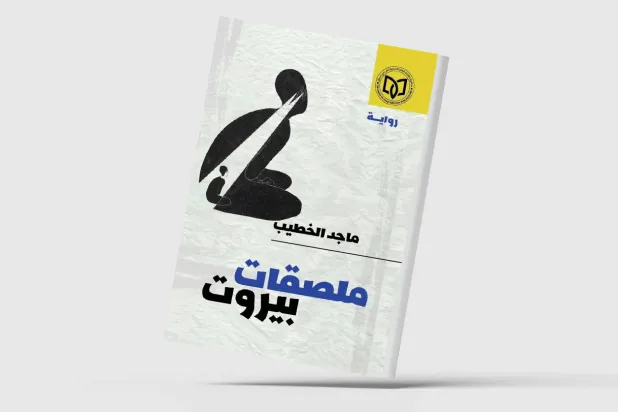استمتعت كثيراً هذا الصيف بقراءة سيرة رامبو التي كتبها الباحث جان جاك لوفرير. وهي أضخم سيرة ظهرت عن هذا الشاعر حتى الآن، إذ تجاوزت الألف ومائتي صفحة من القطع الكبير! ومنذ البداية يحق للمرء أن يتساءل: هل بقي شيء لم نكتشفه بعد عن رامبو؟ ألا تكفي مئات الكتب التي ظهرت عنه في مختلف اللغات من فرنسية وإنجليزية خصوصاً؟ ثم كيف يمكن لشاعر لم يمارس كتابة الشعر أكثر من أربع أو خمس سنوات على أكثر تقدير (بين السادسة عشرة والعشرين) أن يشغل العالم كله إلى مثل هذا الحد؟ كيف لشاعر يمكن حصر قصائده في ديوان صغير الحجم أن يبقى حاضراً بكل هذه القوة إلى يومنا هذا؟ ما هو سر هذا اللغز المحيّر؟ يقول المؤلف على صفحة الغلاف الأخير للكتاب: ولد آرثر رامبو في مدينة «شارلفيل» في شمال فرنسا عام 1854، ومات في مارسيليا عام 1891 عن عمر لا يتجاوز السابعة والثلاثين عاماً. وكل أعماله الشعرية تنحصر في مائة صفحة، على الأكثر. ولكن على الرغم من مرور أكثر من قرن على موته فإن قصائده لا تزال تمارس قدرة انفعالية هائلة على القراء، ولا تزال تحتفظ بحداثة حقيقية وكأنها كتبت البارحة. إن أعماله الشعرية تقع خارج كل أدب معروف وربما تعلو على كل أدب ممكن، كما قال الناقد فيليكس فينيون عام 1886 عن «الإشراقات». ولكن فيرلين يعتقد أن هذا الكلام ينطبق على كل أشعار رامبو وليس فقط على الإشراقات. إنه شعر يقع خارج كل شعر، شعر خالص يعلو على الشعر... انتهى كلام الناقد جان جاك لوفرير.
الشيء الطريف الذي نكتشفه في هذه السيرة الجديدة هو أن رسالة رامبو المشهورة باسم «رسالة الرائي» كانت قد بيعت مؤخراً للمكتبة الوطنية الفرنسية بمبلغ ثلاثة ملايين فرنك فرنسي!.. وهي لا تتجاوز الثلاث أو أربع صفحات. ومعلوم أنها أصبحت لاحقاً بمثابة النص المؤسس وشبه المقدس للحداثة الشعرية الفرنسية. في الواقع أنها مؤلفة من رسالتين متتاليتين، الأولى موجهة إلى أستاذه جورج إيزامبار، والثانية إلى صديقه بول دومني، ولكنهما تشكلان رسالة واحدة في نهاية المطاف. وفيها يدين الرثاثة الشعرية العتيقة والرومانطيقية الباهتة إن لم نقل المائعة ويقوم بأكبر انقلاب على الشعر الفرنسي. كما أنه يدشن الأدب الجديد ويرسم الخطوط العريضة لشعر المستقبل: أي لشعره هو بالذات. ولكن هل نعلم أن رامبو عندما أرسلها عام 1871 إلى صديقه لم يكن يمتلك ثمن الطابع البريدي لكي يضعه عليها فاضطر هذا الأخير إلى دفعه لكي يستطيع تسلمها؟ والآن تباع بثلاثة ملايين فرنك فرنسي! وهذا يذكرنا بقصة الرسام فان غوخ، الذي تباع لوحاته الآن بمئات الملايين من الدولارات في حين أنه كان يتضوَّر جوعاً عندما كان يرسمها!... مهما يكن من أمر فإن رامبو صفّى حساباته مع معظم الشعراء السابقين أو المعاصرين له في هذه الرسالة الشهيرة ودعا إلى انطلاقة جديدة في الكتابة الشعرية. بل إن هذه الرسالة تشكل قطيعة مطلقة مع الماضي. من هنا يمكن أن نفهم جملته الشهيرة: ينبغي أن نكون حديثين بشكل مطلق. ينبغي أن نقطع مع ماضي الشعر والنثر على حد سواء. ينبغي أن نجرب كتابة لم تُجرب من قبل قط. لم يعرف تاريخ الشعر ثورة راديكالية في مثل هذا الحجم والمستوى، ربما ما عدا لوتريامون، ذلك المجنون الآخر، أكاد أقول ذلك الوحش الآخر للشعر... بل إن رامبو طبق هذه الثورة الراديكالية الجنونية على نفسه عندما دعا صديقه إلى حرق - أو تمزيق - ديوانه الشعري الأول الذي كان مودعاً عنده! ولحسن الحظ فإنه لم يفعل. ولو أنه فعلها لكانت قد حصلت كارثة حقيقية، جريمة! لو أنها فعلها لكنا قد خسرنا بعضاً من أجمل قصائد الشعر الفرنسي في براءاته الأولى. آه من البراءات الأولى! آه من الطراوات الأولى!
لقد دخل الشاعر الهامشي «بول دومني» التاريخ فقط لأنه لم يمزق ديوان رامبو الأول: قصائده الغضة. شكراً له وألف شكر. لقد خلد نفسه في التاريخ لهذا السبب بالذات. كفاه فخراً أنه حافظ عليه أو قل رماه في أحد أدراجه العتيقة دون أن يعرف أهميته... ولكن عندما استشعر الأمر بعد سنوات طويلة وعرف أنه يمتلك كنز الكنوز في بيته راح يساوم عليه مادياً دور النشر لكي يفكّ ديونه... عندئذ كانت شهرة رامبو قد ابتدأت تنبثق وتصعد رويداً رويداً حتى طبقت الآفاق وقضت على كل شهرة أخرى... البعض يعتقد أن مانيفست الشعر الجديد، أي رسالة الرائي، لا ينطبق إلا على «الإشراقات» حيث تحلّل رامبو كلياً من قيود الأوزان والقوافي بل وحتى ما وراء الأوزان والقوافي... توصل إلى الشعر المطلق الذي لا شعر بعده. ولكن ماذا نفعل بـ«فصل في الجحيم»؟ وماذا نفعل بقصائد خارقة مثل «بوهيميتي»، أو «الحانة الخضراء»، أو «أحاسيس»، أو سواها؟ وهي من أوائل ما كتب. فـ«فصل في الجحيم» يمكن اعتباره كقصيدة نثرية أو كقصيدة تفعيلة في بعض الأحيان، أما القصائد الأولى، التي ذكرنا عناوين بعضها فكانت لا تزال تتبع الوزن والقافية تماماً. كانت مخلصة لعمود الشعر الفرنسي. لكن ما أجملها وما أطيبها! سوف أثبت إحداها في آخر هذا المقال. في الواقع أن رامبو، وكما تقول الناقدة سوزان برنار، كان يتحلّل في كل مرحلة من قيود جديدة حتى وصل أخيراً إلى شكل شعري حر تماماً من كل قيود. لقد خلع قيوده وأصفاده كلياً وتحول الشعر لديه إلى هواء منبث، إلى أثير... ولا ريب في أن «الإشراقات» تجسد هذا الشكل الشعري الذي سعى إليه رامبو واعياً أو غير واع منذ البداية. ولكنه لم يستطع أن يتوصل إليه إلا في خاتمة مساره الشعري. وهذا أمر طبيعي: فالانفلات من كل القيود ليس عملية سهلة، ولا يمكن أن يتمّ دفعة واحدة وإنما على مراحل. وشعراء الحداثة العربية ابتدأوا هم أيضاً بكتابة الشعر العمودي الموزون، ثم انتقلوا إلى قصيدة التفعيلة كحل وسط، قبل أن ينتهوا أخيراً إلى قصيدة النثر... وبالتالي فإن التطور الذي مرّ به رامبو يعتبر نموذجاً كلاسيكياً لكل ما حصل بعده.
يلاحظ المؤلف أن النظرية الشعرية الجديدة التي أتى بها رامبو لم تؤثر على شعراء جيله، بل ولم يسمعوا بها على الإطلاق! وهذا شيء لا يكاد يُصدَّق بالنسبة لنا نحن المعاصرين. ولكن أليس الرواد يجيئون دائماً قبل الأوان؟ من عرف أهمية نيتشه في وقته أو هولدرلين أو كافكا أو فان غوخ أو بعض المجانين الآخرين؟ لا أحد تقريباً. ولكن شعراء القرن العشرين راحوا يعدون «رسالة الرائي» بمثابة إنجيل الحداثة الشعرية الفرنسية بل والعالمية. راحوا يتمسكون بها حرفياً. نضرب على ذلك مثلاً: السرياليين.
فرامبو دعا، كما نعلم، إلى خلخلة جميع الحواس، وإلى الانخراط في كل التجارب الحياتية البوهيمية والهيجانية الجنونية قبل كتابة حرف واحد في الشعر. والسرياليون راحوا يطبقون نظريته حرفياً ويمارسون كل أنواع الشذوذ والجنون في شوارع باريس ومقاهيها، وأثاروا عليهم غضب الرأي العام والأخلاق التقليدية المحافظة. وكثيراً ما كسروا الكؤوس والأواني في مقاهي باريس من خلال معارك صاخبة مع بعضهم بعضاً أو مع آخرين. وهي معارك مفتعلة لا هدف لها إلا التخريب والتجريب وانتهاك كل القوانين الاجتماعية للبورجوازية الفرنسية المهذبة أكثر من اللزوم. بل ووصل بهم الأمر إلى حد الدخول على الكاتب الشهير «أناتول فرانس» وهو ميت مسجى في كفنه فصفعوه كفاً أو كفين على كلتا وجنتيه ثم خرجوا أمام ذهول الحاضرين وعدم تصديقهم لما يرون... من يستطع أن يفعل ذلك غير السرياليين؟ ولكن هناك بالطبع جوانب أخرى لهذه الثورة السريالية العظيمة التي حررت الوعي الباطني من كل القيود الدينية القمعية والعادات الاجتماعية الخانقة وجعلته ينفجر انفجاراً. ثم توصلنا أخيراً إلى الكتابة الأوتوماتيكية، أي إلى الحرية الانفلاشية الحرة التي لا حرية بعدها.
رسالة رامبو المشهورة باسم «رسالة الرائي»، التي لا تتجاوز أربع صفحات، بيعت مؤخراً للمكتبة الوطنية الفرنسية بثلاثة ملايين فرنك فرنسي
أحاسيس
في الأمسيات الزرقاء للصيف، سوف أنخرط في الدروب الضيقة،
موخوزاً بسنابل القمح، سوف أدعس الأعشاب الصغيرة:
حالماً، سوف أشعر بطراوتها على قدمي.
وسأترك الريح تبلل شعري العاري.
...
لن أنبس بكلمة، لن أفكر بشيء:
ولكن الحب اللانهائي سوف يصعد في أعماق روحي
وسوف أذهب بعيداً، بعيداً جداً، كبوهيمي،
متغلغلاً في أحشاء الطبيعة، كما لو أني مع امرأة.