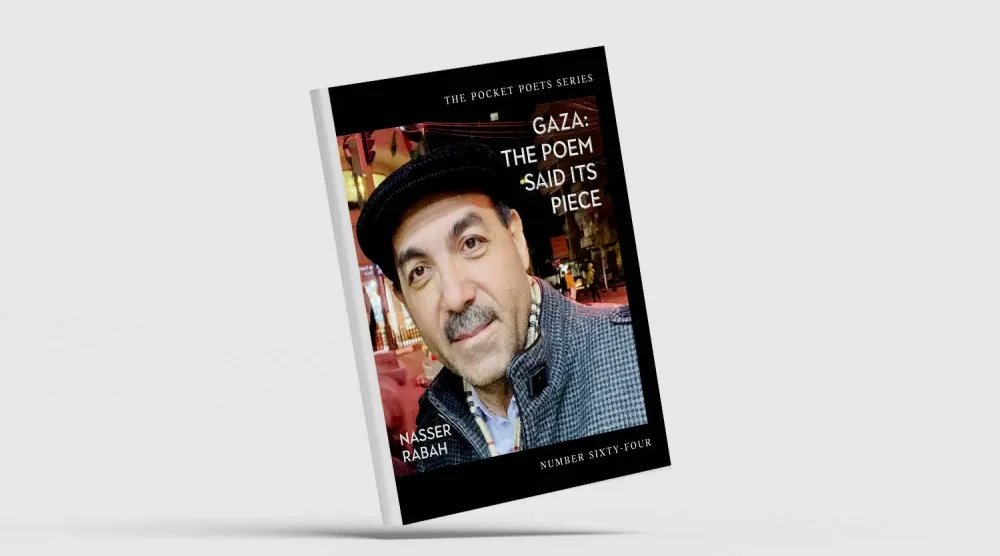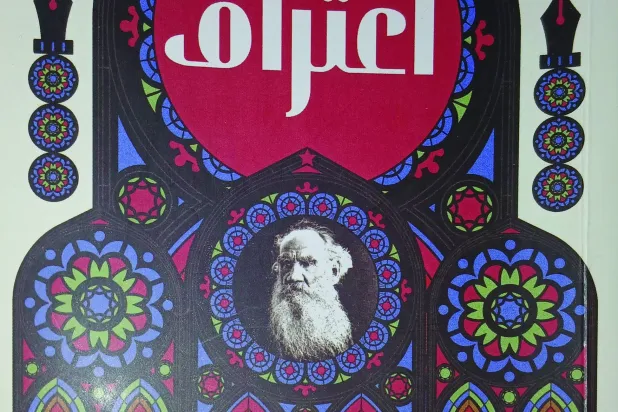رحل الكاتب والناقد المسرحي العراقي عدنان منشد في منفاه الاختياري، في مدينة سامسونغ التركية في 29 يوليو (تموز) 2022، بشكل مفاجئ. وبالرغم من أن منشد قد عُرف بكتابة القصة القصيرة منذ بداية سبعينات القرن الماضي، بالإضافة إلى النقد والتأليف المسرحي، إلا أنه ترك رواية مخطوطة ضمن أوراقه ، حررها ودفعها للنشر صديقه الروائي جهاد مجيد، ومن المقرر أن تصدر قريباً عن اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين. يقول مجيد عن الرواية:
«ترك الأديب الراحل عدنان منشد مسودة هذه الرواية بخط اليد، مما اقتضى بذل الجهد المطلوب لتوضيح كثير من مفرداتها غير الواضحة في النص المخطوط. أو استبدال ما تعذرت قراءته بما يناسب محله.
لم يعطِ الراحل الرواية عنواناً، فعنونتُها بـ(الدولفين) مستلاً إياه من أول عبارة في النص؛ لكن السبب الأقوى لهذا الاختيار انطباقه الكبير مع رؤية المتن الروائي.
لم أشأ تقديم الرواية بتمهيد أو مقدمة؛ إذ أرى في ذلك تطفلاً على التلقي الحر للنص الإبداعي الذي ينبغي أن يترك لمتلقيه».
هنا مقتطفات وافية من الفصل الأول:
يخلعون علي لقب الدولفين. ولم لا؟ طالما أن الحياة تصعد بك من سافل إلى أعلى ثم تنزلك إلى أسفل سافلين. ولهذا أصبحت دولفيناً في فترة ما من حياتي الغريبة المتناقضة؛ لكنني الآن متورط في قضية يصعب النطق بها، قضية لا نجاة فيها ولا يليق الحديث عنها؛ قضية حدثت بسرية تامة، وأحسب أن المشاركين فيها سيدلون بشهاداتهم معي.
داود محمد أمين البروفسور، أو داود الطبيب، وداود النحس على ما يدعونني به الناس في محنتي واغترابي. فأنا أستاذ بيولوجيا أردت أن أكتشف الحياة وأسرارها وطبيعة تركيبها. درست في جامعات بنسلفانيا وكولومبيا، قمت بالتدريس في جامعة بغداد، فتمكنت من صنع خلية جرثومية تذيب الأجسام الحية والميتة من كائنات الأرض، ثم انتقلت إلى العمل في مختبرات الطاقة الوطنية قرب معسكر التاجي. العرض كان مغرياً جداً، ولكن خطواتي فيه كانت خطأ فادحاً.
لم يكن أحد الأيام من شهر نيسان عام 1977 يوماً عادياً بالنسبة إليَّ، حينما قادني البروفسور أحمد فاضل كريدي الفيزيائي إلى أطراف مدينة سلمان باك في جنوب بغداد. هناك شاهدت توربينات لاصفة البياض، من صنع فرنسي هي أشبه بمفاعلات (كيرن) على الحدود السويسرية الألمانية، أيام كنت أعد أطروحتي البيولوجية في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأميركية.
كانت التوربينات مقامة على أرض صحراوية بلقع، وثمة سياج كونكريتي مستطيل تنهض فيه أربعة أبراج مراقبة، لا يمكن البتة مشاهدتها إلا من خلال الناظور الملون في حدود الأميال البعيدة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.
في البداية صعدنا برج المراقبة الشمالي الذي يشرف على القاعدة، وبشكل هادئ وصموت كالنجوم. قال الصديق المرافق لصديقي كريدي الذي كان يعرف المشهد بدعابة: إنه مستغرب هذا الإسراف. فتراءت في مخيلتي وقتذاك طاولة العالم اللاتيني (أتوهان) المتواضعة -وهي الطاولة التي حظيت بأول انشطار عليها في العالم- والتي سبق أن رأيتها في مكان ما مع إعلان لافت لمشروب الكوكاكولا. لعل هذه الطاولة يمكن أن تكون بنفس اتساع وضجيج طاولة (فاوست) فهي محض بطاريات ولمبات وبانيو غسيل، إضافة إلى حلقة من شمع البرافين، وفيها قد يندلع ويتحقق هذا الهول.
في وسط قاعة بلورية، اجتمع عدد من أصحاب التقنيات الكونية حول طاولة حافلة بالمياه المعدنية والمنافض الكريستالية، وأزهار القرنفل. كان أحدهم يدخن غليوناً. طلبوا منا نزع ساعاتنا ومحابسنا لأن الحقول المغناطيسية واسعة جداً. وفي وسط القاعة كان ثمة سلم لولبي عملاق من الصعب أن يصفه المرء، فهو أشبه بسلالم أوروك الآجرية المستطيلة، ولا يوجد بالإمكان شبيه له.
صعدنا السلم بحذر وأنفاس متقطعة، وحين شارفنا ذروته وجدنا أنفسنا على جسر متقطع التكوينات والأوصال، بما يشبه مخلب قط، كأنه صراط الدينونة، الصراط المستقيم الذي لا يستطيع فيه عبد من عبيد الله إلا يميل به مرة وينتصب أخرى، أحسست بحركة المفاتيح في جيبي تطقطق وترن، ثم في هنيهات انطلقت قداحة معدنية وبعدها مقرضة أظافر باتجاه الماكنة العملاقة، والتصقت بها.
انفجارات ملونة بسيطة وشرارات إلكترونية زرقاء تندلق وتخفت، كتنفس رئة مثقوبة، من خلال شاشات متلفزة وامضة رأينا كيف تطلق النوى الذرية باستمرار من حجرة اليورانيوم المرمد، تندفع بأربعين قوة دفع، مستمرة ومتصاعدة، تقطع مسافات كونية تقارب المسافة بين الأرض والمريخ، قريبة من السرعة الظاهراتية المحسوبة لسرعة الصوت.
عشرات الكاميرات تومض بتصوير كل شرارة انبعثت صوراً وتخطيطات غرافيكية، كل صورة من هذه الصور تقاس فراغياً وبطريقة آلية ينتظم كل شيء... مئات الآلاف من الصور لأجل تجربة نووية واحدة فقط، وفي كل نصف ساعة يكافح التقانيون بكل ما عرفوا من مسلكية المهنة والصبر، من أجل حصاد الأفلام في الكاميرات.
وعرفنا في غمرة هذه الجولة أن كل كاميرا تستهلك فيلماً قياس 500 ملم، أو شريطاً أسود من البللود بطول 600م.
في نهاية الجولة، رأينا أصحاب التقانة ما زالوا جالسين في القاعة البلورية ذاتها، قرب حجرة الوقود المرمد، يسجلون ملاحظاتهم بوقار علمي رصين. وكانوا بين الحين والآخر يملكون بعض الوقت لقراءة الصحف والمجلات المصورة. وفي الغالب يجرون اتصالات هاتفية ذات طابع ميداني مستمر مع دائرة (الكونترول) النابضة بالمركزية والشمول، حتى وإن ابتعدوا لدقائق محسوبة إثر هاتف خارجي، أو لحظة هاربة من الزمن مع سكرتيراتهم ذوات الغنج الشرقي الملتاع بفعل لهيب الصحراء، ولكنهم يتفرقون في النهاية وهم منفرجو الأسارير والشفاه، كأنهم أصلحوا أعطال الكون، أو أصلحوا الخلل الفيزياوي في مكان ما من هذه القاعدة، أو اكتشفوا أنه لم يعد هناك عطل على الإطلاق؛ بل خطأ في لمبة المراقبة، أو إنذار صوتي أطلق سهواً.
في كل الأحوال، لا يمكننا الجزم في هذه الأمور بآلية ستاتيكية عقلية لما يمكن أن يحدث خلال الحاجز الزجاجي البراق الذي يفصلها بعيداً عن هذه القاعدة. وحتى لمبات النيون الصغيرة المطفأة والمشتعلة بين حين وآخر كانت تناشدنا في عزم عقلية من جنس آخر ملغز، قريب وليس بمستبعد عن الطوطمية الآلية الجديدة في الربع الرابع من القرن العشرين.
لست واثقاً أن مشاهداتي لهذه القاعدة في زمن مضى وانقضى قد نجحت في استدراجي للعمل فيها؛ إذ يعتبر عدد الاختصاصيين شبه قليل، عدا ذلك ثمة 90 في المائة من التجارب والأبحاث التي تنفذ في مفاعلها يجري ترتيبها لصالح جامعات ومعاهد فرنسية وسويسرية وألمانية. ولطالما قرأت الأبحاث المفصلة الخاصة بمنشآته العلمية البليغة، وصوره الإبداعية التي تتوالى إليَّ من أميركا وأوروبا حول أهميته وحساسيته العلمية، وإحاطته بأسرار اللغة النووية التي كتب بها.