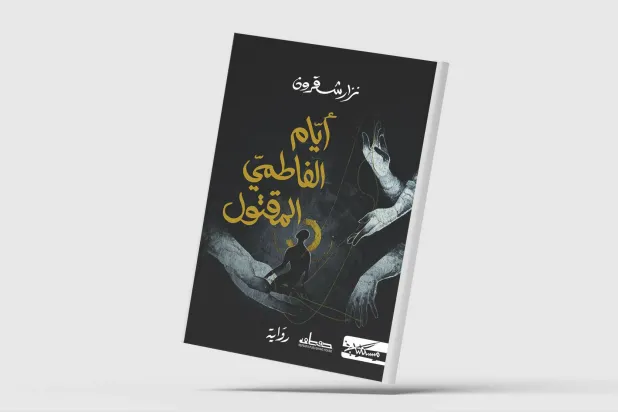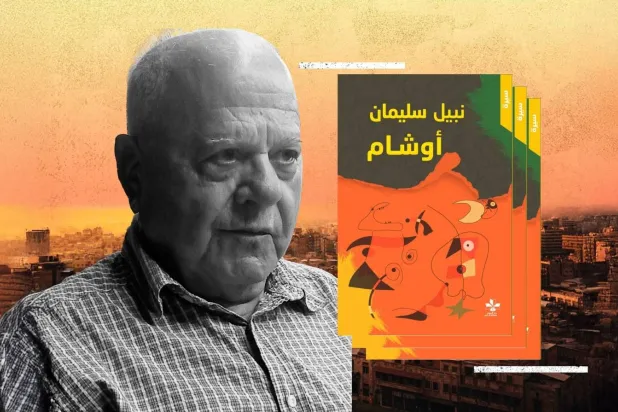وسط ضجيج الاقتتال والتطاحن السياسي الذي لم يتوقف منذ عام 2011 وحتى الوقت الحالي. وبينما اعتاد الليبيون سماع دوي الرصاص والقذائف كان بعض الكتّاب منكبين على أوراقهم، لإنجاز رواية أو قصة أو نصٍ شعري، لا تخلو أجواؤه من مناخات الحرب في بلدهم المنقسم.
تكررت حكايات الحرب في قصص وروايات ودواوين شعرية عدة، منها ما يُظهر صورة الواقع الماثل، مثل الرواية الصادرة مطلع العام الحالي، للكاتب الليبي محمد علي الشويهدي، بعنوان: «ربيع وطن» (منشورات دار الجابر، 2023)، و«ديوان الحرب... حتى لا تشعر البيوت المهدمة بالوحدة»، للشاعرة سميرة البوزيدي (منشورات موقع بلد الطيوب، طبعة رقمية، 2021)، وغير ذلك من الأعمال التي نشرها أكثر من أديب ليبي، منهم عزة كامل المقهور، وكوثر الجهمي، ورامز النويصري... وآخرون.
لكن السؤال الأهم خصوصاً مع تباين الرؤى حول تأثير عامل الزمن في تناول الحرب روائياً: هل ثمة ضوء في نهاية النفق؟ وهل يمكن لأدب الحرب أن يقود لمصالحة وطنية؟

من فوق مقعد صغير بأحد فنادق نيل القاهرة، لا يُخفي الأديب الليبي محمد علي الشويهدي الذي شغل منصب أمين (وزير) الثقافة في بلاده بين عامي 1979 و1980، حزنه لما صارت إليه الأمور في ليبيا. وهو ما رثاه في روايته «بتحول البلاد إلى شرق ستان، وغرب ستان، وجنوب ستان»، معرباً عن اعتقاده أن موطنه «ماضٍ نحو المجهول».
وبنبرة لا تخلو من غصة الألم والمرارة، تستعيد الكاتبة عزة كامل المقهور مجموعتيها القصصيتين؛ «فشلوم - قصص الثورة» - فشلوم حي شعبي في طرابلس شهد اشتعال فتيل الثورة - و«بلاد الكوميكون»، عن الحرب.
تقول الكاتبة الليبية: «تبدو لي كلتا المجموعتين بعيدتين عن قلبي وعن عقلي الآن، لا رغبة لي في تذكر هاتين الحقبتين. نريد نحن الليبيين أن ننعم بالسلم، وأن نتفرغ للبناء. أحمد الله أنني نشرتهما في زمانهما، وإلا لكنت ترددت في ذلك».
وتضيف: «الأحداث الجسام كالاعتقال، أو الموت، أو العنف، أو الحرب، أو الكوارث، إن لم تُكتب وتنشر في حينها، أو في زمانها على الأقل، سرعان ما تفتر، أو يطويها الزمن، أو تتغير ملامحها؛ فالسلم هو الحالة العادية المستقرة التي تمنحنا براحاً زمنياً للكتابة، أما الحالات الاستثنائية كالحرب، فتستدعي كتابة في وقتها، بحرارة الألم وغصة اليأس أحياناً، وإلا فإنني أرى من الصعب الكتابة عنها بعد انقضائها».

وترى عزة المقهور، وهي ابنة الأديب الليبي الراحل كامل حسن المقهور، أن أدب الحرب وسيلة من وسائل المصالحة الوطنية «فهو أدب يعكس واقعاً مريراً وبائساً سيؤثر حتماً في ما بعد الحرب، وحالة ما بعد الحرب هي حالة الهدنة أو السلم. والقصص القصيرة التي تشي بما حدث، ستذكر الأجيال القادمة بالأحداث وتخلق مجتمعات نابهة».
لم تكن الحرب في ليبيا حرباً واحدة اندلعت عام 2011 وما تلاه، بل عرفت البلاد أكثر من حرب، كما يخبرنا الشاعر والناقد رامز النويصري، الذي يقول إن «هذه الحروب أثرت بشكل مباشر على الإنتاج الأدبي في ليبيا، على مستوى الإبداع والنشر على حد سواء؛ حيث نجد الحضور الواضح للحرب وآثارها في النصوص الإبداعية، في مختلف الأجناس الأدبية. وفي المقابل تأثرت حركة النشر فلا يمكن الترويج للكتاب في وجود حرب تقترب من كل بيت».
ويرى النويصري أن الشعر والقصة القصيرة عكسا آثار الحرب ووقائعها بشكل مباشر، إذ بوصفهما جنسين إبداعيين، «يعتمدان الرصد الآني، أو التأريخ للحظة. بالتالي ثمة الكثير من النصوص الشعرية والقصصية التي رصدت وقائع ما عاشه المجتمع من حروب. أما الرواية، فربما تتأخر قليلاً، كونها تحتاج إلى مراجعة ثقافية قبل أن تكون نصاً إبداعياً، خصوصاً في حال كانت الرواية محاولة للتوثيق». وعن تجربته الشخصية، يقول إنه نشر أكثر من نص شعري، وقصة قصيرة، تقوم مادتها على الحرب، التي رغم قسوتها، «فإنها مادة إبداعية دسمة وغنية بالتجارب، التي يمكن للمبدع، من خلالها، أن يقدم نصوصاً إبداعية غنية».
وبدورها، ترى الروائية الليبية كوثر الجهمي أن تأثير الحروب المتتالية منذ 2011 واضح في الأدب الجديد، أو في بعضه، إذ إن هناك أصواتاً شابة «تميل إلى الفانتازيا، مبتعدة تماماً عن خصوصية مجتمعها، فيما تظهر بين الحين والآخر أصوات أخرى مهمومة بما يجري، ترصد وتتسامح، وتتعايش، وتحاول عكس ما يجري فنياً».

ليست آثار الحرب سيئة كلها، هذا ما تعتقده الجهمي: «رغم أن الحرب بشعة، ولا ينبغي لي أن أذكر لها وجهاً آخر، فلا يمكنني إنكار حقيقة أن الحرب منحتْ كثيراً من الكتاب نضجاً مبكّراً، وهذا شيء جيّد تمخضت عنه المحنة».
وحول آثار الحرب على حركة النشر، تقول الروائية الشابة إن الكاتب الليبي «متحرر إلى حد ما، نتيجة الفوضى، من مراقبة ما يكتب من الجهات المختصة، ولكنه في المقابل يواجه أكثر المراقبين تعنّتاً وقسوة: المجتمع الذي تُسيّره منشورات السوشيال ميديا، وتوجهه كيفما شاءت، وإنّ سطراً واحداً مأخوذاً من سياقه، لكفيل بالحكم على كاتب ما بالنفي. الحرب لم توقف عملية النشر، ولكنها صنعتْ جواً مشحوناً بالقهر، يبحث عما يفرغ فيه قهره، ولحم الكتّاب أكثر اللحوم طراوة للنهش، وأسهلها في الهضم».
ورداً على سؤال حول مدى مواكبة الكتابات الأدبية للحرب، تقول إن الأديب الليبي يشعر على الدوام بأن «عليه أن يبرر، وأن يدافع عن قلمه، فيلجأ في العموم إلى استخدام لغة التلميح والمواربة واللف والدوران، خصوصاً في ما يتعلق بالقصة والرواية، أما الشعر فهو المواكب، ربما لأن الشعر يتفجر، ولا يأتي بتأنٍّ كما تفعل القصة، والشعراء الليبيون الذين عاصروا الحروب الأخيرة تمتلئ صفحاتهم ودواوينهم (على قلتها) بالأنين، وفيها الكثير من العزاء».
نشرت الجهمي رواية بعنوان «عايدون»، في عام 2014، رصدت فيها ما أسفرت عنه إحدى الحروب التي شهدتها العاصمة طرابلس، ونالت عنها جائزة «مي غصوب للرواية»، من دار الساقي (2019). وقد كتب بين سنتي (2019 – 2020)، روايتها «العقيد» (دار الفرجاني، 2022)، التي تقول عنها إن «الحرب فيها مختلفة عن تلك التي كنا نمر بها... وقد كتبت معظم الفصول حين كنت نازحة من بيتي ومقيمة في منطقة أخرى تقع أيضاً على خط النار، وكنا مهددين بنزوح آخر من مأوانا الجديد».
وترى الكاتبة الليبية أن «الحرب هي هي، وإن اختلفت مسمياتها وتواريخها. وأظن أن الأمر يختلف بين كاتب وآخر، البعض ينتظر أن تختمر التجربة، وتنضج رؤيته حيالها، والبعض الآخر يشعر بحتمية الكتابة الحية، ربما أنتمي إلى هؤلاء، فالكتابة بالنسبة لي ضرورة في كثير من الأحيان تحول بيني وبين فقدان عقلي».
وعن آثار الحرب على الكتابة تقول إن الحرب «تمنح القلم نضجاً مبكراً، وأعتقد أنه لولاها لما تفجر قلمي، ولبقيت أتمرغ في مسؤولياتي أُمّاً، وزوجة، ومعلمة، دون حاجة ملحّة للكتابة الجادة...الحرب تضعنا في مواجهة حقيقة أنفسنا، هي تعرّينا وتكشف عن خدعة التعاطف الإنساني، وهي بهذا تقدم للعقل المتفكر مفارقات يصعب بلعها، غير أن هذه المفارقات تحديداً هي ما يغذي الأدب ويثريه، وأعتقد أن النصوص الأدبية التي تناولت الحرب، أو السجن، والاعتقال هي أكثر الأعمال الأدبية تهييجاً للوجدان، وأدومها عمراً في تاريخ الأدب».
وبالمثل، يرى الناشر الليبي علي بن جابر أن تأثير الحرب على الإنتاج الأدبي يتضح في كثير من الأعمال، خصوصاً الرواية «بوصفها أكثر الأجناس الأدبية استيعاباً من ناحية سرد الأحداث، والانطباعات، والتأثيرات التي تتركها الحرب على الناس. الكثير من الأعمال تناولت تأثير أحداث عام 2011، وما بعدها على الإنسان الليبي، وعلى النسيج الاجتماعي الوطني».

وحول رؤيته للعلاقة بين الإنتاج الأدبي والحرب، يرى بن جابر أن مواكبة المبدعين للحرب، وإن كانت تعتمد في أغلبها على الموقف الشخصي للكاتب من الحرب ومسبباتها، فإنها «لا تزال دون المستوى المطلوب من حيث الكم والانتشار، ولعل ذلك راجع إلى وجود الكثير من الكتّاب الذين لم يخرجوا بعد من الانطواء، والانكفاء الذي سببته الحرب، وأيضاً تأثير انعدام الأمن والحرية في عدد كبير من المناطق الليبية، ما يجعل الكاتب متخوفاً من التعبير بحرية، حفاظاً على حياته، وعلى أسرته».