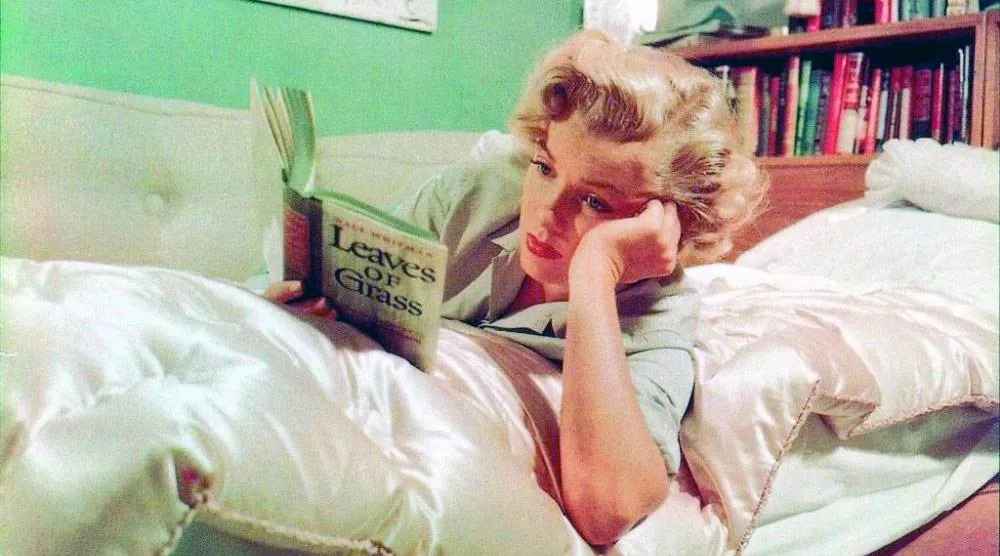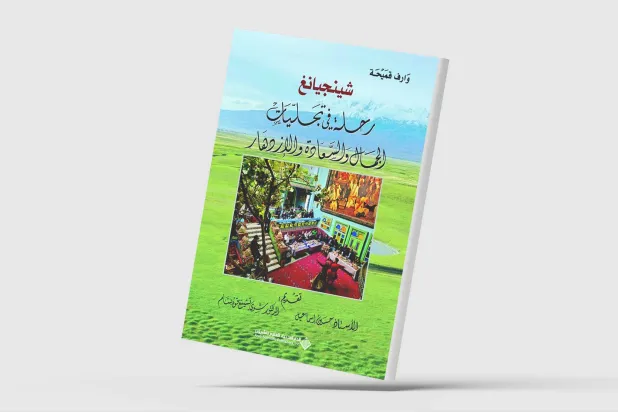عن دار «الكرمة» بالقاهرة، صدرت مذكرات «وأجمل الذكريات ستأتي حتماً» للناشطة النسوية نولة درويش التي نشأت بمنتصف القرن الماضي في أسرة يهودية مصرية لأب وأم اعتنقا الإسلام، وتأثرت بوالدها المحامي الكبير يوسف درويش في انحيازه لقضايا العمال والفقراء، وسارت على دربٍ مشابه مع احتفاظها بشخصيتها المستقلة وقناعاتها النابعة منها. شاركت في العمل السياسي العام وتنقلت في شبابها بين أكثر من دولة حتى استقر بها المقام في العمل ضمن منظمات المجتمع المدني بمصر والدفاع عن قضايا النساء العربيات، وشاركت في تأسيس منظمة «المرأة الجديدة».
في البداية، تشير المؤلفة إلى أنها وُلدت في يونيو (حزيران) 1949 وكان والدها معتقلاً بتهمة انتمائه إلى تنظيم شيوعي، فأرسلت والدتها إليه برقية تلغرافية «تبلغه بمولد ابنته»، والغريب أن والدها كان مقتنعاً تماماً في أثناء فترة حمل أمها أن الطفل القادم سيكون ابنة، فهو له ابن من زواج سابق والآن جاء دور البنت. اقترح الأب لهذه الابنة اسم «ربوة»، لكن الأم استغربته فنحتت من ظلال بعض الأسماء مثل منال ونوال اسم «نولة» لترضي رغبة الأب.
سؤال الهوية
تذكر المؤلفة أنها وُلدت لأم وأب اختارا الانحياز إلى الشعب المصري، فكان أبوها منذ عودته من دراسته الجامعية في فرنسا من المدافعين عن حقوق الطبقة العاملة، وعمل على التواصل مع قياداتها؛ حتى يستطيع تقديم دعمه كاملاً وبطريقة فعالة، وكانت والدتها متضامنة معه في هذا المسعى فقررا اعتناق الإسلام قبل زواجهما بفترة وجيزة في عام 1947، ورغم أنهما لم يكونا شديدي التدين فإنهما اقتنعا بأن هذا الأمر سيقرّب إمكانيات التعامل بطريقة سلسة في ظل التوجس العام المتنامي تجاه اليهود بفعل الدعايات السائدة في تلك الفترة من تاريخ مصر. وتشير إلى أن الانتماءات الدينية لم تكن مطروحة على هذا النوع بقوة، لا سيما في اختيار نوعية التعليم ويُترك لكل أسرة اختيار الأسلوب الذي تراه مناسباً لتعليم أطفالها القيم الأخلاقية والمفاهيم التي يتضمنها دينهم، سواء كانت تتم هذه التربية الدينية في إطار الأسرة أو في دور العبادة لكل دين.
لم تتعرف نولة درويش شخصياً على جدها موسى درويش؛ لأنه توفي قبل أن تولد بفترة طويلة في عام 1940، لكنها سمعت أنه كان إنساناً شديد الطيبة، يرتدي الجلباب وفوقه الجبة والقفطان والطربوش على طريقة «أولاد البلد»، ويمتلك محال عدة في «حي الصاغة»؛ لأنه إلى جانب انخراطه في تجارة الذهب، كان «جواهرجياً» يصنع بيديه ما يعرضه للبيع. وظل أمياً لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا يتحدث غير العربية حتى وفاته. أما جدتها راشيل كوهين فكانت تتطلع إلى أن تبدو كامرأة إفرنجية وهي تنتمي إلى أسرة من المثقفين نوعاً ما، بها المحامي الذي ربما أثر على الاختيار المهني ليوسف درويش.
حكى لها أبوها أنه عندما كان يدرس القانون والتجارة في فرنسا وقع في غرام فتاة فرنسية من أسرة أرستقراطية وهي التي عرفته على الفكر الماركسي، فلما عاد في إحدى الإجازات إلى مصر تحدث عنها لوالده، وقال إنه يريد الارتباط بها. رحب الأب بالفكرة بكل انفتاح بينما رفضت والدته بشدة أن يرتبط بهذه المرأة لأنها أجنبية و«غريبة عن ديننا وملتنا» كما قالت. وعموماً، لم يفلح أمر مشروع الارتباط هذا لأسباب لم يفسرها لها والدها الذي ظل دائم الحرص على تجنب الحديث عن حياته الشخصية.
وتشير صاحبة المذكرات إلى أن الأصول اليهودية من جانب أبويها ثم انتقال كليهما إلى الإسلام وهما ينتميان إلى ملل يهودية مختلفة، ثم زواج شقيقها من مسيحية، ثم زواج ابنة شقيقها من مسلم، كل ذلك جعل أسرتها شبيهة بـ«مجمع الأديان». والأهم من ذلك، هو أن «طبق السلاطة» التي كانت تسميه هكذا على سبيل المزاح، أنتج نوعية من الناس المنفتحين على قبول الاختلاف والرافضين بشدة أي شكل من أشكال التمييز بين البشر، فلم تسمع يوماً أن شقيقها قد تذمر من زواج ابنته بمسلم، ولا تتذكر أنها فكرت في يوم من الأيام أن تبحث عن الديانة التي ينتمي إليها الآخرون، سواء ممن تعرفهم عن قرب أو من العابرين في حياتي.
طبيب الإنسانية
وتروى المؤلفة أنه حين وقعت ثورة 23 يوليو (تموز) 1952 التي تسميها «انقلاباً»، كانت بصحبة والدتها وهما تقفان في شرفة منزلهما بشارع شامبليون بالإسكندرية، حيث تصاعدت من الطريق أصوات موسيقى عسكرية فسألتها: ما هذا؟... فردت ببساطة:
إنها الثورة.
لم تفهم معنى الكلمة، حيث كان عمرها ثلاث سنوات، لكن والدتها كانت مشغولة بالنظر لما يحدث في الشارع ولم تنتبه إلى نظرة الاستفهام في عينيها وهما يشاهدان الاحتفالات التي تدور أسفل الشرفة. شاهدتا فيلقاً من الجنود يمر وهم يرتدون زياً يختلف إلى حد ما عن بقية الجنود فسألت: ماما، من هم؟ فقالت لها: إنهم السودانيون.
لم تفهم وقتها كذلك من هم أو ما صلتهم بالحدث، فكل معلوماتها حينئذ اقتصرت على تعبير «الفول السوداني» واللب، ولكن مع القراءات اللاحقة لتاريخ مصر فهمت أن مصر والسودان كانتا دولة واحدة منذ عام 1820 وحتى عام 1956، وهو ما يفسر لها لاحقاً مشاركة الجنود السودانيين في الاحتفالات بالثورة عام 1952.
وفي القاهرة، ومن خلال وجود الأسرة في بيت شارع يوسف الجندي، ظل طبيب الأسرة هو الدكتور فريد حداد ذو الأصول اللبنانية من ناحية الأب، الاسكندنافية من ناحية الأم والتي تجلت في لون البشرة والعيون الفاتحة والشعر الكستنائي مع ميل للسلوك عميق الإنسانية الذي ورثه من ناحية الأب. كان يتميز بطيبة فطرية في تعامله مع من يعالجهم، بخاصة مع من يحتاجون أكثر من غيرهم إلى خدماته المجانية، سواء بالكشف أو بالعلاج والمتابعة. وأحياناً بشراء الدواء لهم على نفقته الخاصة، وهي الخدمات التي يقدمها في عيادته التي كانت تقع في حي شبرا بالقاهرة. ولو تراءى لصاحبة المذكرات - حسبما تروي - أنه يمكن تخيل وجه لملاك، فإنما تأتي صورته إلى ذهنها على الفور. وخلال عام 1958، نظّم والدها حفلاً في منزلهم على شرف هذا الطبيب للدور العظيم الذي كان يقوم به على المستويين الإنساني والنضالي. كما ورد الحديث عن فريد حداد في السيرة الذاتية للمفكر الفلسطيني - الأميركي إدوارد سعيد والتي حملت عنوان «خارج المكان» والتي يشير فيها إلى زواج فريد حداد بفلسطينية اسمها إيدا، وإنجابهما اثنين أو ثلاثة أطفال كما كتب سعيد، والواقع أنهما أنجبا كلاً من وديع وسامي ومنى، الذين عرفتهم نولة درويش شخصياً، كما تعرفت على والدتهم.
وتروى المؤلفة كيف تعرفت على الثنائي الفني المكون من الملحن والمطرب الشيخ إمام والشاعر أحمد فؤاد نجم، حيث أتيحت لها الفرصة وهي في مرحلة الشباب أن تحضر دعوة لحفل محدود العدد للشيخ إمام وكان ذلك في بيت شخص فلسطيني لم تره فيما بعد. أحضرت معها جهاز تسجيل من نوعية الكاسيت الذي لم يعد متداولاً وسجلت ليلتها كل الأغاني التي استمعت إليها والتي مثلت لها اكتشافاً حقيقياً أبهرها. تتذكر من الحضور المرحومة المناضلة شاهندة مقلد التي اشتهرت بالدفاع عن حقوق الفلاحين والتي تبنتها خلال هذه السهرة حين علمت أنها ابنه يوسف درويش. بقيت أياماً بعد الحفل تستمع إلى الشرائط التي سجلتها، وحينما لا تستمع إليها يظل صدى الأغاني يلاحقها في أذنها.
وحين أذيعت أغنية «يا مصر قومي وشدي الحيل، كل اللي تتمنيه عندي» خلال أيام ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، سالت دموعها من التأثر. تذكرت المرة الأولى التي استمعت فيها لأغاني إمام - نجم مثل «جيفارا مات» و«رجعوا التلامذة» و«اتجمعوا العشاق في سجن القلعة». ذهبت بعد هذا اليوم إلى لقاءات كثيرة مع الشيخ إمام ونجم، منها ما كان في منازل بعض الأصدقاء والمعارف، وأخرى في مدرجات الجامعة. كما سمعت أكثر عن أخبار القبض عليهما وبقائهما بالسجن لفترات. ومع ذلك، سمعت أيضاً أنه حينما كان هذا الثنائي محظوراً، سُئل الملحن العملاق رياض السنباطي في حديث إذاعي عن «أفضل عازف عود في مصر» فرد تلقائياً بأنه الشيخ إمام عيسى.