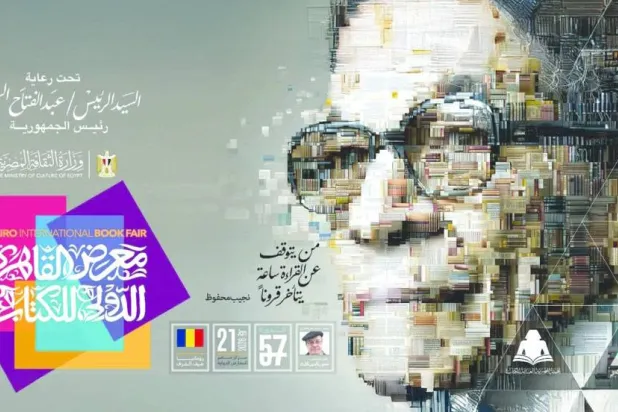أربكت موجات متلاحقة من التطورات التكنولوجية شهدها العالم خلال العقدين الماضيين مفهوم الدولة، انطلاقاً من التقدم العلمي الذي تجلّى في اختراعات وابتكارات تتصاعد كل يوم، مروراً بالوفرة الاتصالية عبر الإنترنت، وصولاً إلى تطبيقات متناهية الصغر تبدأ من الروبوتات وتنتهي إلى الصواريخ العابرة للقارات.
اتخذت تلك التطورات طابعاً كونياً، ووصلت لدرجة من التعقيد في التعامل مع الأجسام متناهية الصغر في حياتنا، ومتناهية البعد في المجرات الأخرى، كل ذلك عبر الأجهزة والتقنيات والشبكات التي حطمت الحدود وقربت المسافات واخترقت كل الأسوار، وأصبحت خطراً يهدد سيادة الدولة بمفهومها التقليدي وأقانيمها الثلاثة (الأرض –الشعب - السلطة).
ومن ثم، أصبح العالم بين خيارين: إما أن تتمكن الدولة من ترويض «وحش التكنولوجيا» الذي أصبح يشكل تهديداً وجودياً لها، أو يفرض «الوحش» شروطه ويقدم مفهوماً جديداً للدولة على مقاسه.
يطرح الدكتور مالك محمد القعقور، الإعلامي اللبناني، تلك الإشكالية بتوسّع في كتابه «فلسفة الدولة أمام التكنولوجيا الكونية»، متتبعا نشأة فكرة الدولة منذ عصر الإغريق وحتى العصور الوسطى وانتهاء بالعصر الحديث، كما يرصد تطورات التكنولوجيا منذ عصر الحرف وحتى عصر البخار ثم الأتمتة، وانتهاء بالعصر النووي.
يشير الكتاب الصادر عن دار أوراق بالقاهرة إلى التفاعل والمنفعة المتبادلة بين الدولة والتكنولوجيا، فالدولة توفر سبل وإمكانيات البحث والتطوير للتكنولوجيا، فيما توفر التكنولوجيا أدوات وآليات تخدم الدولة في مناح مختلف اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وحتى استعماريا.
ويشير المؤلف إلى أن هذه العلاقة التبادلية تغيرت بمرور الزمن، فمع ظهور فكرة العولمة وتحوّل العالم إلى قرية صغيرة، وهو ما يطلق عليه الكاتب مصطلحات مثل «الكوكبة» و«الكونية» و«الشوملة»، تصاعد دور الشركات متعددة الجنسيات التي وصل عددها إلى عشرات الآلاف، بحسب ما ورد في الكتاب. موضحا أن الأقانيم الثلاثة التقليدية، التي كانت تحدد مجال الدولة (أرض وشعب وحكومة)، تحولت إلى أرض وفرد يمتلك مجالاً افتراضياً وشعبا وحكومة، فالتعريف التقليدي للدولة بأنها «تجمع سياسي يؤسس كياناً ذا اختصاص سيادي في نطاق إقليمي محدد، ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة». لم يعد دقيقاً أو يعبر عن الواقع.
يعزو ذلك إلى أن التكنولوجيين ممثلين في شركات عملاقة عابرة للقارات تجاوزوا دور الدولة، بل أصبحوا يهددون وجودها، وبدأت تظهر تساؤلات حول جدوى «الدولة» وهل هي ضرورية؟ ويستشهد الكاتب، في الكتاب الذي يقع في 372 صفحة، برأي الفيلسوف الفرنسي جاك إلّول (1912 - 1994) في كتابه «خدعة التكنولوجيا» بأن الدولة تذوي ويحل محلها تنظيم اجتماعي غير سياسي مؤسس على نوع معين من المعرفة.
الشركات الكبرى تمكنت من إلغاء الحدود بين الدول، والتغاضي عن القوانين المحلية، مما أثّر على الدولة اقتصادياً واجتماعياً بشكل سلبي، وهناك مثال يطرحه الكتاب في النزاع بين شركة «أبل» والسلطات الفيدرالية الأميركية التي طلبت فك شفرات أجهزة أيفون لمشتبه في تورطه بجرائم إرهاب.
فحين حاولت الدولة مراقبة وسائل الإعلام والاتصالات لمعرفة ما يدور في خلد المواطنين، أو حتى لحماية نفسها أو مجالها السلطوي وجدت نفسها في مواجهة منظومة معقدة من التطور التقني تكاد تكون خارج السيطرة.
كل ذلك انعكس على مفهوم الإنتاج وأدواته ومن ثم على وظائف الدولة، فيمكن استبدال الآلة بالعمالة، وأصبحت هناك تهديدات شاملة عابرة للقوميات، وأخطار مرتبطة بالإنتاج الكيماوي والذري شديد التطور، مما أثّر في دلالات مفاهيم مثل الزمان والمكان والدولة والأمة.
يلفت الكتاب إلى تغيّر مفهوم السيادة في القرن الماضي، مع تطور التكنولوجيا وثورة الاتصالات والمعلومات، وتبدّل قوانين التجارة الدولية وآلياتها بطريقة أصبحت تنتهك السيادة الوطنية، برضا السلطات أو غير رضاها، كما ظهرت إمبراطوريات إعلامية ومؤسسات ومنظمات دولية غير حكومية تخرق سيادة الدول.
تلك التطورات خلقت صراعاً بين الدولة والمواطنين، ساحته شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، الطرفان يتنازعان على أحقية كل منهما في السيادة الافتراضية، فبعد أن كانت السلطة في يد الدولة انتقلت إلى يد الشبكة أو التفاعل بين الشبكات، فالأخيرة أصبحت تتنافس مع الدولة للهيمنة على «المواضيع الساخنة» وإبرازها أمام العالم.
الفلسفة التي أسست مفهوم الدولة، وسبق أن حذرت من مخاطر التكنولوجيا إذا تفلتت من سيطرة الإنسان، يجب أن تتصدى للمأزق الراهن الذي تواجهه الدولة، ويجب إعمال التفكير النقدي في «غربلة» المعلومات للوصول إلى الحقيقة لأنه السبيل الوحيد لعدم تحول البشر إلى «حشود جاهلة» يجرفها في طريقه «فيضان الإلكترون».
د. مالك القعقور
وتدخلت التكنولوجيا وثورة الاتصالات على الشبكة العنكبوتية في الكثير من الأحداث الكبرى، منها جماعة «أنونيموس» المعروفة بالقرصنة الإلكترونية منذ عام 2003، ولهم تعريف مجازي شائع بأنهم «الدماغ العالمي الرقمي اللاسلطوي»، وكان لهذه الجماعة دور في الهجوم على مواقع حكومية مثل موقع وزارة العدل الأميركية.
وقدمت الحركة الدعم الفني لعدد من الثورات العربية وحركة «احتلوا وول ستريت»، وتبنى الثوار في أكثر من دولة شعار الحركة وهو قناع «غاي فوكس» المعروف بـ«فنديتا». من هنا تتكون عصبيات افتراضية، من القبيلة إلى «فيسبوك»، لتشكل البنية الاجتماعية الجديدة في المجتمع الكوني الكبير.
ويتناول الكتاب نموذج المدن الجديدة (ما دون الدولة) التي تحظى بنشاط إنتاجي مميز في مجال معين، وتعرف باسم الدولة المصغرة تتعامل بشكل مستقل عن الدولة أحياناً، ويصل الأمر لدرجة أن يكون لها تمثيل دبلوماسي عبر بعثات تحت شعار الدولة الأم.
ومن مخاطر تشريد العمال إلى تطوير الأسلحة إلى التحكم في الجينات البشرية يتحول التطور التكنولوجي إلى ما يشبه «صندوق بندورا»، الذي يحمل كل شرور العالم، فهو منظومة متضخمة تعجز السياسة أمامها، ومن خصائصها الاستقلال الذاتي، كما أنها تسير وتنتشر في كل أنحاء العالم وفق قوانينها الكونية.
من هنا تصبح الدولة في حاجة إلى تعريف آخر أو إطار جديد يحتويها ويحدد دورها ووظائفها، بعد أن تآكل مبدأ السيادة على جميع الجبهات (الأرض - الشعب - السلطة).
يطرح الكتاب أربعة سيناريوهات محتملة لشكل الدولة الجديد في ظل التطور الهائل للتكنولوجيا الكونية. السيناريو الأول: أن تحل الشركات متعددة الجنسيات محل الدولة، وتتنازل الدولة عن أجزاء من سيادتها لتلك الشركات. السيناريو الثاني: أن تستمر سيادة الدولة وتخسر جزءاً من وظائفها الاقتصادية والمالية. السيناريو الثالث: تشكيل حكومة عالمية (دولة كوكبية) تتنازل لها الدول القومية عن سيادتها. السيناريو الرابع: تفكيكي؛ ومفاده أن تتحول الدولة إلى مئات من الدول القومية الصغيرة بدواع مختلفة.
في النهاية يعلي القعقور من قيمة «التفكير النقدي» وقدرته على تقييم ما سيحمله الغد، مشيراً إلى أن الفلسفة التي أسست مفهوم الدولة، وسبق أن حذرت من مخاطر التكنولوجيا إذا تفلتت من سيطرة الإنسان، تتصدى للمأزق الراهن الذي تواجهه الدولة، وأن إعمال التفكير النقدي في «غربلة» المعلومات للوصول إلى الحقيقة هو السبيل لعدم تحول البشر إلى «حشود جاهلة» يجرفها في طريقه «فيضان الإلكترون».