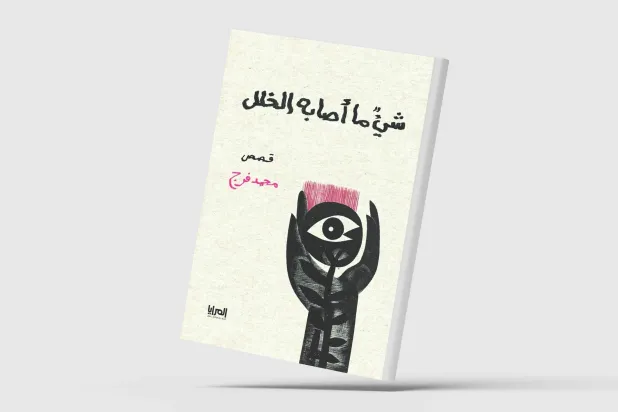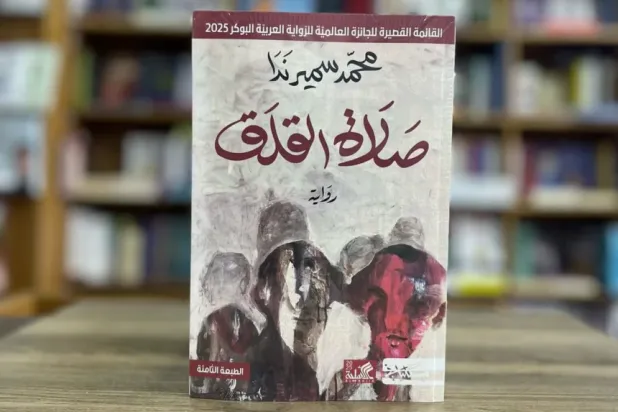يتناول كتاب «الكتابة السردية في اليمن - قراءة أولية في الدلالة والمؤشرات» الصادر أخيراً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب للناقد والباحث محمد جازم، وواقع هذه الكتابة من عدة زوايا ورؤى نقدية، فيستهله بنظرة عامة في مناخات هذا المشهد، ثم يتوقف بشكل خاص وتفصيلي أمام عدد من الإبداعات الروائية اليمنية التي تمثل آفاقاً جديدة في الكتابة السردية.
يشير المؤلف في استهلاله الكتاب إلى أن «الروائيين الجدد» في اليمن يشكلون جيلاً اكتشف قارات جديدة في الإبداع وتحمَّل على عاتقه مقاومة ظروف وملابسات تجعل البلاد تهرول بسرعة جنونية في اتجاه اليأس. إنه جيل متمرد على التقاليد البالية يَجمع بين استحقاق الحداثة والحرص على الهوية، ويبدو أكثر قدرة على قراءة الواقع وأشد عزيمة على مقاومة الضجر إلى درجة أنه وجه خطواته باتجاه المجتمع ليتغلغل في منابته حتى صارت له جذور متينة متداخلة بعناصر الهوية والجمال والتاريخ.
ومن أبرز الأسماء في هذا السياق على سبيل المثال لا الحصر، علي المقري وأحمد زين والغربي عمران ووجدي الأهدل وسمير عبد الفتاح ومحمد عثمان وعبد الناصر مجلي وبسام شمس الدين.
عُرف المقري في الثمانينيات والتسعينيات شاعراً وقاصاً حتى أصدر روايته الأولى «طعم أسود... رائحة سوداء» عام 2008. ويُبرز العنوان جنوح الروائي وسعيه الحصيف إلى استخدام اللغة الشعرية المرتبطة بالتخييل وهو اتجاه يتشكل لدى «المقري» بسهولة لأنه يذهب إلى عالم ذي حساسية مفرطة وهو عالم المهمشين المسكوت عنهم في المجتمع. طائفة ممن يعيش أصحابها في ظروف قاسية وينتزعهم الكاتب من ذلك الظرف القاسي ويحركهم في عمل روائي مبتكر وقد أعطت غرائبية الأحداث النص زخماً متجدداً.
تتحدث الرواية عن علاقة حب نشأت بين شاب وفتاة مهمشة ترتب عليها هروبهما معاً من مجتمع الريف الذي يلفظ نشوء مثل هذه العلائق إلى مجتمع المدينة ليستقرا في منطقة سكنية بمدينة تعز تسمى «محاوي». هنا يفتح النص أشرعته ويُبحر في اتجاه سرد المختلف.
تدور الأحداث في الرواية بين عامي 1970 و1982 وهي حقبة شهدت تقسيم اليمن بين شماليٍّ وجنوبيٍّ، إذ استطاع الروائي أن يوظِّفَ الأحداث الكبرى التي شهدتها البلاد لتنعكس بشكل مباشر على شخصيات العمل.
وتأتي «اليهودي الحالي» بوصفها الرواية الثانية للكاتب والتي تنكأ فنياً الكثير من الجراح والبثور الملتهبة. تقوم الحبكة هنا على قصة حب مغايرة أيضاً كسابقتها، لكنها هذه المرة مغايرة تماماً، بين فتاة مسلمة وشاب يهودي، وهي مفارقة صادمة وانفجارية إذا أخذنا بعين الاعتبار الأجواء الملتبسة في الرواية. تزداد المفارقة اتساعاً كلما عرفنا أن فاطمة، بطلة العمل، لم تكن فتاة سلبية عادية وإنما فتاة تميزت بحبها المعرفة وقراءتها الواسعة في الكتب الدينية والتراثية، وقد دفعتها سعة الاطلاع إلى اختيار حبيبها من خارج النسيج المعتاد لأن الوعي الذي بنته لا يعترف بحدود أو حواجز.
لم تكتفِ فاطمة بالمحبة فقط وإنما راحت تُعلِّم بطلها القراءة والكتابة ونقلت إليه الكثير من معارفها، وهو سلوك إنساني يندرج ضمن التطلع إلى التعايش المشترك ونبذ الفُرقة والتسلط والقمع، كون الإنسان أولاً وأخيراً ابن بيئته وابن مجتمعه وجغرافيته ولا يمكن بأي حال من الأحوال نبذ الآخر بسبب معتقده أو ديانته أو رأيه. وكان لافتاً أن شخصيات «اليهودي الحالي» هي في الحقيقة من الشخصيات البسيطة العادية التي تأخذ طابع المحلية، ولعل هذا من الأسباب التي دفعتها لتكون عالمية عبر ترجمتها إلى أكثر من لغة.
في هذا السياق يأتي الكاتب محمد الغربي عمران الذي أصدر عام 2010 رواية لافتة بعنوان «مصحف أحمر»، التي تحمل بين أجنحتها الفنية تطوراً لافتاً، أُضيف إلى بنية الرواية اليمنية، حيث تداخلت عوالمها بين الواقعية والرمزية والسريالية، بمعنى أنها كسرت رتابة المدرسة الكلاسيكية في الكتابة. ويلفت الباحث إلى التعامل مع الزمان في الرواية، وكيف لعب بدلالاته المكانية دوراً مهماً فيها. هنا تبدو شخصية «العطوي» شخصية مركزية في فضاء النص بامتياز وتتمتع بسمات حالمة، حيث يسعى إلى تذويب الفوارق التي تؤدي إلى الصراع بين البشر على أسس مذهبية أو طائفية أو عرقية أو مكانية. اشتغل الكاتب على النحت اللغوي الذي طال أسماء شخصياته لتحمل مدلولات جمالية ساعدت على تثبيت الأحداث في ذهن المتلقي. ومن تلك الأسماء شخصية «سمبرية» و«تبعة» و«فطمينا» و«حنظلة» و«العطوي».
أما الكاتب أحمد زين، فيشير المؤلف إلى أنه يعد من أهم الكتاب اليمنيين الذين رفدوا المكتبة اليمنية بإبداعاتهم المتنوعة، فبعد أن أصدر الكثير من المؤلفات القصصية انتقل إلى الرواية التي أصدر منها «تصحيح وضع» 2004، و«قهوة أميركية» 2008، و«حرب تحت الجلد» 2011.
تميز زين خلال رحلته الكتابية بأسلوبه الخاص ولغته الخاصة وأسئلته الفنية. ورغم عمله الصحافي وانشغالاته، فإنه ظل وفياً للكتابة الإبداعية التي مكّنته من تبوُّأ مكانة جيدة في المشهد. وتعد روايته المدهشة «قهوة أميركية» إحدى الروايات الأكثر حضوراً في المشهدين اليمني والعربي وذلك لأنها راحت تطرح أسئلة كثيرة تتعلق بشخصية الإنسان اليمني وما يقابل ذلك من رفض وانتقاد، حيث تُظهر «عارف»، بطل العمل، في الاتجاه النقيض المعارض للخمول والجمود، لكن الدراما تتصاعد على نحو نواجه معه سؤالاً جوهرياً: هل يكمن الخلل في رؤية «عارف» للحياة أم في الحياة نفسها؟