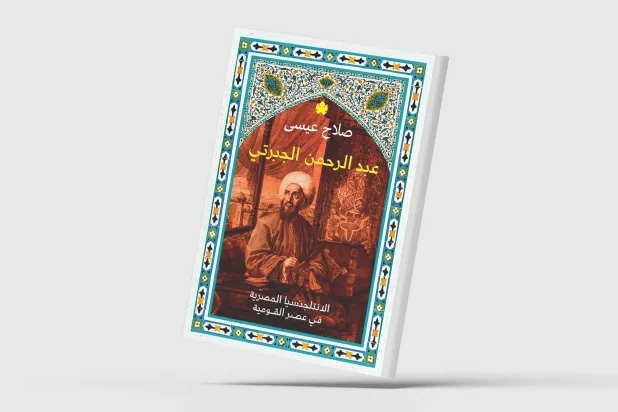لم يعد العالم هو العالم بعد ظهور الرأسماليّة بمفهومها الحديث. إذ مع تطوّر مفهوم العمل المأجور كأساس للثورة الصناعيّة تغيّرت علاقة الأكثريّة الساحقة من البشر بحياتهم وطريقة قضائهم لأوقاتهم، لتتوزع حول الفضاءات الثلاثة: العمل والترفيه والتبطّل.
صوّر فلاسفة البرجوازيّة مثل ماكس فيبر العمل كقيمة عليا، أقرب ما يكون إلى الواجب الديني كما في الثقافة الغربيّة البروتستانتية، فيما أُلبس التبطّل والكسل رداءً شيطانياً، وأسبغت عليهما صفات سلبيّة تربطهما بغياب الإنتاجيّة، وبالتعطّل، والفراغ المؤدي إلى المفسدة والموبقات (كما في رواية فلوبير الشهيرة «مدام بوفاري»). على أنّ الترفيه - بمعنى إشغال الوقت عندما يتوقف العمل مؤقتاً للاستراحة -، تلك المساحة بين هذين الأقنومين الجدليين المتناقضين، أي العمل والتبطل، اكتسب وعلى نحو متزايد في موازاة التقدّم التكنولوجي المتسارع أبداً أهميّة ومركزيّة، للمنظومة الرأسماليّة وللفرد على حد سواء، ودائماً على حساب الرّاحة. لقد تحوّلت الكيفيّة التي نقضي بها وقتنا عندما لا نكون على رأس عملنا بعد الثماني ساعات (اليومية) أو خلال العطلة الأسبوعيّة أو الإجازات السنويّة إلى شبكة من صناعات ضخمة قائمة بذاتها، من السياحة الاستهلاكيّة وارتياد المطاعم والمقاهي إلى المنتجات الثقافيّة على تعدد أنواعها (الكتب، والأفلام، والمسرح والحفلات الغنائيّة، والمهرجانات...)، تتنافس جميعها على توسيع حصّتها من كل وقت مخصص للراحة، بل وشرعت كما يقول جوناثان كريري في كتابه اللاذع «24/7: الرأسماليّة المتأخرة والقضاء على النوم» - 2014* بقضم ما بعد حصتها التقليديّة من وقت الإنسان عبر تقليل عدد ساعات نومه اليومية التي تلتهمها بشراهة لافتة وفرة شاشات قريبة - تلفزيونات وكومبيوترات وهواتف ذكيّة (وغيرها).

ومن الظّواهر اللافتة في هذا المشهد تبدو ألعاب الفيديو الحديثة وكأنّها النموذج الأكثر تعقيداً من أدوات الترفيه التي أصبحت ممكنة في عصرنا بفضل تراكم التقدّم التقنيّ، والتي بحكم انتشارها المتشظي عبر مختلف الطبقات والدوائر الاجتماعيّة لم تعد مجرّد أدوات للعب وفق المفهوم التقليدي الذي نحته ليوهان هويزينجا في كتابه الشهير «هومو لودينز - أو الإنسان كمخلوق لاعب» - 1938*، بل أصبحت أداة لتعظيم الاستهلاك «اقتصادياً» ومصنعاً لتشكيل الوعي «الزائف» (إن جاز التعبير) وفق ما تحبّه المنظومة الرأسمالية وترضاه «سياسياً».
فخلال عقود قليلة، تطورت ألعاب الفيديو شكلاً ومضموناً لتفرض وجودها على الثقافة المعاصرة، واحتلت لها مساحة من وقت الترفيه لملايين الأفراد على حساب المنتجات الثقافيّة الأخرى - إضافة إلى جزء من وقت النوم اليومي -، ودخلت بلا استئذان في قلب دائرة اهتمام رأس المال العالميّ، وأصبحت بعض إصداراتها الجديدة أو التحديثات على الألعاب الموجودة فعلا بمثابة حدث هائل يستحق متابعة مكثفة عبر وسائل الإعلام.
وعلى الرّغم من ذلك، فإن هذه الصناعة الصاعدة لم تأخذ بعد حقّها من التحليل الفلسفي - أقلّه مقارنة بالمادة المتوفرة للمنتجات الثقافيّة الأخرى (قارن مثلاً مع نظريّة الرواية أو المسرح)، ما يفرض على المراقب إن هو عزم على وضعها في نسق عقلانيّ الاستعانة بأفكار الرّواد مثل جان بودريار مثلاً الذي سبق إلى التبشير بسعي منتجي الوعي إلى اجتراح واقع بديل من الواقع الحقيقيّ (مفهوم الـHyper-reality).

ويبدو تطوّر ألعاب الفيديو مطابقاً لنظريّة بودريار كما في كتابه الشهير عن «التشبيهات والمحاكاة - **» عن مرحلة من العالم الرأسمالي شرعت معالمها بالتشكل وتتظافر فيها تقنية المعلومات مع أدوات الاستهلاك الإعلاميّ لتخليق واقع بديل يكاد مع مرور الوقت يبدو محاكاة مستقلة بالكامل عن الحقيقة، حيث بدأت الألعاب أقرب لصيغة تعكس الواقع القائم، قبل أن تنطلق لاستكشاف طرائق لتمويه أو تشويه حقائق قائمة، ومن ثمّ إلى مرحلة التغييب التام لحقائق أساسيّة، قبل أن تخلق واقعاً بديلاً متكاملاً، ليس له علاقة إطلاقاً بالحقيقة، بل مجرّد محاكاة خالصة خاصة به.
ولعل لعبة سيمس «Sims» الذائعة الصيت تكون أفضل مثال لتطبيق نظريّة بودريار على عالم ألعاب الفيديو. فهذه اللعبة التي أطلقت قبل عقدين فقط (صممها المبرمج ويل رايت)، أصدرت أربع نسخ متعاقبة وصلت إلى أيدي ما لا يقل عن 80 مليون «لاعب» ودرّت على الشركة صاحبة الامتياز («إليكترونك آرتس» الأميركيّة) ما يزيد على خمسة مليارات دولار (الرقم لنهاية عام 2021). وتقوم على أساس خلق عالم «الحلم الأميركي»، كيوتوبيا اجتماعيّة متقدمة يمكن للاعب فيها أن يتقمص حياة أخرى، فينشأ منزلاً متخيلاً وفق نسق يختاره، وعائلة على هواه من خلال انتخاب الجينات عبر الأجيال، فيما الفضاء الحضري الذي يحوم فيه متخم بخدمات ترضي مختلف الحاجات العاطفيّة والعلاقاتية.
وتمكّن «سيمس» لاعبها من تجاوز يومه إلى حياة يوميّة بديلة معفاة من هموم العيش الحقيقيّ في ظل النظام الرأسماليّ، إذ له فيها أن يمارس صلاحيّة، دون مرجعيات سوى المشاعر الذاتية، لاختيار الشريك (أو الشريكة)، والمهنة، وكيفية قضاء الوقت في أنشطة مختارة تبدو ممتعة في الواقع الافتراضي. ولكن كل ذلك يظل بوتقة منعزلة تماماً عن حقائق العالم الحقيقيّ التي تجعل هامش الاختيارات وحريات توظيف الوقت ضيقاً للغاية ومحكوماً باعتبارات بنيوية وسياسيّة وتاريخية واقتصادية واجتماعيّة يكاد الذاتي فيها يكون منعدماً لدى أغلبيّة البشر.
الإنسان كما في «سيمس» مستهلك مثاليّ يكسب وينفق دخله في شراء الممتلكات التي تحقق له الرضى ويعيش وفق القيم الغربيّة فيما يتعلق بالحريات الشخصية والاستغراق بالملذات والهوى في إطار «خادع» من الأمن والأمان المستديمين. ويجد كثيرون فيما يبدو أن هذه الحياة البديلة توفر لهم مهرباً من واقعهم القاسي إلى فانتازيا عالم أجمل يمتلكون فيه السيطرة على مصائرهم، وحريّة ممارسة الأمور افتراضياً دون بذل جهد ومال إضافيّ (مثلاً زراعة نباتات في حديقة المنزل الافتراضي الخلفيّة ورعايتها وقطف زهورها بينما قد لا يمتلك المرء حديقة في الواقع القائم وربما ليس لديه الاهتمام للعناية بنباتات حقيقيّة).
إن هذه الخبرات التي تستنفد وقت التّرفيه للملايين من البشر (و«سيمس» ليست إلا نموذجا واحدا من آلاف مؤلفة من الألعاب الأخرى) تخدم بصفاقة ظاهرة غرضي المنظومة القائمة لما بعد إنسان «هويزينجا» اللاعب: تعظيم الاستهلاك (سواء مباشرة عبر اقتناء نسخ الألعاب ومشغلاتها ومستلزماتها وتوابعها أو غير مباشرة عبر استهلاك الطاقة وربما المسليات الغذائيّة والمشروبات ومختلف المنتجات ذات الصلة وهكذا)، وأيضاً المساهمة في صياغة وعي الأفراد سياسياً واجتماعياً كي يتماهوا مع الصيغ الليبرالية القائمة في الغرب (وقطعاً تلك التي يراد لها أن تقوم في المجتمعات الأخرى).
هذه الصناعة الصاعدة لم تأخذ بعد حقّها من التحليل الفلسفي أقلّه مقارنة بالمادة المتوفرة للمنتجات الثقافيّة الأخرى
ومع ذلك، فإن أصواتاً جديدة من مصممي ألعاب الفيديو مثل باولو بيدريشيني وماري فلانغان وإيان بوغوست ترى أن هذا المنتج العالي التقنيّة - كما كل معطيات التكنولوجيا الحديثة - ليست خيّرة أو شريرة بحد ذاتها، وإنما أداة محايدة يمكن للبشر أن يوظفوها لاستعمالات ترتبط بتوجهاتهم. إذ يمكن ولو نظرياً أن يتم تصميم ألعاب فيديو تستفيد من حاجة الناس إلى الترفيه عبر اللعب لتمنحهم تجارب افتراضيّة ومشاعر قد ترتقي بوجودهم الإنساني وتغني تجربتهم المعيشة في الواقع، وتكون أدوات للتأسيس لمجتمعات أقل ميلاً للتنافس والعنف، وأقرب إلى مزاج التعاون الخلاّق، وشكلاً مغايراً للإبداع الفنيّ البشريّ.
وبينما تبدو هذه الفكرة صائبة و«جذابة» على صعيد النظريّة، فإن السؤال - على أرض الممارسة - يبقى: أي رأسمال ذاك الذي سينتج ترفيهاً يتضمّن بذور وعي قد تكون غير صالحة اقتصادياً أو سياسياً، على مدى متوسط أو بعيد؟
إن ألعاب الفيديو هي هبة الرأسماليّة المتأخرة، وإلى مستقبل قريب ستبقى حتماً كما بدأت، إحدى أمضى أدوات الهيمنة على حياة البشر من خلال فضاء الترفيه، وأكثرها قدرة على التحوّل والتطّور توازياً مع تمدد سيطرة التكنولوجيا على عالمنا. فهل سيأتي يوم نترك فيه العمل نفسه للروبوتات والذكاء الاصطناعي، ونتفرّغ لقضاء سحابة وقتنا - بدل التبطّل - في الترفيه من خلال اللعب؟