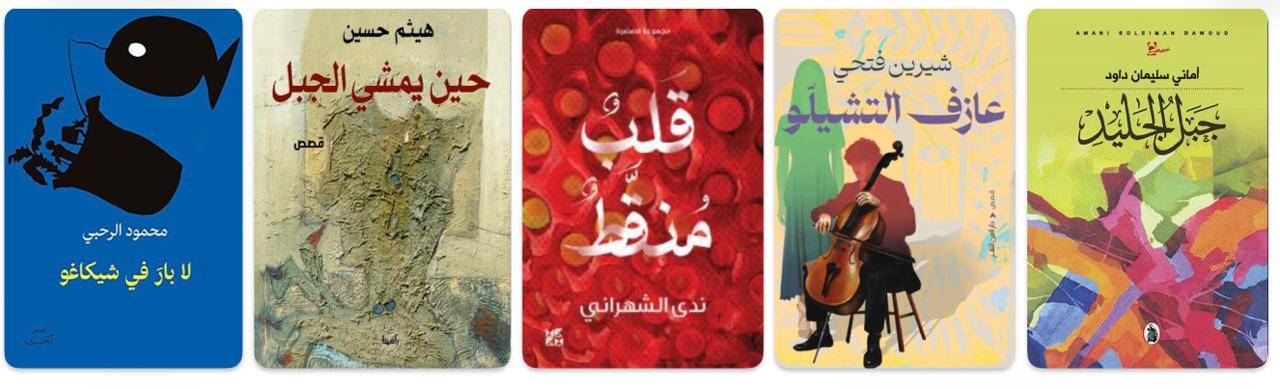أخيرا انطفأ إيف بونفوا بعد عمر مديد ناهز الثالثة والتسعين عاما؛ فقد ولد في مدينة تور الواقعة على نهر اللوار، حيث ولد بلزاك أيضا قبل قرن أو قرنين. ولد عام 1923 وتوفي في الأول من يوليو (تموز) 2016. عاش إيف بونفوا وتقلب في المناصب الجامعية حتى وصل إلى أعلاها: الكوليج دو فرنس، أعلى من السوربون، ودرس في مختلف جامعات العالم الأوروبي – الأميركي، ونشر ما لا يقل عن مائة كتاب! فلم يكن شاعرا فقط وإنما ناقدا أدبيا ومنظرا للشعر من أرقى ما يكون، كما كان مترجما عظيما نقل معظم «شكسبير» إلى لغة الفرنسيين، وترجم أيضا الكثير من أشعار ييتس. الترجمة بالنسبة له كانت متوازية مع عملية الكتابة ولا تتناقض معها على الإطلاق. اذهب واقنع بعض المثقفين العرب الأشاوس بهذه الحقيقة البسيطة. كلهم عباقرة لا ينزلون إلى مستوى الترجمة ولا يضيعون وقتهم في مثل هذه الفعالية الثانوية الهامشية التي لا تليق إلا بالفاشلين الذين عجزوا عن أن يصبحوا كتابا حقيقيين فشغلوا أنفسهم بالترجمة. كل ما يبدعه هؤلاء «وحي إلهي» من بنات أفكارهم، أو هكذا يتوهمون.. لكن دعونا من هؤلاء المثقفين العرب العظام ولنعد إلى إيف بونفوا.
في عام 1972 نشر الشاعر كتابا نثريا يشبه السيرة الذاتية بعنوان: «البلاد الخلفية أو البلاد العميقة»، وهو تعبير فرنسي يعني ما وراء الواجهة في أي بلد أو منطقة. مثلا عندما تكون في بيروت فإن البلاد الخلفية هي ما يقع وراء بيروت في الجبال والوديان والقرى والمزارع المتوارية عن العاصمة والبعيدة عنها. كثيرا ما أعجبني هذا التعبير ووجدت فيه شحنة شعرية حقيقية. المهم أن إيف بونفوا كان يقضي عطلته الصيفية عند أقاربه في تلك المناطق الريفية الساحرة، وفجأة في أحد الأيام رأى أمامه في الأفق شجرة على تلة، وأحس وكأنها شخص أو كائن حي يعنيها أمره. يقول: لم تكن فقط جزءا من الأفق أمام عيني وإنما كانت كائنا حيا له علاقة شخصية معي. شعرت وكأن هذه الشجرة سترافقني كل حياتي. وهكذا أحببتها كصديق أو كصديقة. وهذا الشعور كان جديدا بالنسبة لي وغير معروف حتى ذلك اليوم. وقل الأمر ذاته عن النهر الكبير الجاري في المنطقة الجبلية نفسها التي كنت أقضي فيها أصياف طفولتي. هو أيضا شعرت بأنه شخص يعنيني أمره. لم أكن أعرف من أين جاء ولا أين يصب، ولكن مجرد جريانه أشعرني بأنه سائر نحو المستقبل المجهول مثلي أنا كطفل سائر نحو مستقبل لم أتعرف عليه بعد..
هذا الكلام لا يقوله إلا ابن مدينة ولد في تور وعاش في باريس الخ، أما ابن الفلاحين فيعيش مع كائنات الطبيعة من الصباح وحتى المساء وربما ضجر منها وتمنى لو أنه يسكن المدينة. على أي حال فهذه قصة أخرى. الشيء المهم هو أن شاعرنا الكبير يمجد الريف والقرية والطبيعة في حين أن بعضنا من سكان المدن والعواصم يحتقرون كل ذلك. مرة قال لي أحد المثقفين المشهورين: اذهب أنت فلاح! المقصود غشيم أو أي شيء من هذا القبيل. فكدت أموت من الضحك ليس فقط منه وإنما عليه. في الواقع أني أفتخر بأني ولدت في القرية ولا أجد في ذلك أي معرة على الإطلاق. هنا أيضا ينبغي أن تلقي درسا تأديبيا على بعض المثقفين العرب الذين يحتقرون الطبيعة والريف على عكس إيف بونفوا. هكذا تلاحظون أني أستغل فرصة الكتابة عن هذا الكاتب المحترم لكي أصفي حساباتي الشخصية. وهذه انتهازية ما بعدها انتهازية. ولكنها انتهازية إيجابية أو حتى أخلاقية إذا جاز التعبير.
ما موضوع الشعر بالنسبة لإيف بونفوا؟ أنه الحضور المليء أو الممتلئ للأشياء. الشعر هو ولادات دائمة. الشعر هو تلك النظرة المكثفة التي نلقيها على الأشياء البسيطة للحياة اليومية. كل ما حولنا يمكن أن يتحول إلى شعر في أي لحظة. بإمكانك أن تعيش الحياة شعريا أو نثريا، أنت حر. ولكن هل تستطيع أن تعيشها شعريا أربعا وعشرين ساعة على أربع وعشرين ساعة؟ مستحيل. حتى ريلكه عاجز عن ذلك؛ ولهذا السبب فإن شاعر فرنسا الأكبر في هذا العصر يعود دون أي كلل أو ملل إلى الموضوعات العزيزة نفسها على قلبه: أي الأشجار والأحجار والينابيع والثلج والأحلام، الخ.. وكلها أشياء موجودة في الريف، في الوديان أو قمم الجبال.. هل فهمتم يا متخلفين! يا فلاحين!
كثيرا ما تساءلت عن معنى كلمة رامبو الشهيرة: ينبغي أن نكون حديثين بشكل مطلق. وبما أني فلاح غشيم بطبيعتي فقد اعتقدت أنه يعني بها ما يلي: ينبغي أن نقطع مع الماضي كله جملة وتفصيلا لكي نستطيع أن نكتب شعرا جديدا له معنى، وإلا فسوف نكرر من سبقونا ولن نضيف أي شيء إلى خريطة الشعر. والواقع أن هذا المعنى ليس خاطئا كله، بل وحتما كان مقصودا من قبل أكبر «أزعر» في تاريخ الشعر الفرنسي: آرثر رامبو. فمن يقرأ شعره يعرف أنه كان يتكئ على نفسه كما يقول أبو تمام لا على سواه. وهذه ميزة الشعراء العظام، إنهم يخلقون الأشياء من عدم تقريبا، ولكن إيف بونفوا نبهنا إلى شيء آخر وأعطى تفسيرا جديدا لعبارة رامبو. يقول بأن رامبو يقصد ضرورة تخليص الشعر من اللغة الخشبية للآيديولوجيات الامتثالية السائدة، وليس معناها الشطب على عظماء شعراء الماضي، فلا توجد حداثة حقيقية إلا إذا كانت تعرف معنى الإعجاب بقصائد الماضي العبقرية وضرورة المحافظة عليها. على أي حال، فإن هذا التفسير لا يلغي ذاك وإنما يكمله. من المعلوم أن رامبو كان معجبا ببودلير إلى أقصى حد، بل وكان يعتبره ذروة الشعر. ولكن لو قلده لما أصبح شاعرا متميزا ولظل نسخة باهتة عن شاعر كبير آخر. لو لم ينحرف عنه و«يقتله» في داخله لما استطاع رامبو أن يصبح رامبو. هذا هو معنى العبارة الشهيرة. والله أعلم.
على أي حال شكرا لإيف بونفوا الذي أتحفنا بكتاب ضخم في أواخر حياته عن شاعر الحداثة الأول. انظروا كتابه: حاجتنا إلى رامبو. منشورات سوي الباريسية في أكثر من 450 صفحة من القطع الكبير. بمعنى: لا نستطيع أن نعيش من دون رامبو. أو قل بأننا في حاجة إليه من وقت إلى آخر لكي يشحننا شعريا، لكي يفجر في أعماقنا قوة الرفض ضد ما هو قائم من ظلم وقهر وغباء. يقول رامبو في ديوانه الشهير فصل في الجحيم هذا البيت: لنترك أوروبا التي يتسكع فيها الجنون! فهل كان عدوا لأوروبا وفرنسا في المطلق؟ أبدا لا. ولو عاش في هذا العصر لما غادرها لحظة واحدة، لكنه عاش في القرن التاسع عشر، أي في عصر مليء بالخضات والهزات والحروب والمجازر، فكره بلاده والمنطقة كلها وهاجر إلى بلاد العرب القصية.. يقول إيف بونفوا، أكبر عارف برامبو: «كل شيء ابتدأ من تمرده على الحياة الرتيبة في المحافظات البعيدة. كل شيء انطلق من تمرده على الدين المسيحي الذي كان لا يزال قمعيا في فرنسا آنذاك. كل شيء انطلق من تمرده على النظام البورجوازي السائد. وعن طريق قلب نظام الكلمات راح رامبو يقلب نظام الأشياء، بل والنظام الاجتماعي كله. من هنا أهمية الثورات الشعرية التي تسبق عادة الثورات الفكرية والسياسية. ولكن من يقدر على تغيير نظام الكلمات؟ من يقدر على تفجير الكلمات؟ القول سهل والفعل هو الصعب.ليس كل الناس رامبو!
يقول إيف بونفوا ما معناه: عندما تجف الحياة يأتي الشعر لكي يحييها، لكي يضخ الحيوية في عروقها وشرايينها. الآيديولوجيا متخشبة، ميتة، ووحدها شجرة الشعر تبقى دائما خضراء..
إيف بونفوا: عندما تجف الحياة يأتي الشعر لكي يحييها
فرنسا تودع شاعرها الأكبر الذي رحل عن 93 عامًا

إيف بونفوا .. شاعر فرنسا الاكبر

إيف بونفوا: عندما تجف الحياة يأتي الشعر لكي يحييها

إيف بونفوا .. شاعر فرنسا الاكبر
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة