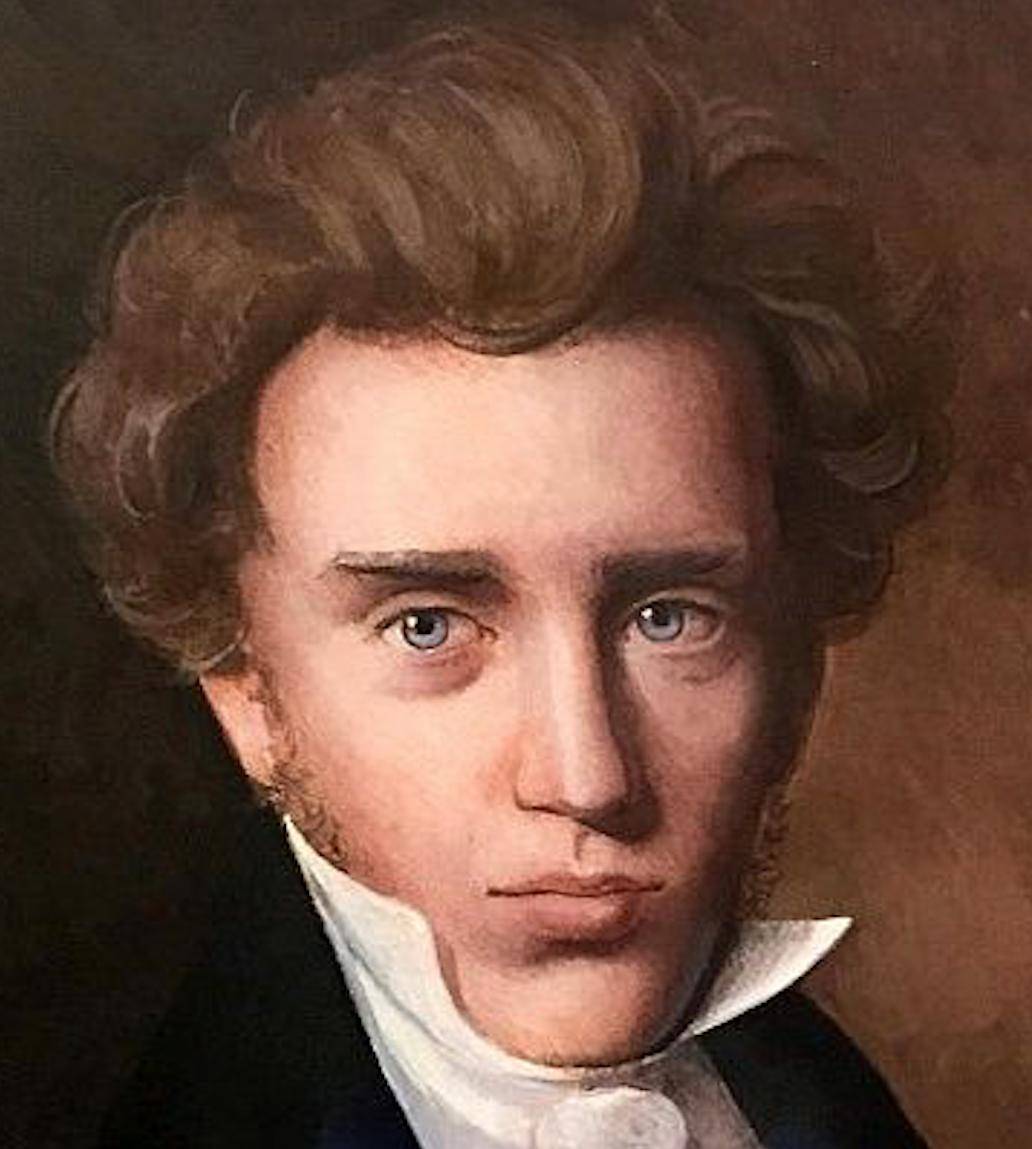عن الموضة، نشأتها وعالمها وثقافتها وفلسفتها وجنونها الدعائي، وأقنعتها التي قد تنقلك من طبقة إلى أخرى، أو تهوي بك إلى الحضيض، يدور هذا الكتاب الشيق «مملكة الموضة.. زوال متجدد»، للفيلسوف الفرنسي عالم الاجتماع الشهير جيل ليبوفتسكي، الذي ترجمته للعربية بسلاسة ممتعة وقدمت له الدكتورة دينا مندور، وصدر حديثاً عن المركز القومي للترجمة بمصر.
وتتساءل المترجمة، في تقديمها للكتاب، عن الدوافع التي تجعل فليسوفاً ذائع الصيت يهتم بموضوع هو من قبيل الرفاهية وترف الضرورة الإنسانية، لكن الأمر يبدو طبيعياً بالنسبة لفيلسوف اشتهر بكتاباته عن سلوكيات الإنسان في مجتمعات ما بعد الحداثة، ووصفها بـ«الحداثة المفرطة»، وكان ذلك محوراً مهماً في عدد من مؤلفاته، ومن أبرزها «زمن العدم» 1998، و«مجتمعات الإخفاق» و«السعادة المفارقة» 2006، و«المرأة الثالثة» 2012، وقد ترجمته أيضاً الدكتورة مندور، وصدر في السلسلة نفسها.
وينطلق الكتاب بصفحاته التي تربو على 300 صفحة من القطع الكبير من فكرة أساسية، مفادها أن تاريخ الأزياء لا ينفصل عن تاريخ المفاهيم والإشكاليات التي تسيطر عليها، فالزي لا يقتصر على المظهر الخارجي للإنسان، ولا على نزعة التنافس بأبعادها الطبقية، بين الغنى والفقر، وإنما هو تعبير عن رؤى وقيم ثقافية، تعبر عن الجديد، وعن شخصية الإنسان التي لعبت دوراً أساسياً في ظهور الموضة في أواخر العصور الوسطى. فقد ساهم كل هذا في التخطيط للمراحل الرئيسية لتنامي ظاهرة الموضة عبر مسارها التاريخي، حيث يرى ليبوفتسكي أنه في نهاية تلك العصور تحديداً، تجسدت كثير من العلامات التي تشهد على حالة الأخذ في الاعتبار غير المسبوقة للهوية الانطباعية لإرادة التعبير عن التفرد الفردي، وتمجيد الفردانية، وهو ما ظهر في كتابة يوميات ومذكرات، ظهر فيها الانشغال بهوية المتحدث في تعبير فردي، كما ارتفعت نبرة البوح الحميم، في الأعمال الشعرية والأدبية، واتسعت المساحة لظهور البيوغرافيا الذاتية والبورتريه الذاتي الواقعي.
ويؤكد الكتاب على هذه الفردانية، ويعزو إليها فكرة زحزحة التقليدي الثابت، في كل أوجه الثقافة والفن. وفي المقابل، دعم صيرورة الابتكار المستمر في الأشكال والأساليب، الأمر الذي مهد الأرض أمام الموضة لتنتشر بإيقاعات متسارعة، والركض وراء الاختلاف والمنافسة إلى حد الطيش والجنون، ما شجع على ظهور التعبير عن الأذواق المتفردة، والاستمرار في البحث عن علامات جديدة، تتجاوب مع صيحات الطبقة الراقية، وتلبي احتياجاتها ورغباتها، وهو ما انعكس بدوره على مناشط الحياة والفكر المعرفي بشكل خاص.
ويذهب ليبوفتسكي إلى أن صيرورة من إضفاء الأسلوبية على معايير الحياة والأذواق صاحبت التكثيفَ، وتسارع البحث عن متع الحياة نفسها، لافتاً إلى أن ظهور الموضة لا ينفصل عن الثورة الثقافية التي تبلورت في منعطف القرنين الحادي والثاني عشر، خصوصاً في طبقة الأمراء، ومع الإعلاء من قيم البلاط التي شكلت طفرة في الشعر بالرقة المرهفة، وأيضاً تحديث نموذج حياة الفرسان، أضيفت معايير أخرى إلى الاحتياج التقليدي للقوة، على رأسها معايير اللغة والصفات الأدبية، والعلاقة المثلى مع المرآة... فالموضة انبثقت من الجهد المتأني لحضارة الأخلاقيات والمتع، بالتوازي مع الولع بالأشياء الجميلة والأعمال الفنية.
ويتابع المؤلف موضحاً أن ظهور الأزياء في العصر الحديث بدأت فيه حقبة جديدة في الفنون الزخرفية التي انتشرت في كل المجالات، مثل فن العمارة والمنمنمات القوطية الأنيقة، وتغير ألوان الملابس للرجال والنساء، وفنون تصفيف الشعر للنساء، وغيرها من الأشياء التي انعكست على أساليب وطرائق العيش والحياة.
والطريف في هذا الكتاب الشيق أنه لا يتعامل مع الموضة كظاهرة عابرة، فهو يؤصل لنشأتها كظاهرة وحاجة فطرية بشرية، كما يرصد تطورها كأسلوب وعلم، يتقاطع ويشتبك مع كل مقومات الثقافة والفن والحياة. وعلاوة على كل هذا، ينظر إلى الموضة كمسرح تحولات لإغراءات الحياة، وهي إغراءات لها فلسفتها وجدلها الخاص، ويكمن هذا الجدل في أنها تزول لتتجدد، لتبقى شاهداً على ذاكرة وأحلام وتاريخ. كما يحلل المؤلف حيوية هذا الجدل من زوايا توغل الموضة في حياة الإنسان، فغوايتها لا تنفصل مثلاً عن غواية الحرية والديمقراطية، وإيقاعاتها معقدة ومتنوعة، بحسب طبيعة الدول والعصور، ومنظومة الأعراف والتقاليد الخاصة، فالموضات تتعدد بطبيعة المؤنث والمذكر، والظروف الملائمة لفكرة الاستمرار، وخلق فضاءات محتملة ومغوية لفكرة الجمالية التي تنشدها الموضة، من الأرستقراطية إلى الشبابية، وغيرهما من الطبقات.
ويركز الكتاب على الإعلام، مشيراً إلى أنه، بما يملكه من تنوع وجاذبية ودعاية، يشكل نقطة التقاء خصبة بين الثقافة والموضة، بين طابع احتمالي ونسبي تمثله الأولى وتقنيات دعائية، تؤثر في قلب الاستهلاك الثقافي، بداية من صناعة الكتاب والأغنية والموسيقى والفيلم، وما تحمل كل هذه العناصر من نشوة التحول والفروق الطفيفة، والمخاطرة في الاستمرارية أحياناً، من أجل توكيد ارتباط قد يكون لحظياً بين قيم الحداثة والتجريب، وهي قيم لا تخلو من التأثر بمعايير السوق المستهلك، فالكتب لا ينطبق عليها ما يرتبط بالسينما أو الأسطوانات، وهو ما يلخصه الكتاب قائلاً: «إننا نشهد هنا ظاهرة تدل على الزوال أكثر من أي وقت آخر».
ويشير الكتاب إلى أن خصوصية الإعلام تكمن في فردنة الضمائر، وتفريق الهيئة الاجتماعية التي لا تحصى، مؤكداً في هذا السياق على أن الأنظمة الثقيلة لا تكف عن فقدان سلطتها، خصوصاً «أن الإعلام أصبح عاملاً محدداً في سياق أنظمة الوعي الكبيرة التي تصاحب الثورة المعاصرة في المجتمعات الديمقراطية، ومن خلال منطق الحدث الواقعي، حيث لا يكف الإعلام بدوره في هذه المجتمعات عن الحد من تأثير التطلعات العقائدية، إنه يصطنع إدراكاً غريباً أكثر فأكثر عن التفسيرات الدينية للعالم، وهذا ليس فقط بواسطة الأخبار اليومية المقسمة والمتقطعة والدقيقة، لكن أيضاً بواسطة انحراف كل هذه الإصدارات، حيث يتدخل الخبراء، ورجال العلم، ومختلف المتخصصين، ويشرحون بطريقة بسيطة ومباشرة للجمهور الحالة النهائية للتساؤلات». وهنا، يلفت الكتاب إلى أن وسائل الإعلام تسير نحو ما يسميه «السحر المتميز» للموضوعية الوثائقية والعلمية؛ إنها تنسف التفسيرات الشاملة للظواهر لصالح تسجيل الأحداث، وتحويلها إلى وضعية سائدة.
ويتابع الكتاب، مؤكداً أن هذا يحدث، على الرغم من أن الآيديولوجيات الكبيرة تميل إلى التحرر من الواقع الفوري المفترض والمضلل، مستخدمة «قدرة المنطق التي لا تقاوم»، والإجراءات الصارمة للحسم، رداً على التفسيرات النهائية الناتجة عن المقدمات المطلقة، وذلك على عكس الإعلام الذي يقدس التغيير التجريبي، النسبي، العلمي، مستهدفاً قليلاً من التعليقات، كثيراً من الصور، قليلاً من التركيبات النظرية، كثيراً من الأحداث، قليلاً من الوعي، كثيراً من التقنية.
ويخلص ليبوفتسكي في هذا الصدد إلى أن زيادة البرامج والقنوات الفضائية الإعلامية، وفي ظل الاتساع الهائل في مملكة الموضة، لم تستطع بعثرة أذواق الأشخاص، وتحريك أهواء الاستقلالية الخاصة، ما يستدعي على الجانب الآخر طرقاً راديكالية معاكسة، بعيداً عن تقديم «الواقعية الملتهبة»، تحت منطق إغواء أو إلهاء الجمهور، مشيراً إلى أنه من أجل تعقب مشرق للعالم، لا بد أن تتجرد وسائل الإعلام من حظوة روح النظام، لكي تشيع حساسية الجمهور للرؤى المجمعة للعالم، وظهور روح واقعية منفتحة، مأخوذة بالوقائع، بالمباشر، بالتجربة المعاشة، حتى لا تختلط بالشهوة البراقة المخادعة للإعلام، في فضاء موضات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية لا تخلو من توجهات آيديولوجية معينة تعوق فكرة الحرية، وكما يقول الكتاب: «لو تكلمنا قليلاً في الملاهي الليلية، لا يعني ذلك أنه ليس لدي الناس ما يقولونه لبعضهم، بل يعني رغبة متزايدة في إطلاق مكبوتاتهم، في الشعور بأجسادهم، في التحرر من القوانين الجبرية للخرافة، والتبادل البين إنساني».
الموضة شاهدة على ذاكرة وأحلام وتاريخ
جيل ليبوفسكي استقصى جذورها الثقافية في كتاب أصدره المركز القومي للترجمة


الموضة شاهدة على ذاكرة وأحلام وتاريخ

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة