لم يُصنِّف الروائي العراقي رياض رمزي كتابه الجديد الذي يحمل عنوان «سَلاماً للغربة... وداعاً للوطن»؛ إذ يصفه بـ«التأمّلات» تارة، و«الشهادة» تارة أخرى. وثمة فرق واضح بين التسميتين؛ فالتأمّل بالمعنى المُعجمي يعني «التروّي أو التبصّر في موضوع ما، والاستغراق فيه بهدف التحقق والاستيقان». أما «الشهادة الأدبية» فهي رواية حدثٍ ما بُغية نقله إلى الآخرين، شرط أن تكون آلية النقل صادقة وخالية من التزوير أو التحريف. غير أن ثيمة الكتاب في مجملها تدور في فلك التأمّل، والاستبطان، وإطالة النظر في المِحن الكثيرة التي ألمّت بالعراق والعراقيين أرضاً وشعباً؛ الأمر الذي يوسّع أفق التأمل، ويضيّق فرص الشهادة إلى أدنى منسوب من البوح المستتر الذي جاء على لسان راوي النص وكاتبه.
لا يدّعي رياض رمزي أنه «مؤلِّف» هذا النص السردي التأملي؛ لأن مهمته الرئيسية كانت تقتصر فقط على «عرض حال» بعض المفجوعين العراقيين، سواء من أصدقائه القدامى أو المُحدثين الذين تعرّف إليهم في مقهى وايتليز Whiteleys في قلب لندن. يطرح المؤلف الوسيط الذي يروي أفكار الآخرين عدداً من الأسئلة الجوهرية التي تتقصى أسباب الخراب الذي حلّ بالعراق منذ ستة عقود، ويلقي باللائمة على الأنظمة العسكرية التي تعاقبت على حكم البلاد، مروراً بهيمنة الطاغية، واستدعاء المحتل، وانتهاء بالطائفيين الذين يشبِّههم بأصحاب «القمصان السوداء» الذين هيّجوا قفائر النحل، وأشغلوا الجميع بخطر الدبابير ليستأثروا وحدهم بقرص العسل، ويقلبوا حياة العراقيين رأساً على عقب، مُجبرين إياهم على العيش في الماضي وتقديسه بشكل أعمى يُصادر فيه عقولهم وقلوبهم في آنٍ معا.
يتخذ الكاتب من رواية «الطاعون» لألبير كامو ذريعة ليثير من خلالها حفنة من الأسئلة المتتابعة التي تؤرقنا جميعاً بعد أن يحيطنا علماً بأن أهل وهران قد واجهوا جائحة الطاعون بعدم الاكتراث، والهرب من الواقع، فما هو الطاعون الذي اجتاح العراق؟ ثم تأتي الإجابة على شكل احتمالات كثيرة يجب أن ندرسها ونحللها جيداً؛ لأنها تترجح بين «داعش»، والأنظمة العسكرية، والنخب السياسية، والطُغِم العشائرية، والاحتلال الذي جاء بالطائفيين الذين يعيشون في الماضي، ويكرّسون ثقافة الحزن، ويناصبون الفرح عداءً مُستحكماً. وبسبب كثرة الطواعين تراجع العراقيون إلى الوراء، وشعرَ اليساريون بتفاقم وتيرة هذا التراجع المخيف.
يقترح الراوي أن ندرس ظاهرة الحزن التي انتشرت في الشوارع والميادين العراقية كما درسَ باختين الضحك في الساحات العامة؛ لأن الأمم العظيمة تبني هويتها الوطنية على مفاهيم حضارية وقضايا تنويرية شاملة، حيث عوّلت أميركا على الديمقراطية، وراهنت الصين على الثورة الاشتراكية، في حين وضع الفرنسيون ثقتهم في تراث الثورة الفرنسية، فلماذا يغامر «الطائفيون» العراقيون في بناء هويتهم على قضية تاريخية تخص حدثاً واحدا لا غير؟
ثمة سؤال خطير في هذا الكتاب مفاده: «لماذا لا ينتمي الطائفيون إلى البلد وإلى عاصمته؟ ألأنهم لا يستمعون لأغاني بلادهم؟» (ص35)؛ فالوطن من وجهة نظر المؤلف «تصوغهُ أغانٍ وأشعارٍ وحكاياتٍ مرويّة» (ص36)، ويورد مثالاً واقعياً على الطفلة ميرنا حنّا التي غنّت فأصغى إليها أكثر من 30 مليون عراقي، ليس لأن حنجرتها ذهبية، وإنما لأن غناءها يعزّز الانتماء إلى الوطن. إن تضييق الخناق على الغناء، وتحريم الموسيقى، ومنع الحُب، وتجريم المزاح يفضي من دون شك إلى مجتمع يهيمن عليه الحزن، وتخيّم عليه الكآبة، علماً بأن المبدعين هم الذين يصنعون شخصية الأمة، ويصوغون ذاكرتها وعقلها الباطن.
يستعرض الراوي أسماء الكثير من الأدباء والفنانين والمفكرين الفرنسيين أمثال هيغو، زولا، فلوبير، بلزاك موباسان، رودان، سارتر، بياف ورامبو، هؤلاء جميعاً وآلاف من صنّاع الثقافة والفن والفكر لا أحد يسأل عن عترتهم، أو إلى أي طائفة ينتمون؟ لا يختلف الأمر كثيراً في روسيا التي تفخر بدستويفسكي، وتولستوي، وتشيخوف، وبطرس الأكبر، وحتى المعارضون لنظام الحكم الروسي مثل سولجنستين وألكسندر هرزن اللذين أعادا اكتشاف روسيتهما من جديد بما نهلاه من ثقافة غربية؛ فلامسا وجدان الأمة الروسية. تُرى، هل يمكن تربية العراقيين على رموز الثقافة العراقية مثل المتنبي، السيّاب، البياتي، جواد سليم، يوسف عمر، مسعود العمارتلي، شمال صائب، علي مردان إلى آخر هذه القائمة النيّرة الطويلة التي تفضي إلى هُوية وطنية تسمح للعراقيين بالتصدي للأخطار المُحدقة بالوطن الجريح الذي ينزف منذ ستة عقود في أقل تقدير.
ما الذي يميّز بغداد الآن عن غيرها من الحواضر والمدن؟ وما أسطورتها التي تدلّ عليها؟ ففي موسكو هناك البولشوي ومايا بليستسكايا، أعظم راقصة باليه في القرن العشرين، وفي باريس هناك اللوفر وموباسان، وفي القاهرة هناك نجيب محفوظ وأم كلثوم. ماذا في بغداد الآن غير الكآبة والحزن الثقيل؟
يُعتبر مقهى «الوايتليز» وطناً مصغراً للاجئين العراقيين الذي يقارعون فكرة «السقوط في المنفى» كما أسماها الراوي، ففيه يستعيدون ذاكرتهم القريبة، ويستمعون إلى أغاني وحيدة خليل، وسليمة مراد، وناظم الغزالي ويسترجعون قصص حسون الأميركي، حجي راضي، عدنان القيسي وغيرهم من العراقيين الذين خلّفوا أثراً ما في ذاكرة العراق الحيّة. يرتاد هذا المقهى أناس كثيرون، لكن الراوي اختار أربعة نماذج عراقية مناضلة ومنفية أحبت العراق، وتشردّت من أجله، لكنها ظلت معتزة بكرامتها، ومحتفظة بإنسانيتها. هذه الشخصيات الأربع هي سعدي، حسين، فؤاد وجبار يأتون مذعورين، لكنهم ما إن يلجوا إلى «وايتليز» حتى يشعروا بالهدوء والأمان. أربع شخصيات من مستويات ومشارب ثقافية متنوعة تجمعهم السياسة والمنفى وحب الوطن، فسعدي عبد اللطيف قارئ نهم ومترجم جيد يجد نفسه في كل الثوار المهزومين الذين قالوا إن المستقبل للاشتراكية. أما حسين مزعل، فهو بطل ليس من هذا الزمان، يكتب نقداً رفيعاً ولا يحب المجاملة؛ لأنه ليس مهووساً بذاته. يعتقد أن سقوط بغداد قبل 758 سنة بسبب خيانة العلقمي، الوزير الأول الذي تخابر مع المغول، وصار أشبه بأبي رُغال الذي دلّ إبرهة على الكعبة. يتساءل مُحقاً: «هل أن الأحفاد من الزمن الحالي ساروا على نهج جدهم؟» (ص120). كما يعتقد حسين، مثل الراوي تماماً، بأن الأموات هم الذين يحركون التاريخ في هذه البلاد.
فؤاد كرجي هو النموذج الثالث الذي طُرد من العراق فوجد نفسه في لندن وحيداً ومطلّقاً ومنفياً. وعلى الرغم من كل المصائب التي مرّ بها، لا يزال فكهاً وساخراً، لكنه تعلّم أن يتماسك كي لا يتفتت عند أعتاب الشيخوخة.
أما الشخص الرابع والأخير فهو جبار دبيّس المنقطع إلى «السبايات» والطقوس الكربلائية، لكنه انبهر باليسار العراقي فانتمى إليه بحماس كبير جعلنا نشك، نحن القرّاء، في طبيعة إيمانه الديني من جهة، ودرجة ولائه السياسي من جهة أخرى.
نخلص إلى القول بأن الفكر النقدي الحرّ الذي يعوّل على العقل البشري المتنوِّر هو الذي يصنع الأمم المتحضرة، وأن الأدباء والفنانين والمفكرين هم الذين يؤسسون الهُوية الوطنية، ويخلقون الذاكرة الجمعية للبلد، وليس الطُغم العسكرية والعشائرية والدينية التي أرجعت العراق إلى الحقب المظلمة؛ لأن قادته الجدد لا يُحسنون إلا السير إلى الوراء.
أصدر رياض رمزي خمسة كتب، أبرزها رواية «التيس الذي انتظر طويلاً» و«الديكتاتور فناناً» اللذين لقِيا صدى طيباً بين القرّاء العراقيين والعرب.
المبدعون حين يصنعون شخصية الأمة
مأساة العراقيين في «سَلاماً للغربة... وداعاً للوطن»
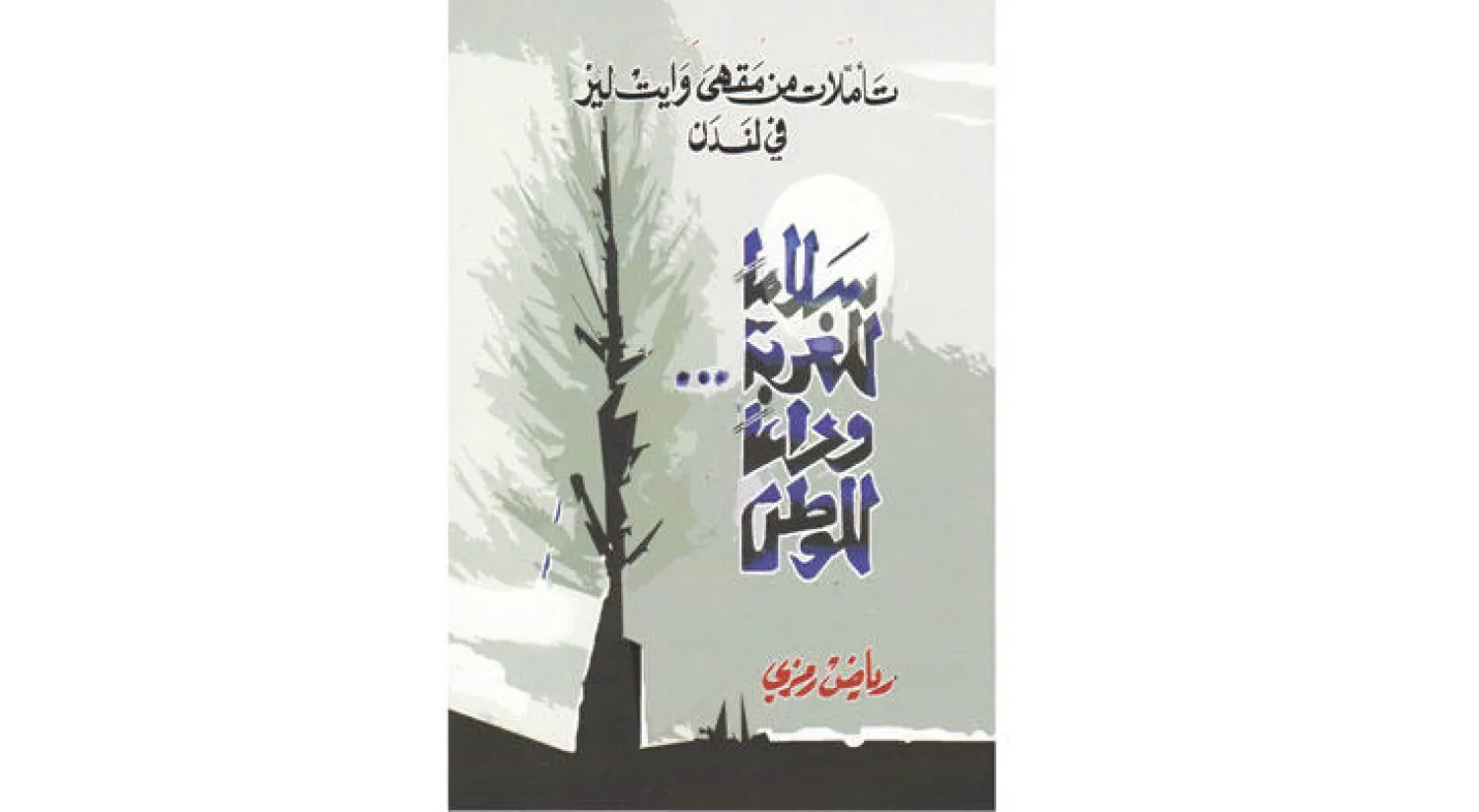

المبدعون حين يصنعون شخصية الأمة
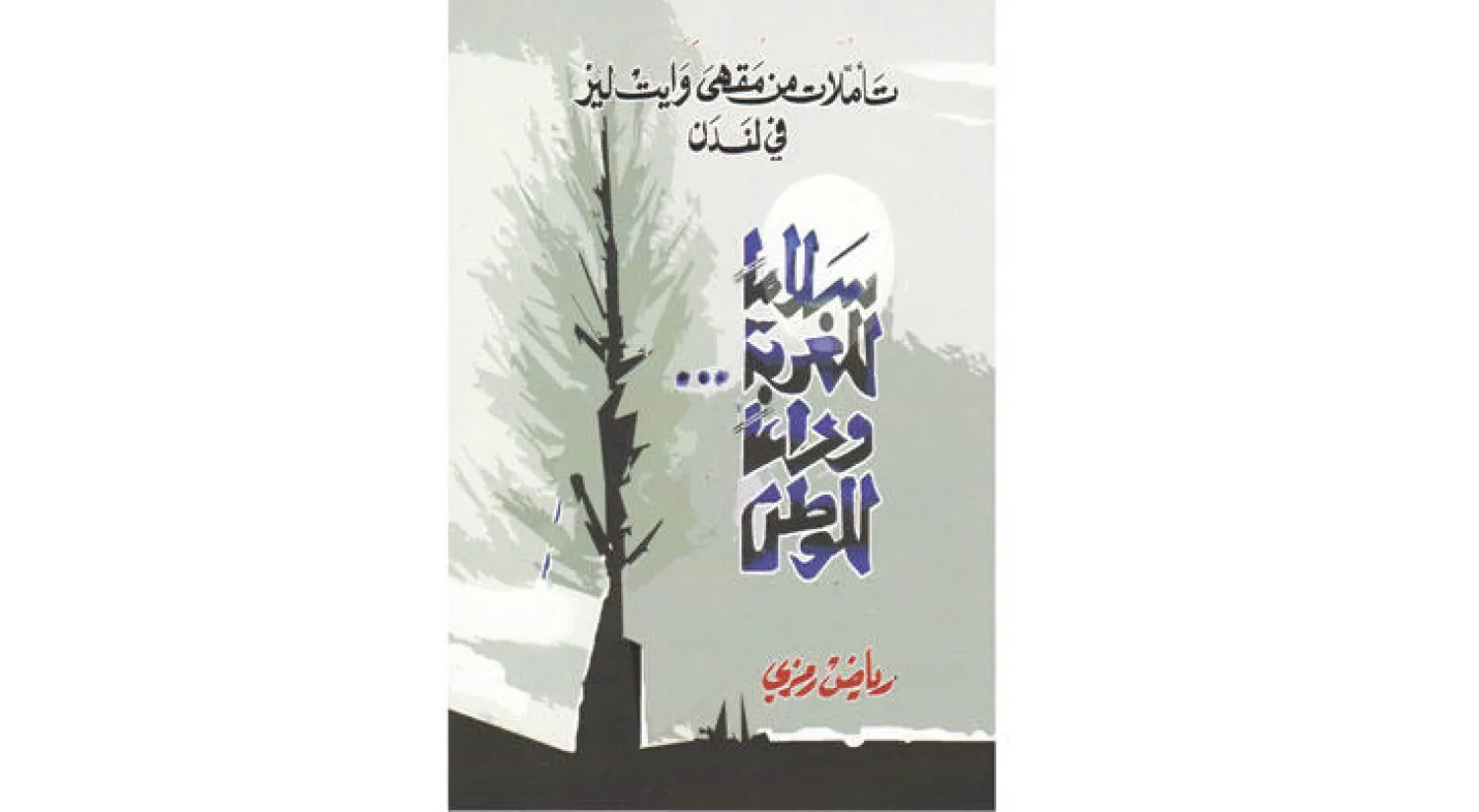
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة








