في عام 1922، عندما صعد موسوليني إلى السلطة في إيطاليا، كانت الفاشية تبدو لأوّل وهلة مشروعاً لاستعادة النظام بعد فوضى الحرب العالمية الأولى؛ لكنها سرعان ما كشفت عن وجهها الحقيقي: سيطرة مطلقة باسم المصلحة العامة. اليوم، وبعد قرنٍ كامل، يعود السؤال ذاته بثوب جديد: هل نحن على أعتاب فاشية أخرى؛ «فاشية رقمية» تتغذّى من الخوارزميات والذكاء الاصطناعي؟
قد يبدو السؤال مبالغاً فيه؛ لكنّ نظرة واحدة إلى ما يحدث في «وادي السيليكون» تكفي لتولّد أعلى أشكال القلق. الشركات العملاقة، التي كانت تُبشّرُ بحرية الوصول إلى المعرفة إلى حدود تنشأ معها مشاعية معرفية مجانية، باتت هي ذاتها تتحكم في المعرفة؛ صناعةً ومناقلةً وترويجاً لما يرادُ وما لا يرادُ، والمنصّات التي رفعت شعار «تمكين الأفراد معرفياً» أصبحت تحدّدُ ما نقرأه، وما نعرفه؛ بل وحتى ما نعتقده.
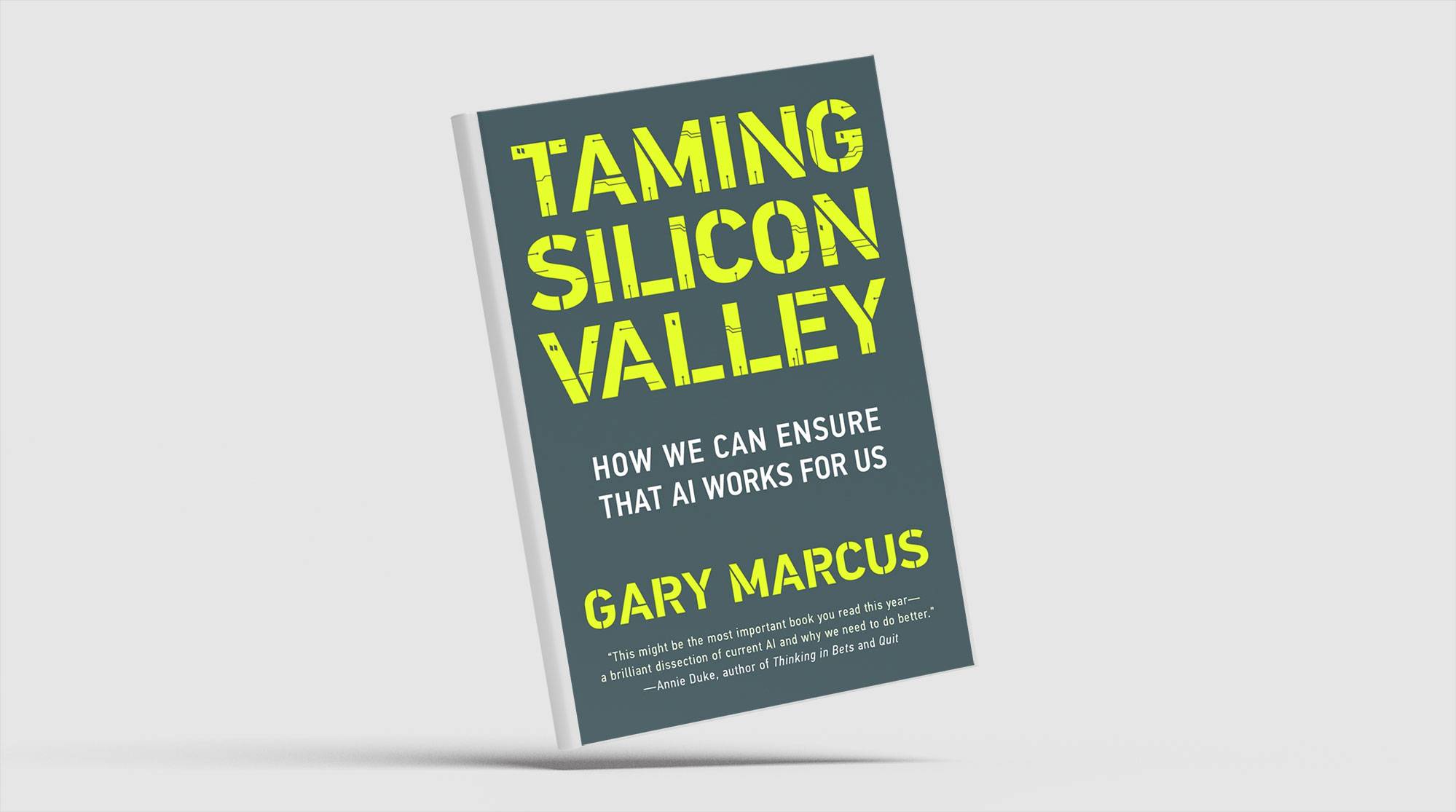
في كتابه الأخير «ترويض وادي السيليكون (Taming Silicon Valley)»، المنشور أواخر عام 2024، يحذّر الباحث الأميركي غاري إف. ماركوس (Gary F. Marcus)، (وهو مختصٌّ في علم النفس واللغويات والذكاء الاصطناعي، ويعمل أستاذاً في جامعة نيويورك، وله كثير من الكتب المهمّة في هذه المجالات) من تبعات هذا الانجراف الهادئ نحو شكل جديد من السلطة... ليست سلطة عسكرية ولا آيديولوجية؛ بل «سلطة رقمية» تُمارَسُ من وراء الشاشات. يعتقدُ ماركوس أنّ الذكاء الاصطناعي - كما يُمارَسُ اليوم - لم يعُدْ محض علم أو أداة أو ثورة تقنية جديدة؛ بل صار نظاماً اجتماعياً واقتصادياً متكاملاً يصوغ سلوك البشر ويعيد تشكيل المؤسسات والمجتمعات. إنّه عصر نهضة جديدة بكلّ المقاييس والاعتبارات.
يؤكّدُ ماركوس في كتابه أنّنا نشهدُ اليوم انتقالة جذرية من «الفاشية الكلاسيكية» إلى «الفاشية التقنية (Techno-Fascism)». «الفاشية القديمة» كانت تعتمد على السيطرة المادية: الشرطة، والجيوش، والإعلام الموجّه، والخطابة. أما «الفاشية التقنية» فتعمل بطريقة أعلى أناقةً، وأشد خبثاً في الوقت ذاته. إنها لا تفرض عليك ما تفعل؛ بل تدفعك إلى فعله دون أن تدري.
حين تقترح عليك الخوارزمية ما «قد يعجبك»، فإنها في الحقيقة لا «تقترح»، بل توجّهك، وحين تجمع البيانات عنك لـ«تخصيص تجربتك»، فإنّها في الواقع تكتب سيرتك النفسية بدقةٍ تفوق ما تعرفه أنت عن نفسك. نحنُ نعيش لحظة مفارقة: لم يَعُد الإنسان يواجه الاستبداد في الشوارع؛ بل في جيبه: في هاتفه، في ساعته الذكية، وفي كومبيوتره اللوحي أو المحمول. الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرّد أداة للراحة أو الكفاءة؛ بل تحول إلى جهازٍ سياسي بامتياز: كلّما زادت قدرته على التنبؤ، زادت قدرة مالكيه على التحكّم فينا.
ماركوس يسمّي هذا الوضع «اختطاف المستقبل»؛ إذ يرى أنّ حفنة من الشركات - بقيادة أباطرة التقنية الرقمية: «غوغل»، و«ميتا»، و«مايكروسوفت»، و«أوبن إيه آي (Open AI)» - تمسك اليوم بالمفاتيح الجوهرية للمستقبل البشري على مستويات اللغة، والمعرفة، والقرار. هذه الشركات لا تمثّلُ «السوق الحرة» كما تدّعي؛ بل تمثلُ نوعاً من «الاحتكار العقلي العالمي». يصف ماركوس «الأباطرة الرقميين» بأنّهم «الفاشيون الجدد»: «نخبة الخوارزميات». ويمضي في الإيضاح بقوله إنّ «الفاشي القديم» كان يرفع شعارات القوة والوحدة القومية؛ أما «الفاشي الجديد» فهو يرتدي قميصاً رمادياً ويحمل بطاقة موظف في «وادي السيليكون»... إنه مبرمِج، أو مدير منتج، أو مستثمر مغامر؛ لكنّه في كلّ أشكاله الوظيفية يعتقد أنّه يصنع المستقبل؛ غير أنّه في الواقع يعيد صياغة الحاضر على صورته الخاصة.
يصف ماركوس «الأباطرة التقنيين» بأنّهم «الكهنة الجُدُد» الذين يملكون أسرار «الكود (Code)» والمعرفة التقنية... هم مَنْ يقرّرون شكل الذكاء الاصطناعي، والقيود المفروضة عليه، وما إذا كان يجب أن يخضع للرقابة أم لا. بهذا المعنى نحن أمام طبقة جديدة؛ طبقة من «الفاشيين التقنيين» الذين لا يحتاجون إلى رفع شعارات أو استعراض عضلات، يكفيهم أن يملكوا البنية التحتية الرقمية للعالم. يصف ماركوس الأمر بطريقة درامية مثيرة حينما يوردُ في كتابه أنّ «وادي السيليكون» استحال إلى ما يشبه «الفاتيكان الجديد للتقنية»: يملك العقيدة (الذكاء الاصطناعي)، والطقوس (الكود)، والمؤمنين (المُسْتَخْدِمين)، والقدّيسين الجُدُد (روّاد الأعمال)... لكنْ بخلاف الفاتيكان؛ لا يخضع أحدٌ فيه للمساءلة الأخلاقية.
ماركوس يرى أن هذه «اللامساءلة» هي جوهر الخطر؛ فحين تصبح الخوارزميات أذكى من البشر، ويُرفَعُ شعار «الثقة بالتقنية»، فمن ذا الذي بمستطاعه تقديم ضمانة مؤكّدة أو مقبولة بأنّ التقنية نفسها لا تنزلق إلى «فاشية خفية»؟
تعمل «الفاشية التقنية» بواسطة الوسائل التقنية الناعمة والأنيقة... ما يميّزُ «الفاشية التقنية» هو أنها لا تأتي بالبنادق، بل عبر «الواجهات الحاسوبية».
هي لا تمنعك من الكلام، بل تغرقك بالضجيج حتى لا تعود تعرف ما تقول.
هي فاشية لا تحتاج إلى الرعب، بل إلى الإدمان.
في هذا العالم تُصبح البيانات بديلاً للدم، والخوارزميات بديلاً للقوانين.
حين يقرر الذكاء الاصطناعي من يُوظَّفُ، ومن يُقصى، ومن يُراقَبُ، فإننا نعيش بالفعل شكلاً من أشكال «الحكم التقني (Technocracy)» الذي قد يتحول بسهولة إلى «فاشية» حين تُرفَعُ عنه الضوابط الأخلاقية والقانونية.
لعلّ من أهمّ ما ورد في كتاب ماركوس أنّه يقدّمُ قائمة من «12 خطراً فورياً» لـ«الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)»: من نشرِ المعلومات المضلّلة، إلى فقدان السيطرة على المحتوى، ومن تشويه الحقيقة إلى الترويج لأنساق آيديولوجية مشخّصة دون سواها؛ لكن خلف هذه المخاطر التقنية يكمن خطر أعمق: تحويل «الإنسان» نفسه إلى «بيانات قابلة للمعالجة».
حين يُختزَلُ الوعيُ إلى خوارزمية، والمشاعرُ أنماطاً، والعلاقاتُ إلى إشعارات، نكون قد دخلنا فعلاً «عصر ما بعد الإنسان»؛ العصر الذي تكتب فيه الآلة ميثاق الإنسانية من جديد.
«الفاشية القديمة» كانت تعتمد على السيطرة المادية: الشرطة والجيوش والإعلام الموجّه والخطابة... أما «الفاشية التقنية» فتعمل بطريقة أعلى أناقةً وأشد خبثاً
> عنوان كتاب ماركوس «ترويض وادي السيليكون» يبدو أقرب إلى صيحة استغاثة، منه إلى اقتراح أكاديمي. إنه يدعو إلى استعادة السلطة الأخلاقية من أيدي الشركات التقنية عبر سياسات واضحة للشفافية والمساءلة وحقوق البيانات. الأهمّ من ذلك أنه يدعو إلى وعي جماعي؛ فالتقنية لا تُروَّضُ بالقوانين وحدها، بل بوعي الناس الذين يستخدمونها. المسألة ليست حرباً بين البشر والآلات؛ بل بين مجتمعات بشرية تؤمن بالإنسان، ونُخب تقنية تؤمن بالفائقية التقنية حدّ جعلها الآيديولوجيا الحاكمة للعصر المقبل. ماركوس يذكّرُنا بأنّ السؤال لم يَعُدْ: «هل يمكننا تطوير ذكاء يفوق البشر؟»، بل: «هل يمكننا تطويرُ ذكاء يخدم البشر؟». «الفاشية التقنية» تبدأ حين نخلط بين الذكاء والسلطة، وبين الكفاءة والعدالة، وبين المعلومة والحقيقة.
> نحن عند خطّ الشروع فقط، ولم نشهد تغوّل عصر «الفاشية التقنية» بعدُ. يؤكّدُ ماركوس أنّ الذين يظنون أننا في منتصف الطريق يخطئون التقدير: نحن في البداية فقط. «الفاشية التقنية» ليست مشروعاً معلناً، بل تحوّل زاحف يحدث بصمت. كل تحديث جديد؛ كل تطبيقٍ «مجاني»، كل ميزة «مخصصة لك»، إنّما هي خطوة صغيرة في طريق بناء نظام شامل من المراقبة والضبط الناعم في «إمبراطورية الفاشية التقنية».
> لكنّ هذا المستقبل ليس قدَراً محتوماً لا مفرّ من مواجهته... يكتب ماركوس في خاتمة كتابه: «لم يزلْ لدينا خيار. يمكننا أن نعيد رسم العلاقة بين التقنية والمجتمع، شريطة أن نعترف أولاً بأننا فقدنا السيطرة». ترويض «وادي السيليكون» لا يعني كراهية التقنية، بل تحريرها من عبادة السوق، وألا تتحول القيم إلى كُود، وألا يتحول الإنسان إلى متغيرٍ في معادلة إحصائية.
> «الخوارزميات الحاسوبية» في عصرنا هذا هي التي تُسيّر العقول. نعم، قد لا نسمع خطاباً فاشياً صاخباً؛ لكننا نعيش ضمن نظامٍ يحدّد ما نراه وما نفكّرُ فيه وما نرغب به. «الفاشية التقنية» ليست ضجيجاً، بل صمتٌ منظمٌّ ومبرمَج. مقاومة هذا الشكل الجديد من السيطرة لا تكون بالهروب من التقنية، بل بفهمها، وتملكها، ومساءلتها. علينا أن نتذكّر أنّ كل خوارزمية كتبها إنسانٌ يمكن تغييرها. لكن أول خطوة في المقاومة هي الاعتراف بالحقيقة: «عصر الفاشية التقنية» قد بدأ؛ لكنه لم ينتصر بعد.



















