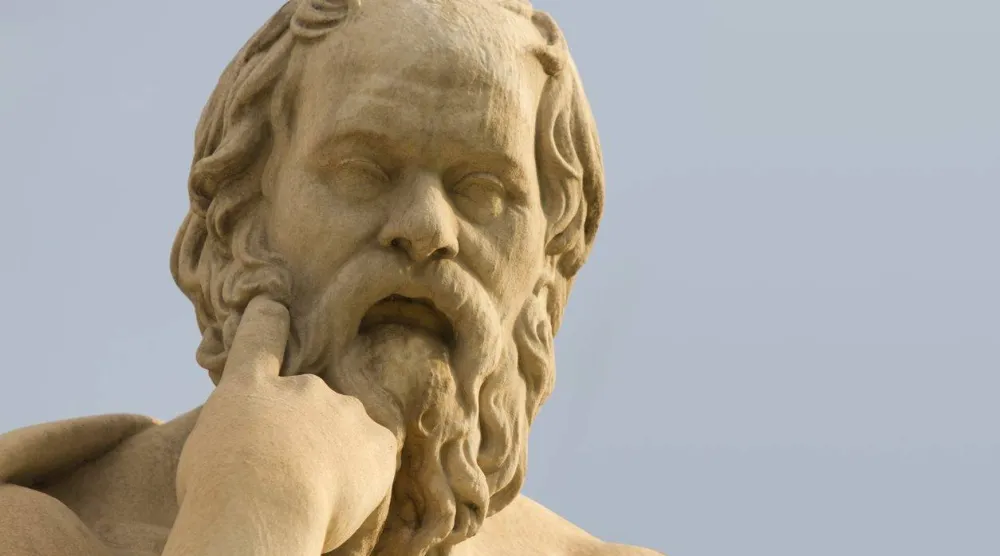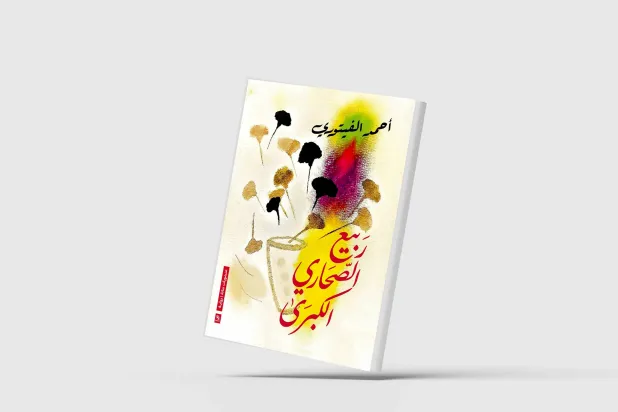يتنوع النِّتاج الأدبي للكاتبة الفلسطينية ليانة بدر ما بين الرواية والقصة والشِعر، علاوة على مُنجزها السينمائي، وقد حازت أخيراً على «جائزة فلسطين للأدب». ومن أبرز أعمالها: «الخيمة البيضاء»، و«نجوم أريحا»، و«شرفة على الفاكهاني»، و«ورد السياج».
هنا حوار معها حول مشروعها الأدبي، ورؤيتها للكتابة...
> في رواية «ورد السياج» نلمح تداخلاً بين الحاضر والذاكرة، وتعدداً في الأصوات السردية. كيف رسمتِ خريطتك لبناء شخصيات قادرة على التعبير عن تجربة الشتات الفلسطيني بكل تشعباتها؟
- أردت ان تكون رواية «ورد السياج» معبرة عن الحياة الفلسطينية خارج وداخل فلسطين، ووددت أن أُظهر التضحيات الجمة والأهوال التي عاشها فلسطينيّو المخيمات خارج الوطن، وهذه مسألة يتم التغافل عنها عادة، وكأن النضال مقتصر على الفلسطينيين داخل الوطن. لقد بذل الناس في الشتات تضحيات كبيرة، وعاشوا أهوالاً ومجازر، مثل تجربة الحصار في مخيم تل الزعتر ومجزرة صبرا وشاتيلا خلال الحرب الأهلية اللبنانية وما بعدها.
كما وددت ان أرصد مرحلة حافلة بتضحيات النساء وصعود إمكاناتهن وقدراتهن على المساهمة في الحياة الفلسطينية بكافة تجلياتها. كانت هناك مفاهيم أخرى، تسمح للعمل التطوعي النسائي بأن يتحمل مسؤوليات جمة في ترميم المجتمع ومساعدة الناس، وهو ما قضت عليه التنظيمات غير الربحية فيما بعد.
ولتغطية مرحلة واسعة بين 1977-1982، وهي ما اختتمت بالخروج من بيروت، كان عليّ متابعة شخصيات عديدة مختلفة الطباع والمشارب، وهكذا وُجد تعدد الأصوات في الرواية.

> هل ترين أن الذاكرة يمكن أن تكون «مساحة للكتابة» تعيد صياغة الحاضر بشكل مختلف؟
- الذاكرة هي الرافعة التي تحمي وجودنا من انعدام الأمل. حينما نحافظ على ذاكرتنا، فإننا نساعد وجودنا على الاحتفاظ بالحب والحنان والتوقعات بحيث لا نقع فريسة الخيبة والنسيان.
وعلى الصعيد الجماعي لم تتح الفرصة لكتابة تاريخنا الفلسطيني روائياً، وما أشتغل عليه في معظم كتاباتي هو متابعة التاريخ العام عبر التاريخ الشخصي لبشر تعرفت عليهم، وكنت على ألفة ومعرفة عميقة بهم. هذا هو تاريخ الأدب على كل حال، نحن نسجل ما نحس به ومن نتعرف بهم، ونحاول الربط بين هذا التاريخ الروائي المنفرد وبين تاريخ المجموع.
> تمثل أعمالك مزيجاً بين التوثيق التاريخي والصوت الذاتي. إلى أي مدى ترين أن حضور التجربة الذاتية عنصر أساسي في مشروعك الأدبي عموماً، وبرز بشكل خاص في «شرفة الفاكهاني» عن تجربة بيروت؟
- نعم، إن هذا الدمج بين التاريخ الشخصي والعام هو الذي يصنع الكتابة في حالتنا. لا يمكن للإنسان الفلسطيني أن يهرب من التاريخ الاستعماري العنيف الذي صنع حاضره السياسي المكون من اللجوء والفقر. لقد أردت أن أظهر جمال الحياة الإنسانية التي يعيشها الناس بتضامنهم وارتباطهم بالحرية والتوق إلى الانتماء. وفي «شرفة على الفاكهاني» أثارت انتباهي شخصيات النساء اللاجئات في المخيمات، ووجدت أنهن ما زلن يمتلكن اللغة العفوية الأولى التي جلبنها من الجليل. وهكذا خضت مغامرة محاولة اكتشاف هذه اللهجات الطافحة بالأمثال الشعبية والسخرية والتضامن. وعندما لامني صديق ناقد على الكتابة عن الحاضر أيامها، وكنا ما زلنا في بيروت قلت له إن الحاضر سوف يتحول إلى ماضٍ وإننا سنتذكر المرحلة عبر هذه الشخصيات، وهذا ما حدث فعلاً.
> كيف تساعدك الكتابة على استعادة تجربتي الحرب والمنفى؟
- الكتابة أرشيف حي لتجربة الوطن والمنفى، فقد أتيح لي التنقل بين العديد من الأمكنة ومشاهدة التجارب والخبرات التي تحدث بها. وُلدت في مدينة القدس وطفولتي مقدسية مدينية، ثم أتيح لي الاستقرار في أريحا خلال العام الدراسي بسبب وجود عيادة أبي الطبيب بها، وكانت مدينة صغيرة في الغور محاطة بحزام كبير من المخيمات التي تحوي عشرات الآلاف من لاجئي 1948، وفي العيادة استمعت إلى عشرات القصص والحالات التي تطفح تعاسة بسبب اللجوء وفقدان الوطن.
لكن حرب 1967 حوّلتني بدوري إلى لاجئة بعد أن ذهبنا إلى عمّان ولم نستطع العودة بسبب احتلال الضفة الغربية. ثم عشت في بيروت 10 سنوات، وفي دمشق 5 بعد سقوط بيروت، ثم 7 سنوات في تونس.عايشت معارك الحرب الأهلية اللبنانية بكل رعبها ومآسيها، وكنت أكمل امتحاناتي الجامعية فيها على وقع الرعب الذي تسببه أصوات كسر جدار الصوت الذي تصنعه الطائرات الحربية. لقد رأيت ويلات الحرب والإصابات المرعبة التي تسببها القذائف. وما فعلته عبر كتاباتي هو أنني قمت بتحويل حصيلة الرعب والخوف التي لازمتني سنوات طويلة إلى حروف وكلمات وقصص تحكي عما يحدث وعن الناس الذين عرفتهم وسط هذه المصائب.
بشكل عام، لم أكتب إلا ما عشته وما عاشه من هم حولي، ولكني بحاجة إلى سنوات أخرى كي أحكي ما حدث في فلسطين التي عدت إليها عام 1994.
> اتجهتِ في روايتك «الخيمة البيضاء» إلى توظيف تفاصيل الحياة اليومية، من الأغاني إلى مشهد الحواجز، كيف تنظرين إلى التفاصيل العادية واليوميات في مشروعك الأدبي؟
- قبل عودتي إلى فلسطين كنت أشتغل على إكمال تلك المرحلة أدبياً، فقد اشتغلت في رواية «عين المرآة» على الوجود الفلسطيني في لبنان منذ عام 1948 وتتويجه بالحرب التي قادها اليمين المتطرف في لبنان لتصفية مخيم تل الزعتر بكل ما يضمه من تعدد المكونات الإثنية فيه، لم تكن العودة سهلة على الإطلاق، فقد تغيرت فلسطين بعد غيابي عنها أكثر من عقدين، وتغيرت الأشياء كلها التي كنت أعرفها، ولهذا لزمتني الكتابة عن الوضع الجديد الذي لا أعرفه. كتبت مجموعة قصصية آنذاك «سماء واحدة»، ولكنني كنت مرتبكة من تشابكات الواقع الصعب الذي جعل هناك شقّاً عموديّاً بين أهل البلد والعائدين. علماً أنني كنت أنتمي لكليهما. كانت ثرثرات عديدة تنطلق بين هؤلاء وهؤلاء، وأنا محتارة فيما يجري، وأخيراً قررت أن تكون هذه الحيرة هي موضوع روايتي «الخيمة البيضاء»، وأن أواجهها روائيّاً كي أرى إلى أين تنتهي.
> أنتِ لستِ روائية فقط، بل أيضاً شاعرة وصانعة أفلام. كيف يتسلل الشعر والسينما
إلى العمل الأدبي لديكِ؟
- أول كتاباتي كانت الشِعر كما هو تقليدي في ثقافتنا، لكني كرست عملي الروائي والقصصي أولاً حتى لا تختلط الموازين ولكي يكون هناك فصل إيجابي بينهما. كانت فكرة «المهنية» مغرية بالنسبة لي، وهكذا تأخرت حتى نشرت النصوص الشعرية، وحتى الآن ما زال لدي تراكم من عدم النشر، ربما أيضاً لأن دور النشر تبدي استعدادها للنشر الروائي أولاً، لكن الحقيقة أنه في الحياة يختلط الشعر مع السينما، وتنتج عن هذا توليفة مهمة من الأفكار والحركات المثيرة التي تبث الحيوية، سواء في الأفلام أو في المقطوعات الشعرية.
لقد تربيت على حضور الأفلام مع أطفال العائلة الممتدة في القدس وعلى التعليق والاهتمام بكل جديد في العروض، وكنت أظن في طفولتي أنني سأشتغل بطلة سينمائية مثل كثيرين غيري، وهكذا لذت بالشعر وكتابة المذكرات والانطباعات في صباي إلى أن كتبت روايتي الأولى ونشرتها وأنا في عمر مبكر نسبياً.
من ناحية أخرى، كنت حريصة على ألا تتوقف هذه العلاقة بالسينما والشِعر، لذلك قمت بكتابة وإخراج 7 أفلام وثائقية حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات الدولية، وعرضت في مهرجانات عالمية متعددة، إلا أنني أخذت قراراً بالتوقف عن متابعة القيام بالمزيد منها بسبب احتياجي للوقت كي أُكمل المشروع الأدبي الذي أشتغل عليه، وهو كتابة التاريخ الفلسطيني عبر عيون النساء.
إني بحاجة إلى سنوات أخرى كي أحكي ما حدث في فلسطين التي عدت إليها عام 1994
ليانة بدر
> كيف استقبلتِ تتويجك بجائزة فلسطين للأدب؟
- الجوائز هي محض محفزات تشير لنا إلى أننا على الطريق الصحيح، وأنه علينا أن نتابع مهما كلفنا هذا من جهد وتضحيات. في حياة الكاتب كثير من التكريس للعمل، فهناك دوماً أكداس من الكتب الجديدة التي تنتظره كي يقرأها، وعليه أن يكتب ما يخطر بباله فور أن يتبادر إليه كي لا تطير الأفكار وتكف عن التحليق، ولطالما ضاعت أفكار ثمينة لأن الوقت لم يساعد على تسجيلها.
إن الإصرار والمتابعة خصلتان فريدتان تعلمتهما من والدي الطبيب الكاتب والشاعر ورائد دراسات علم الفلك عند العرب القدامى. كان والدي يخبرني أن الخيلاء تقود أصحابها إلى السقوط، أحياناً لا أصدق أن رواية «ورد السياج» قد بدأت كتابتها في التسعينات وأنها لم تصدر إلا الآن، طبعاً لقد أضفت إليها الكثير وذهبت إلى تغطية مرحلة جديدة يعيشها الشعب الفلسطيني حالياً، لم أستطع أن أنساها. ومن فصل واحد كان مكتوباً أنتجت الرواية الحالية، فصولها التاريخية العديدة تُعبر عن مراحل جديدة، ونساء يحاولن التعبير عن أنفسهن خوفاً من محو أصواتهن، كما جرت العادة في كتابات كثيرة.
> ما الذي ما زلتِ تبحثين عنه في الكتابة والفن إلى اليوم؟
- ما زلت أبحث عن فسحة راحة تنتهي بها هذه الحرب الظالمة على شعبنا الفلسطيني في غزة، التي تسببت في قتل عشرات الآلاف من العائلات والنساء والأطفال، هل يمكننا أن نطمح في سلام ما، تتوقف فيه هذه المقتلة الجنونية؟!
> هل هناك عمل جديد تعكفين عليه حالياً؟- نعم، أقوم بالعمل على رواية تبدو صعبة ومتشعبة إلى الآن، ولكنني أعمل بطاقة الحب والمحبة التي اعتدت معالجة الروايات بها، صلّوا معي من أجل أن أتمكن من إتمامها كما أود دون استعجال أو إهمال.