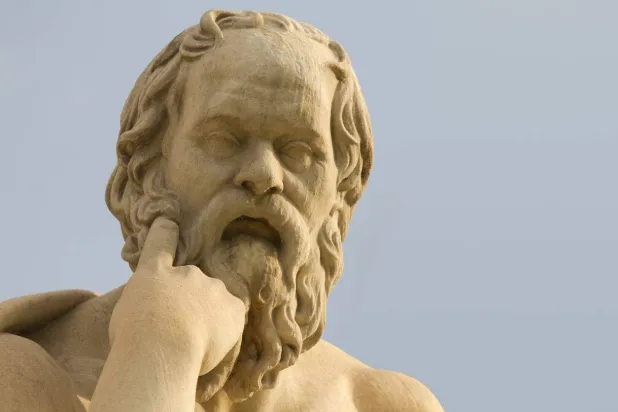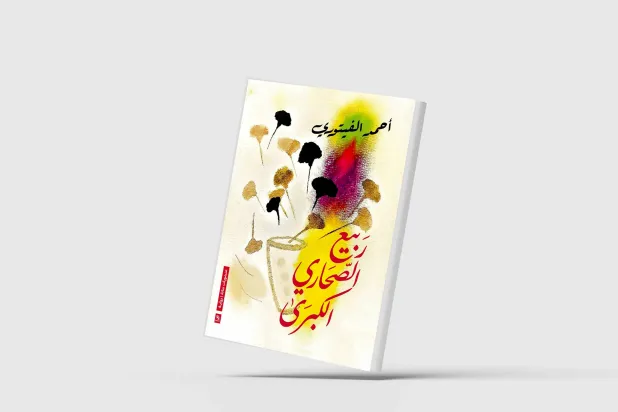في روايتها الأحدث «بالحبر الطائر»، الصادرة عن دار «الكتب خان» في القاهرة، تقدم الروائية المصرية عزة رشاد أربع شخصيات نسائية رئيسة، هُن مركز الرواية، متتبعة مصائرهن ومآلاتهن، في رحلاتهن لإثبات الوجود، ومصارعة الإرث الذكوري المتجذر ثقافياً، يهربن منه إلى فضاءات أخرى بعيدة، لكنه يلاحقهن كقدرٍ محتوم لا فكاك منه، حتى بعد السفر وعبور البحر المتوسط إلى الفضاء الغربي، فلم يجدن الخلاص على الشاطئ الآخر، بل لاحقهن المصير نفسه، الإلغاء والمحو، وعدم الاعتراف بهن، إضافة إلى الاغتراب عن أنفسهن، وعن هوياتهن، فتضاعفت الأزمات والمآزق الوجودية التي تعانيها كلٌّ من النساء الأربعة.
نعيمة ونجوى ونادين ونسمة، أربع نساء في العقد السادس من العمر تقريباً، جمعتهن الصداقة في شبابهن أثناء الدراسة في جامعة الإسكندرية، وأطلقن على أنفسهن لقب فريق «الفور N»، على غرار اسم الفرقة الغنائية الشهيرة في نهايات القرن العشرين، ثم تفرقت بهن السبل، هاجرت نجوى إلى أميركا وتزوجت هناك رجلاً لبنانياً، وتزوجت نادين شاباً مصرياً سكندرياً وسافرا معاً إلى فرنسا، وسافرت نسمة إلى إنجلترا وتزوجت زيجتين فاشلتين. وحدها نعيمة التي ظلت في الإسكندرية، وتزوجت روائياً كان زميلهن في الجامعة، ولها مركز ثقل خاص في الرواية؛ فهي همزة الوصل بينهن، تحاول إعادة لمّ شمل صديقاتها عبر التواصل والحوار في «جروب» على «فيسبوك»، وتدعوهن للعودة إلى الإسكندرية في إجازة يقضينها معاً، يستعدن فيها ذكرياتهن في المدينة الكوزموبوليتانية، وأحلام الشباب التي كانت تملؤهن بالأمل قديماً.
تتأسس الرواية على تقنية تعدد الأصوات، ففي جروب «فيسبوك» - الفضاء الافتراضي الذي يجمعهن معاً - تحضر الأصوات كلها بشكل سطحي عبر جمل مقتضبة وعابرة، فتبدو كل واحدة منهن للثلاثة الأخريات وكأن حياتها تسير بشكل جيد، لكن الساردة تمنح كل شخصية فصلاً تحكي فيه عن نفسها بصوتها الخاص، عبر تقنية التداعي الحر، لتتكشف أزمة كل منهن، واختلاف المآلات بين ما كانت تصبو إليه في شبابها، وما تبدو عليه الآن لصديقاتها، وبين حقيقة حياتها وأزمتها الراهنة. ويتحول غناؤهن في الشباب إلى نحيب على مصائر لم تكن في الحسبان.
يجمع الشعور بالمحو والإلغاء الشخصيات الأربع، فكل شخصية منهن تعاني محواً ما، سواء في المجتمع المحيط، أم في محاولتها هي محو تاريخها وذكرياتها، وهذا ما يبدو منذ عتبة العنوان. تكتب نعيمة مذكراتها بحبر طائر، قابل للمحو بعد فترة، كي يتمكن ابنها وزوجها من قراءتها لو ماتت بغتة، ويعرفا ما عانته منهما، ومعهما، وإذا عاشت طويلاً تنمحي الكلمات والذكريات من تلقاء نفسها. إنها بهذا تضع ذاتها وتاريخها وأوجاعها على محك النسيان والتلاشي، كما تلاشت أحلامها، وكذا علاقتها بابنها وزوجها، وحتى علاقتها بالقطط التي تُربيها، مستعيضة بها عن التواصل مع عائلتها، فآخِر قطة لديها هربت وتركتها تعاني الوحدة. وفي النهاية تتلاشى نعيمة على مهل، على أثر حادث أدخلها غيبوبة طويلة، لتظل عالقة بين الحياة والموت، تماماً كما كانت وهي في كامل صحتها.
هذا التلاشي والمحو لا علاقة له بالمكان، ولا بوجود الشخصية في مصر، فصديقاتها المهاجرات واجهن المحو نفسه، وربما بدرجةٍ أكثر قسوة، إذ إن نجوى، أكثرهن جموحاً وانطلاقاً وتحرراً في مرحلة الشباب، تعاني محواً أشد وطأة في مانهاتن الأميركية، إذ تنمحي ذاكرتها، وتعاني نسيان اسمها وتاريخها وابنتها وزوجها، هذا النسيان الناتج عن صدمات نفسية حادة، بعد أن هربت ابنتها «نورا» من منزل الأسرة، وتتواتر أنباء أو توقعات عن انتمائها لـ«داعش»، ولم يكن هرب الابنة سوى نتيجة عدم قبول المجتمع الأميركي لهم بصفتهم أسرة عربية مسلمة، فالشاب الأميركي الذي أحبته رفض الزواج منها نزولاً على رغبة أمه التي لم تقبل أن يتزوج ابنها الأميركي فتاة من أصول عربية. هكذا شعرت نجوى بتهدم وتلاشي كل ما عاشت عمرها لأجله، تجذرها في مجتمع متحرر بدا وهماً غير حقيقي، وأنها ستظل مهاجرة عربية غير مرحَّب بها، وكذا تلاشت أسرتها بعد أن أفنت حياتها في تشييدها، فكانت المحصّلة أن تتلاشي ذاكرتها جراء هذه الصدمة.
نادين، التي انتقلت إلى باريس، وتفرغت لتربية ابنها وابنتيها، ولمساعدة زوجها أستاذ الجامعة في الارتقاء مهنياً، ومحت ذاتها وطموحها المهني تماماً، وعاشت أسيرة أفكار رجعية تحكم الجالية العربية المحيطة بها، فوجئت بأن ابنها أدمن المخدرات وهجر المنزل أيضاً، وطلب منها زوجها أن تعود بالابنتين إلى الإسكندرية؛ لإنقاذهما من مصير شقيقهما في مجتمع منفتح، وسيرسل لهم «مصروفاً» شهرياً، وسيظل هو في عاصمة النور يمارس مهنته وحريته، فشعرت بأن تاريخها وعطاءها كله يُمحى «في فرنسا، كنتُ أحسب وجودي معهم هام ومؤثر، لكنه امّحى في لحظة، كحبر طائر. وفي الإسكندرية، لن أفعل سوى الوقوف بالطابور، لأصرف قيمة الشيك».
الصديقة الرابعة في فريق «الفور N» هي نسمة، وُلدت بعيب خلقي في جيناتها، إذ كانت لديها كروموسوم X، دون كروموسوم ثان، لا X، ولا Y فتكون ذكراً، بل عالقة جينياً بين الجندريْن، ولم يأتها الطمث مطلقاً لتكتمل أنوثتها، رغم وجود أعضاء أنثوية، وهو ما يسمى متلازمة تيرنر، وظلت موضع اندهاش كل من يعرفها في مصر، وعندما هاجرت لتجد الدعم والتفهم لحالتها، لم تجد هناك سوى ما وجدته هنا؛ عدم التقبل، فضلاً عما تعانيه في إنجلترا من صعوبات الحياة، فاعتادت أن تمحو جسدها وتخفيه، قبل أن يخفيه المجتمع، ممارسة القمع الذاتي على نفسها «لا جسم لي... أمحوني داخل ثياب واسعة لا شكل لها، ولا شكل لي داخلها، ولا إحساس بكياني».
«بالحبر الطائر» ليس مجرد عنوان للرواية بل هو عنوان لعطاء النساء ووجودهن ونضالهن في الحياة، عنوان لما يبذلنه من أجل الأسرة والعالم، لكنه سرعان ما يتطاير، وسرعان ما يتعاطى معها الجميع، في الشرق والغرب على السواء، ككائن شفاف، غير مرئي، وعطاءاته ليست موضع اعتبار، وسرعان ما يجري محو هذه العطاءات، بل محو وإلغاء المرأة نفسها.