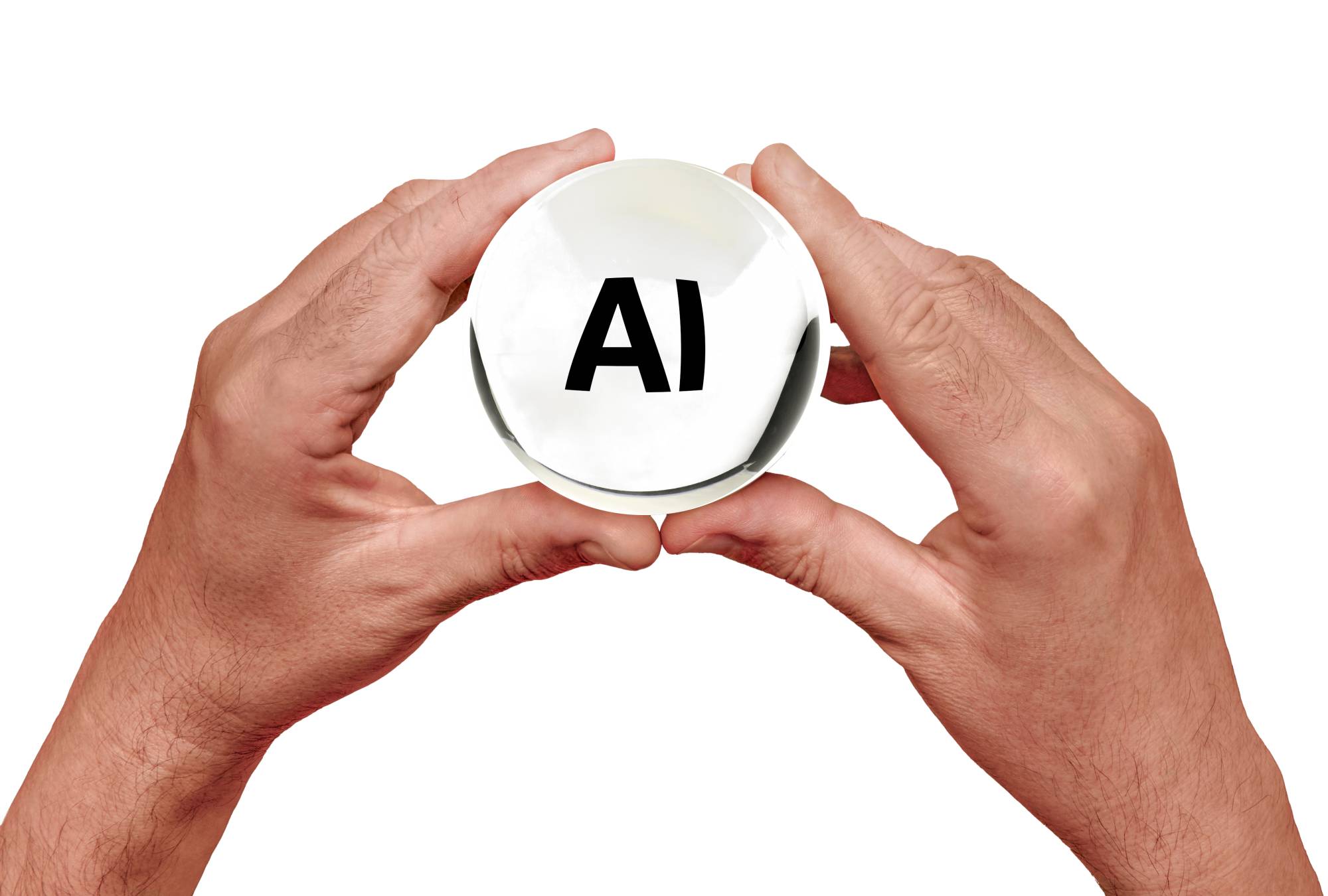في مختبرٍ في قبو جامعة نيو مكسيكو، كان ماركوس غارسيا يفتش في سلة مهملات مليئة بالنفايات البلاستيكية. وهناك عثر على زجاجات، وقطع من شبكة صيد، وفرشاة أسنان، وكوب عليه شخصية بوكيمون، ولعبة جي. آي. جو... «نعم!» صاح وهو يرفع طرف ماصة مهملاً. «وجدتها»، كما كتبت نينا أغراوال(*).

مختبر علمي رائد
غارسيا عضو في مختبر رائد، يديره عالم السموم ماثيو كامبن، يدرس كيفية تراكم الجسيمات الدقيقة المعروفة باسم البلاستيك الدقيق في أجسامنا. وقد بثّت أحدث ورقة بحثية للباحثين، نُشرت في فبراير (شباط) الماضي في مجلة «Nature Medicine»، سلسلة من العناوين الرئيسية المثيرة للقلق، إضافة إلى الضجة في الأوساط العلمية.
جسيمات البلاستيك الدقيقة في الدماغ
وقد وجد الباحثون في المختبر أن عينات الدماغ البشري في عام 2024 تحتوي على نحو 50 في المائة من البلاستيك الدقيق أكثر من عينات الدماغ في عام 2016.
وقال كامبن: «هذه المواد تزداد في عالمنا بشكل كبير». فمع تراكمها في البيئة، تتراكم في أجسامنا أيضاً. كما أثار بعض النتائج الأخرى التي توصل إليها الباحثون قلقاً واسع النطاق.

البلاستيك والخرف والمواليد الخدج
في الدراسة، احتوت أدمغة الأشخاص المصابين بالخرف على مواد بلاستيكية دقيقة أكثر بكثير من أدمغة الأشخاص غير المصابين به. في أوراق بحثية نُشرت العام الماضي، أظهر الباحثون وجود جسيمات بلاستيكية دقيقة في خصيتي الذكور ومشيمة الإناث . كما وثّق علماء آخرون وجودها في الدم، والسائل المنوي، وحليب الأم، وحتى في براز الطفل الأول.
وفي فبراير (شباط) أيضاً، وبالتعاون مع زملاء من كلية بايلور للطب ومستشفى تكساس للأطفال، أصدر مختبر كامبن بحثاً أولياً يُظهر أن مشيمات الأطفال الخُدج تحتوي على جسيمات بلاستيكية دقيقة أكثر من تلك الخاصة بالأطفال المولودين في موعدهم الطبيعي، على الرغم من أن هذه الجسيمات لم تتراكم إلا بعد فترة قصيرة.
ولكن على الرغم من جميع الأماكن التي عثروا فيها على جسيمات بلاستيكية دقيقة، وكل القلق بشأن المخاطر الصحية، كان هناك الكثير مما لم يفهمه الباحثون بعد.
الجرعات والسموم
أول ما يتعلمه علماء السموم هو أن «الجرعة تُكوّن السم»: أي مادة، حتى الماء، يمكن أن تكون سامة بجرعة عالية بما يكفي. لكن كامبن وغارسيا لم يكونا على دراية بكمية الجسيمات البلاستيكية الدقيقة اللازمة لبدء التسبب في مشكلات صحية. ومع وجود هذا الكم الهائل من البلاستيك في عالمنا، هل كان طعامنا، أو ملابسنا، أو هواؤنا، أو مصادر أخرى هي التي تُشكّل التهديد الأكبر؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة، لجأ الباحثون إلى الجثث.
البحث عن البلاستيك في الدماغ
في ورقتهم البحثية، أفاد الباحثون بأن متوسط تركيز البلاستيك الدقيق في 24 دماغاً بشرياً اعتباراً من عام 2024 بلغ نحو 5000 ميكروغرام لكل غرام، على الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين في هذا التقدير نظراً لطرق حسابه.
وهذا يعني نحو 7 غرامات من البلاستيك لكل دماغ -أي ما يعادل ملعقة ذات استخدام واحد، كما ذكر كامبن، أو نحو خمسة أغطية لقنانيٍّ من الماء. تحتوي أدمغة الأشخاص المصابين بالخرف على كمية أكبر، مع أن الباحثين أشاروا إلى أن ذلك قد يكون بسبب امتلاك هذه الأدمغة حاجزاً دموياً دماغياً أكثر مسامية، وبالتالي قلة قدرتها على التخلص من الجزيئات السامة.
لم يتضح بعد تأثير هذه الكمية من البلاستيك على صحة الإنسان، لكنها كافية لإثارة القلق. وتدرس مجموعته الآن أنسجةً من مقاطع عرضية لدماغ واحد لمعرفة ما إذا كانت مناطق معينة تحتوي على تركيزات أعلى من البلاستيك الدقيق، وما إذا كان ذلك مرتبطاً بمشكلات مثل مرض باركنسون أو فقدان الذاكرة.

أبحاث بتكلفة عالية
وللمقارنة، يود الباحثون دراسة دماغ من فترة ما قبل سبعينات أو ستينات القرن الماضي، عندما أصبح البلاستيك منتشراً في كل مكان. يقول كامبن: «يمكنك تخيل متحف قديم كلاسيكي بدماغ يطفو في جُرة. أنا بحاجة ماسة لواحد من تلك».
وهذه التجارب مكلِّفة وتستغرق وقتاً طويلاً. وليس من السهل الحصول على عينات الدماغ. وتبلغ تكلفة الأجهزة التي تحلل البلاستيك نحو 150 ألف دولار للجهاز الواحد.
لكنَّ هذه الدراسات أتاحت لكامبن التوصل إلى استنتاجات لم يتوصل إليها أحد غيره. فقد دفعته إلى الاعتقاد أن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في أجسامنا أصغر بكثير من أي شيء وصفه علماء آخرون، وهو ما يفسر كيفية اختراقها حواجز أجسامنا ووصولها إلى أعضائنا.
دراسات مجهرية
وقد أكد هذا الظن باستخدام مجهر عالي الدقة: فقد أظهر أشياء تشبه الشظايا لا يزيد طولها على 200 نانومتر -أي أقل بنحو 400 مرة من عرض الشعرة- ورقيقة لدرجة أنها كانت شفافة. في حين استخدمت الدراسات السابقة مجاهر لا يمكنها الرؤية إلا حتى 25 ضعف هذا الحجم.
يرى كامبن أن توثيق وجود جسيمات صغيرة جداً قد يُزعزع فهمنا لكمية البلاستيك الموجودة في أجسامنا، وكيف تصل إلى هناك، وإلى أين يمكن أن تذهب، وما الضرر الذي قد تُسببه.
بلاستيك الماء والنباتات والغذاء
لا يستطيع الباحثون الجزم بكيفية دخول هذه المواد البلاستيكية إلى أجسامنا أو من أين نشأت، لكن لديهم بعض الأدلة. قالت كريستي تايلر، أستاذة علوم البيئة في معهد روتشستر للتكنولوجيا، والتي تدرس المواد البلاستيكية الدقيقة في النظم البيئية المائية، إنهم يعلمون أن النفايات البلاستيكية تنتهي في تربتنا ومائنا وهوائنا وحتى المطر.
وقد تُدمج في النباتات وتصبح أكثر تركيزاً في أثناء صعودها في السلسلة الغذائية. يوجد البلاستيك في ملابسنا وسجادنا وأرائكنا وحاويات تخزين الطعام -«إنه في الواقع في كل مكان»، كما قالت تايلر.
تغلغل بلاستيك النفايات
تشير خصائص البلاستيك التي وجدها فريق كامبن في الأنسجة البشرية إلى أنها جاءت في المقام الأول من نفايات جرى إنتاجها منذ سنوات كثيرة، وتعرضت للعوامل الجوية بمرور الوقت. وجد الباحثون كمية كبيرة من البولي إيثيلين، على سبيل المثال، وهو النوع السائد من البلاستيك الذي جرى إنتاجه في الستينات، ولكن كمية أقل من البلاستيك المستخدم في زجاجات المياه، التي انتشرت في التسعينات.
ولأن إنتاج البلاستيك يتضاعف كل 10 إلى 15 عاماً، فحتى لو توقفنا عن إنتاجه اليوم، فإن كمية كبيرة من البلاستيك تظل قيد الاستخدام بالفعل، مما سيؤدي إلى تراكم مزيد ومزيد من النفايات البلاستيكية في البيئة، وربما في أجسامنا لعقود قادمة.
دخول البلاستيك إلى الجسم
يعتقد كامبن أن الطريقة الرئيسية لدخول هذه المواد البلاستيكية إلى أجسامنا هي عندما نبتلعها، بعد فترة طويلة من التخلص منها وبدء تحللها. وهو أقل قلقاً بشأن ما يسمى «البلاستيك الطازج»، مثل تلك التي تتساقط من ألواح التقطيع وزجاجات المياه في أثناء استخدامنا لها، لأن هذه الجسيمات أكبر بكثير وأحدث مما قام بقياسه. وتشير الأبحاث إلى أن الجسم يتخلص من بعض المواد البلاستيكية الدقيقة الأكبر حجماً.
وأقر كامبن بأن وجهة نظره بشأن البلاستيك الطازج «غير تقليدية»، ويقول علماء آخرون إنه من المفيد اتخاذ خطوات لتقليل التعرض له. من الواضح أن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة يمكن أن تتسرب من قنانيِّ المياه، وأوعية الطعام المسخنة في الميكروويف، والملابس الصناعية، وتشير الأبحاث المستمدة من الدراسات على الحيوانات إلى أن هذه الجسيمات قد تكون ضارة، وفقاً لتريسي وودروف، مديرة برنامج الصحة الإنجابية والبيئة في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو.
ولكن، كما هو الحال مع أي علم مبكر، هناك محاذير. أولاً، من الصعب للغاية قياس هذه الجسيمات الدقيقة. ولم يُكرر أحد البحث بعد لمعرفة مدى صحة النتائج. والسؤال المهم هو عمَّا إذا كان كل ما يقيسونه من البلاستيك بالفعل، أو ما إذا كان بعضه دهوناً، التي قد تبدو متشابهة كيميائياً ولكنها موجودة بشكل طبيعي في الجسم.
وقالت وودروف: «تبدو تقديراتهم لكمية البلاستيك الموجودة في الدماغ مرتفعة». ولكن حتى لو كانت كذلك، كما قالت، «فإن ذلك لن ينفي النتائج التي تشير إلى أنهم يرون مزيداً من البلاستيك بمرور الوقت. وهذا في الواقع يتماشى تماماً مع ما نعرفه عن إنتاج البلاستيك».
المخاطر الصحية الناجمة عن البلاستيك
هناك سؤال واحد يشعر كامبن وغارسيا أنهما بدآ بالإجابة عنه بثقة. وهو السؤال الذي بدآ به: ما كمية البلاستيك في أجسامنا؟
وهما الآن مستعدان لاستكشاف الروابط المحتملة بين جرعات معينة ونتائج صحية بشرية، مثل أمراض القلب، ومشكلات الخصوبة، والتصلب اللويحي.
ويبدآن تجربة على الحيوانات لفهم الجرعات التي قد تكون ضارة.
بدأت تيا غارلاند، طالبة الصيدلة، هذه العملية في المختبر، مرتدية قناعاً لتجنب استنشاق الجسيمات، إذ أدخلت قطعاً مما يشبه الطباشير الملون في آلة أصدرت صوت عواء مخيفاً في أثناء تجميدها وسحقها للمواد البلاستيكية. في النهاية، سيُطعم الباحثون هذه القطع للفئران، وسيدرسون كيف تؤثر المستويات والأنواع المختلفة على أدمغتها وسلوكها.
وقد جاءت هذه القطع من شاطئ في هاواي، حيث جمعت غارسيا وآخرون 1800 رطل (الرطل 453 غراماً تقريباً) من بقايا البلاستيك و220 كيلوغراماً أخرى استخلصتها من الشِّبَاك.
* خدمة «نيويورك تايمز»
حقائق
7
غرامات من البلاستيك رصدت لكل دماغ - أي ما يعادل مقدارملعقة منه