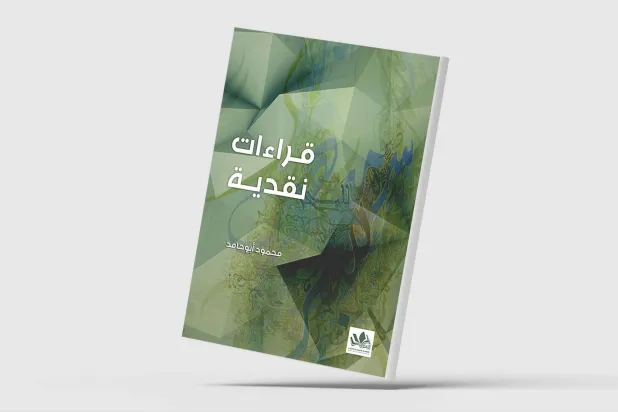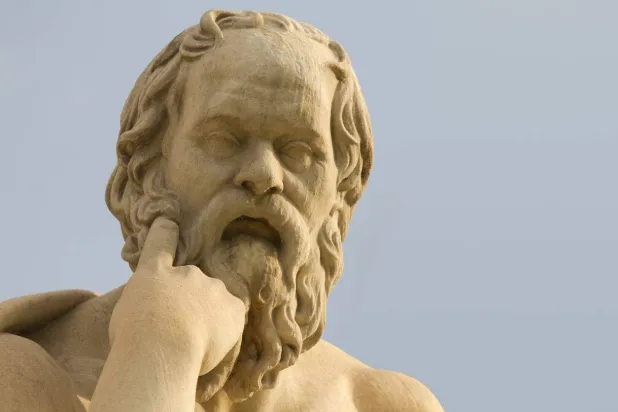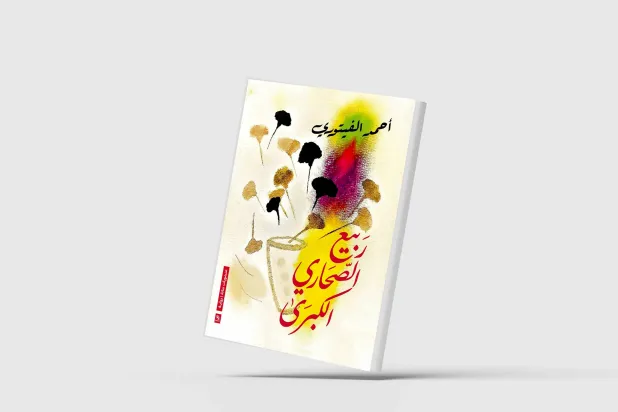تحوي مملكة البحرين سلسلة من المقابر الأثرية، من أبرزها مقبرة تُعرف باسم الشاخورة، نسبةً إلى القرية التي تجاورها. كشفت أعمال التنقيب المتواصلة في هذه المقبرة عن مجموعة كبيرة من القطع الفنية المتنوعة دخل قسمٌ منها متحف البحرين الوطني في المنامة، ومنها تمثال أنثوي منمنم من العظم لا نجد ما يماثله في ميراث البحرين الأثري إلى يومنا هذا. يعود هذا المجسّم إلى المرحلة الممتدّة من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الأول للميلاد، ويبدو فريداً من نوعه على الصعيد المحلّي، غير أنه يتبع في الواقع تقليداً فنياً جامعاً شاع في الشرق كما في الغرب، ويشابه بوجه خاص قطعاً فنية صُنعت في بلاد الرافدين خلال تلك الحقبة.
تقع مقبرة الشاخورة شمال غربي القرية التي تحمل اسمها في المحافظة الشمالية، وتبعد نحو 700 متر جنوب شارع البديع في شمال العاصمة المنامة. ظهرت المعالم الأولى لهذا الموقع في مطلع ستينات القرن الماضي، وتواصلت أعمال المسح والتنقيب فيه خلال العقود التالية، وأدت إلى الكشف عن سلسلة من القبور تعود إلى مراحل تاريخية متعاقبة، خرجت منها مجموعات متعددة من اللقى الأثرية. تكفّلت إدارة الآثار المحلية بأعمال التنقيب في حملة استمرت من عام 1992 إلى عام 1993، تبعتها حملة أخرى دامت من 1996 إلى 1997، أدارها الأستاذ مصطفى إبراهيم سلمان. كشفت هذه الأعمال عن تلٍّ يحوي مجموعة تتألف من 94 قبراً، إضافةً الى 10 جِرار خُصّصت لدفن أطفال، وحمل هذا التل رقم 1 في التقارير التوثيقية الخاصة بهذه الحملة.
تبيّن أن أحد هذه القبور يعود إلى صبيَّة في مقتبل العمر، دُفنت مع مجموعة من الحليّ والأغراض الخاصة بها، وصلت بشكل شبه كامل، إذ لم تتعرض لأي عمل من أعمال النهب كما يحصل عادةً، وحمل هذا القبر رقم 47 في هذه التقارير. ضمّ هذا الأثاث الجنائزي عقداً بديعاً من الذهب يبلغ طوله نحو 24 سنتيمتراً، ويتألف من أربع قطع خرطومية تتآلف مع تسع قطع دائرية وتِسع قطع عنقودية. كما ضمّ تمثالاً أنثوياً صغيراً من العظم، وصل من دون ذراعيه الموصولتين به في الأصل، وفقد جزءاً كبيراً من رأسه. بقيت هاتان القطعتان الفنيتان مجهولتين إعلامياً، إلى أن تمّ الكشف عنهما للمرّة الأولى خلال عام 1999، حيث تمّ عرضهما ضمن معرض خاص بالبحرين أُقيم في معهد العالم العربي. تبعت هذا العرض الأول عروض أخرى ضمن معارض مشابهة، وساهمت هذه العروض في دخول هاتين القطعتين الفنيتين في الدائرة الإعلامية الواسعة.
يبلغ طول هذا التمثال 17.5 سنتيمتراً، ويظهر عند طرف كل من كتفيه ثقب دائري، ويوحي هذان الثقبان بأن هذا المجسّم المصنوع من العظم كانت له أطرافٌ مفصليّةٌ مستقلّة صُنعت من مواد قابلةٍ للتلف، والأرجح أنها كانت من الخشب. يُعرف هذا الطراز من التماثيل الأنثوية المنمنمة بالدمى المتحرّكة، ويتميّز بذراعين تمّ ربطهما بالصدر بواسطة خيوط، ممّا يسمح بتحريكهما. يعود أقدم شواهده الأصلية إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، مصدرها مصر، وتشكّل هذه الشواهد أساساً للتقليد المتّبع حتى يومنا هذا في صناعة اللعب. وصل هذا التقليد كما يبدو إلى البحرين منذ تلك الفترة الموغلة في القدم، كما تشهد قطعة عاجية استثنائية من محفوظات المتحف البريطاني في لندن، تعود إلى الألفية الثانية قبل الميلاد. وصل هذا التمثال بشكل مجتزَأ، ويبلغ طوله 21 سنتيمتراً، ومصدره المقبرة الشهيرة بـ«تلال مدافن دلمون»، وهي حقل تلال مدافن عالي الشرقي، نسبةً إلى مدينة عالي في المحافظة الشمالية، وتقع في وسط البحرين، إلى جنوب مدينة عيسى، وإلى شمال مدينة الرفاع.
يختلف تمثال الشاخورة من حيث الأسلوب الفني عن تمثال عالي، ويختزل تطوّر هذا النسق في مطلع القرن الميلادي الأول. الرأس عريض وكبير، حجمه أكبر من حجم القامة من حيث النسبة التشريحية، ويتميّز بشعر كثيف تبدو خُصلُه أشبه بقبعة كبيرة يظهر في وسطها شقّ غائر ومستقيم. يحدّ هذه القبعة في الجزء الأسفل مثلّثان متساويان تكسو كلاً منهما شبكة من الخطوط العمودية المتوازية، حُدّدت بخطوط غائرة. فقد الوجه جزءاً كبيراً من جانبه الأيمن، وحافظ على الجزء الأعلى من جانبه الأيسر، وفيه ظهرت العين بشكل كامل، وبدت لوزية وواسعة وجاحظة. الأنف مستقيم وناتئ. الثغر ضائع ولم يبقَ منه أي أثر. وصل صدر البدن بشكل كامل، وتميّز بعقد مثلّث عند أسفل العنق، وحزام عريض يلتف حول الوسط. يرتفع هذا الصدر فوق ساقين مفصولتين الواحدة عن الأخرى، يعلوهما مثلث يستقر عند الحوض.
يختزل تمثال الشاخورة الطراز الشرقي الخاص بالدمية المتحرّكة في مطلع الحقبة الميلادية، وهو الطراز الذي يبرز في بلاد الرافدين بوجه خاص، وشواهده كثيرة، منها تمثال من محفوظات متحف بغداد مصدره مدينة سلوقية القديمة على ضفة نهر دجلة، ومجموعة من التماثيل محفوظة في متحف بنسلفانيا، مصدرها بابل ونيفور. واللافت أن هذا الطراز الشرقي بلغ الغرب بشكل محدود كما يبدو، كما تشهد بضعة تماثيل منمنمة خرجت من مقابر قديمة في روما تعود إلى الحقبة المسيحية الأولى، ودخلت متحف الفاتيكان.
في شبه الجزيرة العربية، نقع على دمية واحدة من هذا الطراز، لا يتجاوز طولها 8 سنتيمترات، وهي محفوظة في متحف قسم الآثار في جامعة الملك سعود بالرياض، ومصدرها قرية الفاو الثرية بالآثار. مثل دمية الشاخورة، صُنعت دمية الفاو من العظم، وفقدت ذراعيها، غير أنها حافظت على رأسها بشكل كامل، ولم تفقد أي تفاصيل من مكوّنات ملامحها.