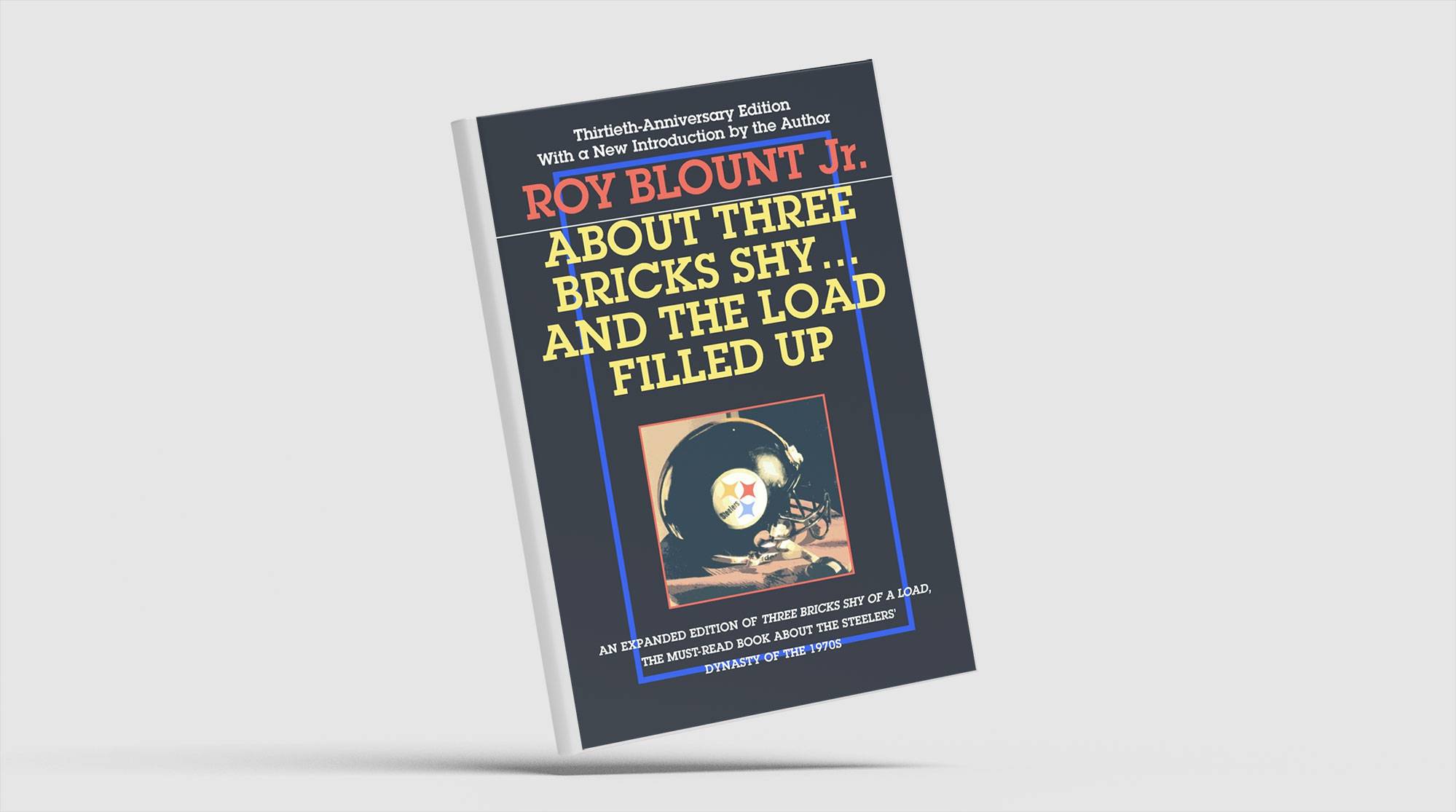* بعض الأدباء ينظرون إلى مهنة الكتابة نظرتهم إلى مهنة الكاهن. فالأديب كما يرونه مفسر لحقيقة عليا ينقلها لمن يحتاجون إلى نور البصيرة
«إن الشعر لا يجعل شيئاً يحدث». هكذا كتب الشاعر الأنجلو - أميركي و. هـ. أودن في قصيدته «في ذكرى و. ب. ييتس» وهي مرثية للشاعر الآيرلندي الذي توفي في يناير (كانون الثاني) 1939. فالشعر - والأدب عموماً - في رأي أودن عديم الفاعلية في العالم الواقعي. إنه مجرد كلمات لا تلبث أن تتبدد في الهواء ولا تحدث تغيراً ملموساً. وفي مواضع أخرى من كتاباته النثرية يقول أودن إن تاريخ البشرية ما كان ليتغير قيد أنملة لو أن هوميروس ودانتي وشكسبير لم يكتبوا حرفاً واحداً أو لم يمشوا على ظهر الأرض.

لكن الكتاب الذي نعرضه هنا يتخذ موقفاً مغايراً لموقف أودن. إنه كتاب «كتّاب غيروا التاريخ» Writers who Changed History الذي اشترك في وضعه أحد عشر ناقداً وباحثاً، وقدّم له الإذاعي والصحافي البريطاني جيمس نوتي James Naughtie.
والكتاب صادر في هذا العام (2024) عن دار نشر «بنجوين: راندوم هاوس» في 368 صفحة من القطع الكبير محلاة بعشرات الصور واللوحات الملونة في إخراج طباعي فائق الجمال.

الكتاب - كما يدل عنوانه - يذهب إلى أن الكلمة المكتوبة عظيمة التأثير وقادرة على توجيه مجرى الأحداث. وهو مقسم إلى ستة فصول تعرّف بأكثر من مائة شاعر وروائي وكاتب مسرحي من مختلف اللغات منذ العصور الوسطى حتى يومنا هذا.
لن أتوقف هنا عند الأسماء الكبرى التي أشبعتها الأقلام بحثاً وتكونت حولها مكتبات كاملة من الدراسات (شكسبير، سرفنتس، ديكنز، تولستوي، بروست، جويس، إلخ...)، وإنما سأتوقف وقفة قصيرة مع ثلاثة أدباء من جنسيات مختلفة يكتبون بلغات مختلفة ويمثلون الأجناس الأدبية الثلاثة الكبرى: الشعر، والمسرحية، والرواية.
فالشعر يمثله شارل بودلير (1821 - 1867) الشاعر والناقد الفني الفرنسي الذي أحدث ديوانه «أزهار الشر» (1857) «رعشة جديدة» في الشعر على حد تعبير فيكتور هوغو. لقد أقام بودلير جسراً يصل بين الرومانتيكية والرمزية، واستوحى حياة المدينة الحديثة (باريس في هذه الحالة)، كما استوحى الأجواء المدارية لجزر المحيط الهادئ. وقد كتب عن موسيقى رتشارد فاغنر، وقدم الأديب الأمريكي إدجار آلان بو إلى القارئ الفرنسي، ونوّه بلوحات المصورَين ديلاكروا ومانيه. كان من آباء الحداثة الشعرية؛ إذ صوّر اغتراب الفرد وسط الجموع، وحالات الملل والعزلة والكآبة والقنوط، وجمع في شعره - إذ يتجول في غابة من الرموز - بين معطيات الحواس وتراسل العطور والأصوات والألوان في معبد الطبيعة وعالج قصيدة النثر، كما كانت له محاولات قصصية. ومن معطفه خرج رمبو وفرلين ومالارميه.
والمسرحية يمثلها أديب إسكندنافي هو السويدي أوغست سترندبرغ (1849 - 1912) الذي لم تكن حياته تقل دراميةً وعذاباً واضطراباً عن حياة بودلير. كانت حياة عاصفة (صوّرها في سيرته الذاتية المعنونة «ابن خادمة» وفي كتابه المعنون «الجحيم») ملؤها الصراعات العاطفية والأزمات العقلية، وصور التوترات في العلاقات بين الرجل والمرأة، وكان يعتبر الزواج (تزوج ثلاث مرات) مبارزة أو ميدان قتال أو ساحة صراع بين الذكر والأنثى، كما في مسرحياته «الأب» و«الآنسة جوليا». وتلاقت بعض أفكاره مع بعض أفكار شوبنهاور ونيتشه وفرويد.
جرّب سترندبرغ يده في معالجة مختلف الأجناس الأدبية، وجمع بين النثر والشعر، ومارس فن التصوير. ولكنه يذكر أساساً بتجاربه في المسرح التعبيري والرمزي الذي يغوص على أعمق الذكريات والمخاوف والرغبات. لقد تقلب بين دراسة اللاهوت والطب، وانجذب إلى التصوف والسحر والخيمياء والخوارق. ومن أقواله في مسرحيته المسماة «مسرحية حلم»: «ليس العالم والحياة والكائنات البشرية سوى وهم وطيف وصورة حلمية». وهو يمثل نقلة من ناتورالية (المذهب الطبيعي) القرن التاسع عشر إلى حداثية القرن العشرين.

ومن أعلام الرواية في عصرنا ج. م. كوتزي (ولد في 1940) وهو أستاذ جامعي وناقد ولغوي ومترجم لنماذج من الشعر الهولندي إلى اللغة الإنجليزية وحائز جائزة نوبل للأدب في 2003. قضى كوتزي فترات من حياته في لندن والولايات المتحدة الأميركية. وهو أوروبي الأفق انجذب إلى حداثة إليوت وباوند وبكيت وإلى موسيقى باخ. كان معارضاً للتفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا ولحرب أميركا في فيتنام، كما كان نباتياً مدافعاً عن حقوق الحيوان.
تغيم في روايات كوتزي الحدود بين القصة والسيرة الذاتية والمقالة، وتصور صراع الطبقات وتصادم الثقافات، وتحفل بمشاهد الاستجواب والتعذيب والعنف، والماضي في أعماله يطارد الحاضر بلا هوادة. ومن أهم رواياته «في انتظار البرابرة» (1980 وعنوانها مأخوذ من قصيدة للشاعر اليوناني – السكندري كافافي)، وهي تصور التواطؤ مع الأنظمة القمعية التي تتجاهل العدالة وحقوق الإنسان.
ومما يثلج الصدر أن الكتاب يتضمن أديبين عربيين يقفان إلى جانب أقرانهما من كتاب العالم في هذه الصحبة الماجدة: نوال السعداوي (2021 - 1931) ونجيب محفوظ (2006 - 1911). ربما كانت السعداوي (في رأى كاتب هذه السطور) محدودة القيمة، توسلت إلى الغرب أساساً بآرائها النسوية الجسورة، ولكن لا ريب في أن محفوظ كان من أعظم كتاب الرواية في أي لغة في القرن العشرين. ويحمل الكتاب صورة لمحفوظ وهو يسير في أحد شوارع القاهرة في 1989 متأبطاً عدداً من الجرائد والمجلات تعلوها جريدة «الأهرام». ويذكر الكتاب عدداً من الحقائق عن محفوظ ربما كانت معروفة للقارئ العربي ولا جديد فيها، ولكنها ضرورية للقارئ الأجنبي، كالقول بأن محفوظ وُلد في حي الجمالية الشعبي، وأنه أرّخ للحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية المصرية في القرن العشرين، وأنه استوحى في رواياته الأولى تاريخ مصر القديمة، ثم انتقل إلى مرحلة واقعية توجها بثلاثيته المعروفة، ومنها إلى مرحلة تجريبية بها عناصر رمزية (الغورية) ووجودية وسيريالية وعبثية.
ونعود إلى الكلمة التمهيدية التي صدر بها جيمس نوتي الكتاب فنجده يقول إن بعض الأدباء ينظرون إلى مهنة الكتابة نظرهم إلى مهنة الكاهن. فالأديب كما يرونه مفسر لحقيقة عليا ينقلها لمن يحتاجون إلى نور البصيرة وسداد الهداية. إن الكتابة رحلة في المجهول تنتهي باكتشاف. وبعد أن كانت قديماً مرآة تعكس ما تراه صارت مصباحاً يضيء دواخل النفس. لقد ختم الشاعر الآيرلندي شيمس هيني حياته الأدبية بترجمة الكتاب السادس من «الإنيادة»، ملحمة الشاعر الروماني فرجيل، إلى اللغة الإنجليزية. وقبل ذلك استوحى دانتي في القرن الرابع عشر، وإليوت في القرن العشرين، ذلك الشاعر القديم وأعادا تفسيره بغية زيادة معرفتهم بأنفسهم وبالآخرين.
إن عظماء الكتّاب يشتركون في أنهم أبدعوا شخصيات ذات دلالة إنسانية باقية (فاوست المتعطش إلى المعرفة، دون جوان الساعي دائماً أبداً وراء الحب، دون كيشوت الحالم، هاملت المتردد، إلخ...) ونحن نعود إلى هذه النماذج البشرية المرة تلو المرة لأننا نريد أن نعيش خبراتها من جديد، ولأنها تلبي حاجات إنسانية باقية. وجزء من فتنة هؤلاء الكتاب مرده أنهم يجعلوننا لا نكف عن التساؤل: كيف حققوا هذا الإنجاز؟ كيف سبروا أغوار هذه الشخصيات؟ كيف صوّروا هذه التجارب؟ لقد صنعوا ما لم يستطع غيرهم أن يصنعه، ومن هنا كان احتياجنا الدائم إليهم وكان التغير – البطيء ولكنه ثابت - الذي يحدثونه في مجرى التاريخ.