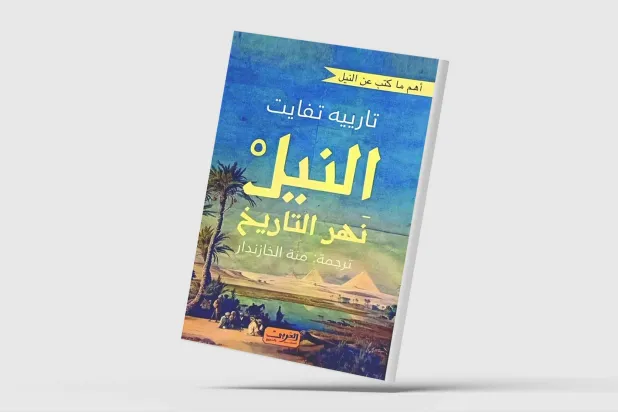في المجموعة القصصية «زغرودة تليق بجنازة» للكاتب والروائي المصري أحمد إبراهيم الشريف، يُحكم الموت قبضته بتراوحاته ومراوغاته المفاجئة حد الصدمة والجنون، والساخرة حتى البكاء، وذلك في فضاء تسكنه المفارقة كمكون رئيسي للسرد، بداية من عنوان المجموعة الذي جعل من رنّة الزغرودة المعروفة بمُصاحبتها للفرح ظلاً للقبور.
صدر الكتاب أخيراً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويضم 100 حكاية تتسم جميعاً بوِحدة نسبية من الطول، تبدو كهيكل فني للعمل يعتمد التكثيف الدلالي والإيقاع السردي المُناوِر.
في قصة «فضيحة» يُقرر البطل بكل وعي أن يهوي من الطابق العاشر لينهي حياته، وفي المسافة من الطابق العاشر للأرض، يبدأ في مراجعة قراره، ويتمنى لو يتعثر بحبل غسيل أو زينة رمضانية منسية ليتشبث بها قبل فوات الأوان، وفي تلك المسافة الزمنية السوريالية، يستدعي صوت أمه التي ستلومه على اختياره طريقة موت بفضيحة سيشهد عليها الجيران، تماماً كما اختارت عمته أن تموت بفضيحة عندما أشعلت في نفسها النيران وركضت في الطريق، في مقابل والده الذي آثر الموت في هدوء وكتمان بحبوب منومة قبل خلوده للنوم، لتبدو قرارات إنهاء الحياة وكأنها ميراث عائلي محتوم في دوائر مُغلقة، ويبدو الموت مادة حكائية قابلة للتشكيل.
استلهام الموروث الشعبي
تدور أجواء المجموعة القصصية في فضاء القرية، بتقاليدها وفقرها، ونُواح نسائها، والانتظار الذي لا تنقطع أوصاله على أرصفة القطارات، فبطل «قطار الفجر» لا تُغادره ذكرى ذلك اليوم الذي تاه فيه وهو طفل من أمه في محطة قطار، يظل بعد سنوات طويلة مُتشبثاً ببيته القديم الذي يطل على سكة حديد القطار، رغم ما صار عليه البيت من هلاك جعله كلما مرّ قطار من أمامه يرتج، يرفض البطل أن يغادر البيت المُتهالك، ويُطل كل مرة من شرفته مع «رجّة» قطار جديد، وكأنه يبحث عن وجه أمه الذي غاب معه ذات يوم.
أما بطل قصة «لا قطارات للموتى» فيظل مُرابضاً على رصيف محطة أسيوط بصعيد مصر لأيام، في انتظار عودة شقيقه، فأمه المُنتحبة حذرته من العودة بدونه. يتعاطف معه العابرون ويسألونه عن محطة القطار التي أخبره شقيقه أنه سيركب منها، ولكننا نعلم أنه ينتظر جُثمانه الذي وعدته الحكومة أن يصل لقريتهم، فيرحل بعد أن تأكد من أن «الميتين مش بيجوا في القطارات».
وتطرح المجموعة التباس علاقة الأبطال بفكرة الغياب، والاختفاء، والموت، فالموت محسوس الخطوات، ومرئي، تشم نذيره نساء القرية، بل يتحاورن معه كأنه معرفة قديمة، ففي إحدى قصص المجموعة يُقسم البطل أن أمه رأت منذ دقائق ملاك الموت بكامل هيبته يمر أمام بيتهم، وأنها سألته: «رايح فين بس على الصبح؟»، فأجابها: «خليكِ في حالك»، وبعد مرور وقت بسيط، سمعوا عويل موت صادراً على بعد خمسة بيوت منهم.
يبدو هذا الحدس غير بعيد عن الموروث الشعبي القروي الضارب في ترقب الموت، والإيمان بالماورائيات والسِحر و«العفاريت»، فالأطفال يترصدون رائحة الموت بعد موت أحد أبناء القرية، ويُطاردونه بالعصي والحجارة خشية أن يدخل بيوتهم ويستولي على أحد أفرادهم في طريقه، وأحد الأبطال يمر بجوار نخلتين يؤمن أهل القرية أن عفريتاً يسكنهما، فيمر بجوارها ويتحصن بترديد سورة «الإخلاص»، لكنه يقع في شرك الفضول، فيطلب من العفريت أن يُظهر له وجهه.
وتهيمن السردية الدينية في المجموعة على زمن القصص وأبطالها، ما بين تلقين الشهادة لمن يستقبل الموت، والسعي والذِكر وراء النعوش، كما أن الأبطال ينسبون الأحداث بتقويم رفع الآذان والصلوات: «وصل النعش ومؤذن جامع الشيخ سلمان ينادي لصلاة المغرب»، فحركة الزمن محدودة بحدود غيطان الذرة وجريد النخيل، التي يبدأ يومها بمطلع الفجر، ليسود الظلام والخوف من بعد صلاة العشاء «في الصباح خرج مرعي من البيت يضحك ويمزح، وعاد بعد آذان العشاء جثة مثقوبة الصدر».
وتبدو النساء في المجموعة وقد جمع بينهن قدر الفراق، والقهر الذي يسلبهن أزواجهن وأبناءهن قتلاً بدافع الثأر، أو بسبب التباري على إنجاب الذكور، فبطلة إحدى القصص «فهيمة حسنين» تُردد عديدها مع مطلع كل صباح منذ قتلوا ابنها، ولم تعد تُميّز من يأتِ لمواساتها بعد أن ابيضت عيناها من البكاء، و«حمدية» تقص جزءاً من شعرها كل يوم، وتضع القصاصات في جلباب زوجها الذي مات مقتولاً على يد ابن أخيه، ثم «فوزية» التي صارت امرأة بروح غراب، يخشى مَن حولها الاقتراب ولو خطوة من مُحيطها، بعد أن صارت نذير شؤم، وتردِّد أن من يقترب من نحيبها تصيبه لعنة، وذلك بعد أن تزوج زوجها بأخرى حتى تُنجب له الولد. وفي ذات صباح استيقظت القرية لتفاجأ باختفاء صوت فوزية وكأنها داهمها الخرس، فعلموا حينها أن زوجها المُفارق أنجب الولد، فدعوا لها بالصبر، وكفوّا عنها لقب روح الغراب.
تصطبغ أسماء الأبطال والبطلات في المجموعة بنكهة محلية قروية خالصة، بما في ذلك نسب الأبناء الذكور لأمهاتهم في زمن الموت، وإطلاق الدعاء وتوسل الرحمة، كما تطرح المجموعة سؤالاً يبدو وكأنه الحقيقة الغائبة وراء جرائم مسكوت عنها، وضحايا تائهين، وافتقاد سلطة المجتمع وعقابه، يختلط السؤال بالمرويّات الشفاهية، فيما يبدو الموت هو المُمسك بخيوط السرد، والمُحيط بأسرار من ذهبوا في أحشائه، كما يظهر في قصة «نهاية»، في إيقاع مثقل بالشجن والأسى: في الطريق إلى قبرها، يقول أهل زوجها: أشعلت النار في نفسها، ويصرخ أهلها: أحرقوها بعدما أوثقوها في سريرها، وتُسجل الوثائق الرسمية: سقطت لمبة جاز فأنهت كل شيء، ويهمس الناس: نهاية متوقعة.