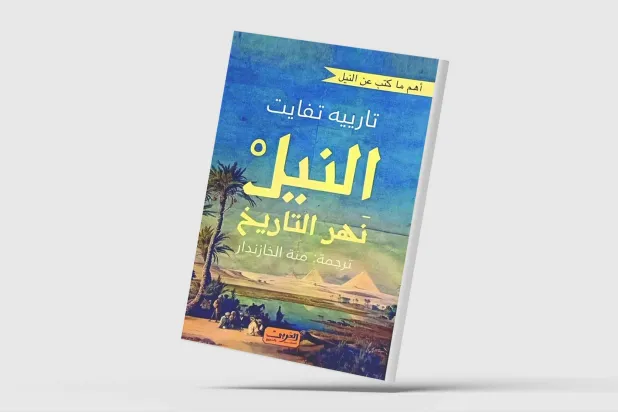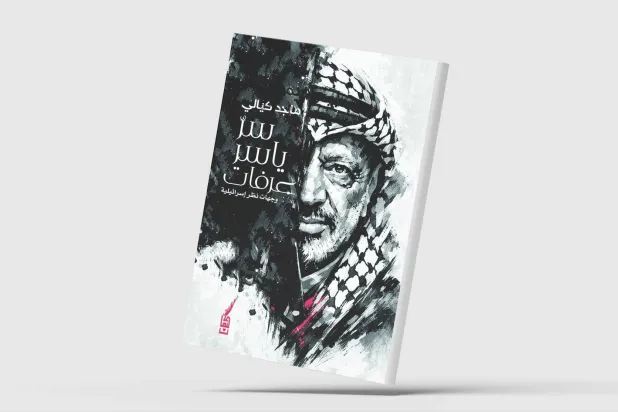تكتسب كتابات الشعراء عن تجربتهم الشعرية قيمة خاصة قد لا تتوافر في كتابات النقاد المحترفين وأساتذة الأدب الأكاديميين؛ ذلك أن كتابة الشاعر عن فنه تجيء ثمرة معايشة حميمة لهذا الفن، وخبرة شخصية مباشرة بمسالك الشعر وشعابه ومضايقه على نحو يبرأ من التجريد الجاف والتنظير البارد.
وأحدث شهادة من هذا القبيل يقدمها كتاب صادر في هذا العام (2023) عنوانه «النوم على الجزر: حياة في الشعر» (Sleeping on Islands: A Life in Poetry). صدر عن دار «فيبروفيبر» للنشر بلندن، من تأليف الشاعر والروائي والناقد الإنجليزي أندرو موشن (Andrew Motion) الذي شغل في الفترة 1999- 2009 منصب شاعر البلاط في المملكة المتحدة، وهو أحد مؤسسي «محفوظات (أرشيف) الشعر» على الشبكة العنكبوتية الدولية. ويعيش حالياً في مدينة بولتيمور بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك منذ تعيينه أستاذاً للفنون بجامعة جونز هوبكنز في 2015.
وموشن غزير الإنتاج، له عدد من الدواوين الشعرية. وفي أدب السير والتراجم: «فيليب لاركين: حياة كاتب» و«كيتس». وفي أدب المقالة والسيرة الذاتية والتأملات: «في الدم: مذكرات عن طفولتي». وفي النقد الأدبي: «شعر إدوارد توماس» و«فيليب لاركين». كما حرر قصائد مختارة للشعراء وليم بارنز وتوماس هاردي وجون كيتس وشعراء الحرب العالمية الأولى.

يتخذ كتاب «النوم على الجزر» شكل فقرات قصار تفصل بينها خطوط وتنتقل في الزمان والمكان جيئة وذهاباً في الفترة ما بين 1970 - 2021، فقد تبدأ إحدى الفقرات مثلاً في عام 2000 ثم ترتد إلى الوراء رجوعاً إلى عام 1976، وهكذا، مما يولد شعوراً بتدفق الزمن وجريانه وآليات الذاكرة التي تربط بين الماضي والحاضر وتعتمد على تداعي الأفكار واتصال تيار الشعور.
في مقدمته، يقول موشن إن كتابه هذا امتداد لكتابه السابق: «في الدم: مذكرات عن طفولتي»؛ إذ إن ذلك الكتاب سجل طفولته حتى سن السابعة عشرة. وهو هنا يواصل القصة ابتداء من ذلك العمر؛ أي إننا نلتقي به هنا شاباً يافعاً ورجلاً في منتصف العمر وشيخاً. وتتوقف القصة عند ربيع 2020. والفارق بين الكتابين أن «في الدم» كان مكتوباً باستخدام الفعل المضارع من وجهة نظر الطفل، محملاً بطزاجة الرؤية وطرافتها، أما «النوم على الجزر» فمكتوب باستخدام الفعل الماضي من وجهة نظر الراشد، كما أنه أميل إلى الانتقاء من تفاصيل الحياة؛ فهو يركز على مسيرته الشعرية ولقاءاته وصداقاته وعلاقاته بسواه من الشعراء، وأغلبهم الآن قد طوته يد المنون، ومن ثم كان بناء الكتاب أقرب إلى الطابع الشذري أو إلى جزر متناثرة في محيط الحياة. وهذا ما يفسر عنوان الكتاب: «النوم على الجزر».
حين منح موشن إجازة من التدريس بجامعة جونز هوبكنز لمدة عام، أغلق على نفسه باب مكتبه وقرر أن يستعرض ماضيه، فكان هذا الكتاب. وزاد من عزلته ظهور وباء «الكوفيد» وتوقف عجلات الحياة عن الدوران وانتشار الشعور بالحزن والإحباط في الحياة العامة والحياة الخاصة على السواء.
وفيما بين بداية الكتاب ونهايته نلتقي بموشن في مواقف مختلفة ولحظات تتراوح بين السعادة والشقاء، والنجاح والإخفاق، ولكنها كلها تجتمع على رسم صورة لحياة شاعر أثناء العقود الأخيرة من القرن العشرين والعقدين الأولين من الألفية الجديدة، حياة يشتبك فيها العام والخاص. وتقوم الأحداث الخارجية – سياسية وغيرها - في مؤخرة الصورة، ولكن البؤرة دائماً هي فن الشعر محور حياة موشن، بل مبرر وجوده ذاته.
وأهم علامات الطريق في حياة موشن، كما يسجلها، هي ما يلي: في الفترة الفاصلة بين انتهائه من المرحلة الثانوية والتحاقه بـ«كلية الجامعة» بجامعة أكسفورد التقى بفتاة تدعى جوانا صارت زوجته وهما ما زالا طالبين جامعيين. انتهى الزواج بالطلاق وأعقبته زيجتان أخريان. وبعد حصول موشن على الليسانس شرع في كتابة رسالة للماجستير عن الشاعر الإنجليزي إدوارد توماس تحت إشراف الشاعر والمحاضر جون فولر.
ومن الأحداث الشخصية التي يذكرها موشن أيضاً أن أباه أصيب بالسرطان في العظام (كان قد تزوج بعد وفاة الأم). وكما بدأ الكتاب بوفاة الأم فإنه ينتهي بوفاة الأب.
هذا عن الجوانب الشخصية من حياة موشن. أما عن الجوانب العامة ونشاطه الأدبي والوظائف التي تقلدها، فإنه يخبرنا بأنه بدأ ينشر قصائده في عدة مجلات ودوريات. وحصل على وظيفة محاضر في الأدب الإنجليزي بجامعة «هل»، وكان أمين مكتبتها هو فيليب لاركن لأكثر من عشرين عاماً. وفيما بعد استقال موشن من وظيفته في جامعة «هل» وعاد للعيش في أكسفورد، وتولى رئاسة تحرير مجلة «بويتري رفيو»، وغدا مشرفاً على برنامج للكتابة الإبداعية في كلية «هولواي الملكية» بجامعة لندن، واختير شاعراً للبلاط الملكي، ثم منح لقب «سير».
بدأ اهتمام موشن بالكتابة حين تعرف على مؤلف كتاب متواضع موضوعه ثعلب صغير، وبدأ يفكر في الموضوعات التي يمكن أن يكتب عنها، فكان أول ما تبادر إلى ذهنه هو حادثة موت أمه، مما قاده إلى التفكير في الموت بعامة وموت المحيطين به في الأسرة والمدرسة والمعارف بخاصة.
وبدأ ينظم الشعر – إلى جانب قراءته - وهو طالب في المدرسة الثانوية. وكان ناظر المدرسة، لحسن الحظ، محباً للشعر ومهتماً بصفة خاصة بشعر الحرب. واستهوته قصائد إدوارد توماس وإميلي دكنسن، لكن لماذا الشعر بوجه خاص؟ لمَ لا يختار شيئاً أكثر إدراراً للربح المادي؟ تراكمت هذه الأسئلة في ذهنه، ثم كان الجواب: «الشعر لأنه صوت المعاناة؛ لأنه قد يحفظ ذكرى أمي في كلمات؛ لأنه فرار من الماضي وإعلان استقلال؛ لأنه ذو سحر خاص وجمال لا يقاوم؛ لأن أشكاله دعوة إلى شعور أشد عمقاً وفكر أكثر دقة؛ لأنه يمثل التكثيف والاستقطار؛ لأنه ينتمي إلى كل إنسان؛ لأنه ابن عمومة للامعنى، وهو مع ذلك يقول الحقيقة بطريقة غير مباشرة؛ لأنه منعزل؛ لأنه يجعل العزلة سبيلاً للتواصل؛ لأنه - بتعبير بايرون - (شعور بعالم سابق ومستقبل)؛ لأنه لا يحوجه إلى أسباب أو أعذار؛ لأنه ليس شكلاً من أشكال المعنى وإنما هو طريقة للوجود».
سؤال آخر كان يطارده: كيف يغدو شاعراً حديثاً؟ كيف يحب عظماء الشعراء الموتى ويترك كلماتهم تتغلغل في مسامه ومع ذلك لا يكون مجرد صدى مردد لأصواتهم؟
صدر أول ديوان لموشن (وكان ديواناً صغيراً في خمسين صفحة) عن دار نشر «كاركانت» التي يشرف عليها الناقد مايكل شميت في 1978. كان الديوان مؤلفاً من ثلاثة أقسام: الأول قصائد متفرقة، والأوسط قصيدة قصصية طويلة نال عنها جائزة «نيودجيت» للشعر بجامعة أكسفورد، والثالث قصائد عن أمه.
ماذا كانت محركاته للكتابة؟ يقول: «كانت الكتابة كما يراها ذهني سبيلاً لرسم خريطة للزمن، لدوائره وخطوطه المستقيمة على السواء، وكانت الكلمات على الصفحة سبيلاً لقول: إني هنا». ويقول: «بدأت أكتب لأن الكتابة موقع يوفر لي الخصوصية؛ لأنها أعانتني على تعميق ما أشعر به (وأحياناً على فهم ذاتي بطريقة أفضل)»، فالقصائد «طريقة لتقبل ما هو محتوم، وأيضاً لإيقاف الزمن أو الخطو خارج الزمن».
ويعبر عن الصعوبات التي يواجهها الشاعر فيقول: «كانت الكلمات التي أريد أكثر ما أريد أن أستخدمها في قصائدي وراء متناولي دائماً»، إلى أن كان يوم شرع فيه في كتابة قصيدة عن ثياب أمه الراحلة (ظل أبوه عدة سنين يحتفظ بثياب زوجته، على سبيل الوفاء لذكراها، في علية البيت)، فإذا بالكلمات تواتيه وتستجيب لما يريد أن يقوله وكأنها استرجاع لذكرى.
وطموحه تعبر عنه الكلمات الآتية: «في ممارستي الشعرية كنت أطمح إلى توسيع نطاق العقيدة الغنائية، وأن أقاوم إغراء النظم حين أرتطم بخبرة شخصية حميمة كالحب أو الأسى أو الوحدة بحيث لا تعدو القصيدة أن تكون صرخة إيقاعية. وبدلاً من ذلك أردت أن أصطنع مقاربة أكثر موضوعية: أن أكتب قصائد قصصية يبدو على السطح أنه لا صلة لها بظروف حياتي الشخصية، مما يكفل أن تخرج واسعة النطاق متنوعة الاهتمامات، ولكنها تظل في الوقت ذاته مستلهمة من مشاعر شخصية قوية. أردت بمعنى آخر أن أكون انطوائياً وانبساطياً في آن، أن أوفق بين الغنائي والقصصي».
بدأ اهتمام موشن بالكتابة حين تعرف على مؤلف كتاب متواضع موضوعه ثعلب صغير... وبدأ يفكر في الموضوعات التي يمكن أن يكتب عنها
ومن الأجزاء الممتعة في كتاب موشن ما يرويه عن شعراء عصره الذين تعرف عليهم، وملاحظاته عن شخصياتهم ومظهرهم وسلوكهم، وصلاته بهم. من هؤلاء الشعراء و.هـ. أودن، وروبرت لويل، ووليم إمبسون، وشيمس هيني، وفيليب لاركن، وتد هيوز.
إن شهادة موشن في هذا الكتاب إضافة عصرية إلى شهادات سابقة عبر القرون. فنحن نتذكر؛ إذ نقرأه، القصائد التي نظمها هوراس اللاتيني وبوالو الفرنسي عن «فن الشعر». وفي الأدب الأميركي نسترجع مقالة للقاص والشاعر والناقد إدجار آلان بو، عنوانها «فلسفة الإنشاء» وصف فيها نظمه لقصيدته المسماة «الغراب»، وفي القرن العشرين شرح هارت كرين في بعض رسائله كيف نظم قصيدته «الجسر». وكتب أرشيبولد ماكليش قصيدة عنوانها «فن الشعر» ختمها بقوله: «على القصيدة أن تكون، لا أن تعني». وعربياً، كتب عدد من الشعراء من زوايا مختلفة عن حياتهم في الشعر: عبد الوهاب البياتي، ونزار قباني، وأدونيس، وصلاح عبد الصبور، ومحمد إبراهيم أبو سنة، وغيرهم. وفي كتاب أستاذ علم النفس الدكتور مصطفى سويف عن الإبداع الفني، في الشعر بخاصة، شهادات عدد من الشعراء والكتاب عن طرقهم في الكتابة، ومراحل تطورهم، والمؤثرات الذهنية والوجدانية والحياتية التي دخلت في تكوين أعمالهم.
وُلد موشن في لندن عام 1952 لأب حارب في الحرب العالمية الثانية وكان من الجنود الذين هبطوا على شاطئ نورماندي في 1944، وأم تدعى جيليان، وكان له أخ أصغر يدعى كيت التحق بكلية الزراعة، ثم اشتغل تاجر بذور. وتلعب الأم دوراً مهماً في هذه الذكريات، وكانت قد لقيت حتفها من جراء حادثة سقوط عن صهوة جواد ارتطم حافره المعدني برأسها، مما أحدث لها نزيفاً في المخ كانت فيه نهايتها بعد أيام قضتها في المشفى. وستخلف هذه الحادثة أثراً باقياً في وجدان موشن وفي قصائده.