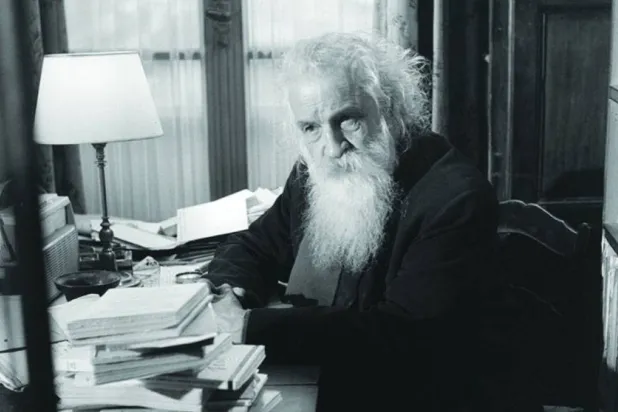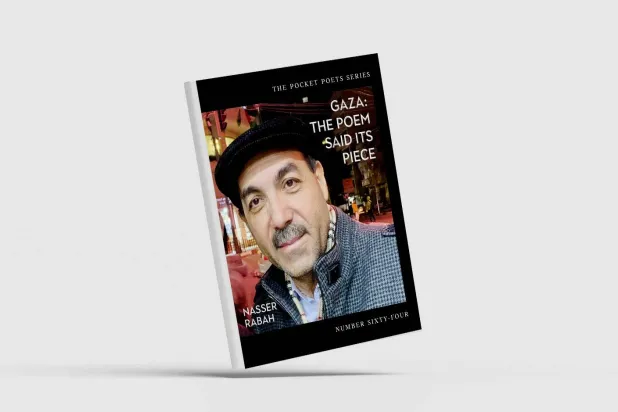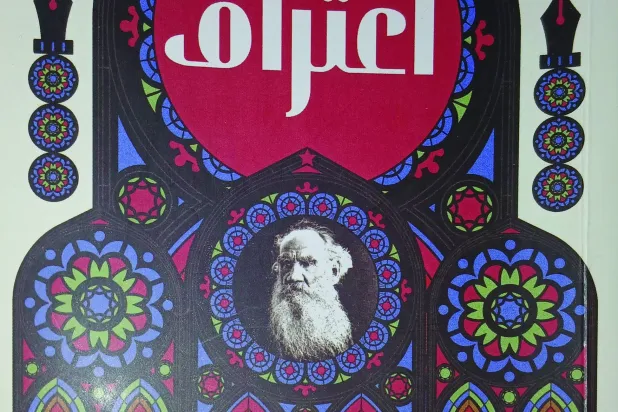هل الهويّة الجماعيّة متطرّفةٌ بحدّ ذاتها؟ إذا كان الأمر صحيحاً، بَطَلت كلُّ إمكانات الانتماء الجماعيّ. المنهجيّة الأنسبُ تقتضي أن نستخرج من الهويّة العناصرَ التي تنطوي على قابليّات التطرّف. ولكن هل نستطيع أن نتفحّص العناصر التأسيسيّة في الهويّة الذاتيّة تفحّصاً نقديّاً سلميّاً من غير أن نجرّ علينا وعيدَ الآخرين وحُكمَهم الإقصائيّ؟ لا بدّ أوّلاً من التذكير الوجيز بالعناصر الأساسيّة التي تتكوّن منها الهويّة الجماعيّة: العرق؛ الأرض وموقعها وبيئتها ومناخها؛ اللغة ومبانيها ومقولاتها ومعانيها؛ التصوّرات الثقافيّة المرتبطة بالاختبارات الوجدانيّة الدِّينيّة والفكريّة والأدبيّة والفنّيّة؛ التاريخ الذي يحتضن اختبارات الوجدان الجماعيّ المعتني بتدبّر المعيّات الإنسانيّة المتواجهة.
ذكرتُ العناصر التكوينيّة هذه وفق ترتيبها المنطقيّ؛ إذ إنّ الجماعات الإنسانيّة أدركت ذاتَها أوّلاً في رباطٍ أصليٍّ، جعلها تعتقد أنّ لها عرقاً خاصّاً يفصلها عن الأعراق الأخرى. غير أنّ الأبحاث الأنتروبولوجيّة أظهرت أنّ العرق مفهومٌ ملتبسٌ لا يُعبّر عن حقيقةٍ تاريخيّةٍ موثوقةٍ، لا سيّما حين اتّضح للجميع أنّ اقتران الجماعات بالأوضاع الجغرافيّة، والأحوال المناخيّة السائدة في الأرض المستوطَنة، جعل التطوّر البيولوجيّ ينحو منحى التمايز والتفرّد. لو نشأ اليابانيّون في الصحراء العربيّة، لاكتحلت عيونهم بضياء السماء المرصّعة بنجوم الليل الساكن. وعليه، يمكن القول إنّ العرق مقترنٌ بطبيعة الأرض والبيئة والمناخ، وما ينجم عن هذا كلّه من آثار التغيير البيولوجيّ الحاسم.
من الطبيعيّ إذن أن تحتلّ الأرض المرتبة الثانية؛ إذ إنّ الجماعات الإنسانيّة غالباً ما تنحت هويّاتها بالاستناد إلى اختبارات الانتماء الجغرافيّ الأصليّ. أعتقد أنّ الجغرافيا عنصرٌ حاسمٌ في تعيين الهويّة الجماعيّة؛ إذ يشعر الإنسانُ بأنّ احتضان الأرض أشبهُ برحم الأمّ، منه تنبثق الكائناتُ انبثاقاً عفويّاً. بيد أنّ الأرض ليست ملكَ الناس الذين يستوطنونها، بل الحضنُ الرؤوف الذي يجمع ولا يُفرّق. إذا شاءت مصادفاتُ الدهر أن تحلّ هذه الجماعة أو تلك في هذه الأرض أو تلك، فهذا لا يعني أنّ الأرض أصبحت خاضعةً لمشيئة القوم المستوطِنين. كلّنا ضيوفٌ على الأرض، ولا أحد منّا في مقام المالِك المطلق.
من الضروريّ أن يتذكّر الناسُ هذه الحقيقة؛ إذ إنّ مصير الأرض مقترنٌ بالوهم التملّكيّ الذي أفضى إلى المنازعات والاقتتال. أمّا الوجه المشرق في ذلك، فالقولُ بارتباط اللغة الوثيق بما يختبره الإنسانُ من علاقة حميمةٍ بالإيحاءات المنبعثة من جماليّة الأرض المسكونة. يجمع علماء اللسانيّات على أنّ خصائص اللغة تقترن جزئيّاً باختبارات الانتماء إلى الأرض. ومن ثمّ، تتجلّى اللغة حاملةً اختبارات الوجدان الفرديّ والجماعيّ في سكنى الأرض. من صميم هذه الاختبارات تنعقد التصوّراتُ الوجدانيّةُ الجماعيّةُ، يُعبّر عنها الناسُ تعبيراً ثقافيّاً، يتناول جميع حقول الإفصاح، سواءٌ في الجماليّة الأدبيّة، وفي الصوغ المفهوميّ الفكريّ، وفي الرمزيّة الفنّيّة، وفي الروحيّة الدِّينيّة.
أمّا العنصر التأسيسيّ الأخير، فينعقد في مسار التاريخ الذي يختزن اختبارات المعايشة المتطلّبة بين الذات والآخر، سواءٌ على مستوى الفرد، ومستوى الجماعة، ومستوى القوم. لا عجب، والحال هذه، من أن ينطوي التاريخ على عناصر الاختبار الإيجابيّ والسلبيّ، وقد طبعت الوعيَ الإنسانيَّ وفرضت عليه نمطاً معيّناً من التفكير والتعبير والمسلك. لذلك أعتقد أنّ خصائص الهويّة الجماعيّة لا تكتمل إلّا حين نُمسك بجميع هذه العناصر، فنستجلي أثرها في مسار نشوء الوعي الذاتيّ الفرديّ والجماعيّ نشوءاً مُقترناً بما اختزنه التاريخ من اختباراتٍ حاسمةٍ.
من الممكن الآن أن نبحث في العناصر التأسيسيّة هذه عن قابليّات التطرّف الكامنة في الهويّة الجماعيّة. لا أعتقد أنّ العناصر الخمسة هذه تحمل في حدّ ذاتها خطرَ التطرّف، بل الخطر يأتي من بناء الوعي الجماعيّ الذي يتصوّر العرقَ مدعاةً للافتخار والاستكبار، والأرضَ تسويغاً للتملّك الأنانيّ، واللغةَ سبيلاً إلى الهيمنة على وقائع الحياة، والثقافةَ مبرّراً للتفوّق النوعيّ، والتاريخَ بُرهاناً على عظمة الذات الجماعيّة. ولكن من أين يأتي الانحرافُ الخطيرُ هذا في التصوّر الجماعيّ؟ من الواضح أنّ الأصل في ذلك كلّه وعيُ الناس، الذي نحتته التأويلاتُ التضليليّةُ المتراكمةُ في حياة الجماعة. أمّا هذه التأويلات فتقترن في قدرٍ ضئيلٍ منها بتراكمات التاريخ، وفي قدرٍ عظيمٍ بمصالح الأنظومة المقتدرة الحاكمة، سواءٌ في حقل السياسة والاقتصاد والآيديولوجيا الدِّينيّة والقوميّة، وكذلك الفكريّة والعلميّة والإعلاميّة.
من المستحيل أن توحي لنا أرضُنا بالتطرّف. ومن الخلف أن تنطوي لغتُنا على عبارات العنف والإقصاء والدينونة. ومن السخف أن يُسخّر الناسُ الثقافةَ أو الفنَّ أو الدِّين لمناصرة تواطؤاتهم المنفعيّة. العلّة الأصليّة كامنةٌ في تأويل العناصر التأسيسيّة التي منها تنبثق هويّة الجماعات الإنسانيّة، وفق ما تَرسمه لها مصادفاتُ الزمان. لذلك من الضروريّ أن يعتصم الجميع بتواضع الكائنات الهشّة التي تستضيفها الأرضُ استضافةً مجّانيّةً مُطلقةً. ليس لأيّ إنسانٍ من حقٍّ كيانيٍّ شرعيٍّ أصليٍّ، يُخوّله الاستحواذَ على الأرض والبيئة والسماء والفضاء والكون. أمّا هويّاتنا الجماعيّة فثمرةُ تفاعلاتنا التاريخيّة الممهورة بانطباعاتنا البشريّة البنيويّة.
العرق مقترنٌ بطبيعة الأرض والبيئة والمناخ وما ينجم عن هذا كلّه من آثار التغيير البيولوجيّ الحاسم
هل من سبيلٍ إلى الانعتاق من تأويلات التطرّف العنفيّة الجاثمة على هويّاتنا الجماعيّة؟ رأسُ الحكمة الاعترافُ بأنّ الهويّة الجماعيّة ليست كتلةً صلبةً من الحقائق والتصوّرات والمضامين المكتملة الجاهزة، بل مسارٌ حيٌّ من التكوّن التاريخيّ المتدرّج. مشكلة الهويّة أنّنا لا نعاين أطوار نشوئها الزمنيّة المتعاقبة، بل نتلقّفها في حلّةٍ نظنّ أنّها الهيئة التاريخيّة النهائيّة التي استقرّت عليها. جرّاء المدى الزمنيّ الطويل الذي اختمرت فيه أطوارُ التحوّل والتبدّل والتقويم الذاتيّ، لا يستطيع المرءُ أن يعاين الحركة اللصيقة بالهويّة، بل يكتفي بإدراك الثبات الراسخ فيها. زدْ على ذلك أنّ اختبار الحركة في الهويّة يُقلق الوعي الإنسانيّ الفرديّ، ويجرّده من مُسلّماته ومُستمسكاته ويقينيّاته الاطمئنانيّة. ما من إنسانٍ يرغب في اختبار الاضطراب الكيانيّ حين يعاين التحوّلَ الذي أصاب هويّتَه في معترك الاختمار الثقافيّ المديد الزمن.
السبيلُ الآخر يقضي بأن نميّز ثلاثةً من التصوّرات التي نصوغها من أجل التعبير عن هويّاتنا صوغاً يَحكم وعيَنا التاريخيَّ: التصوّر الثقافيّ الأوّل، منبثقٌ من خصوصيّة الحضارة التي ننتمي إليها انتماءَ التأثّر بالعناصر الخمسة هذه: التصوّر الثقافيّ الثاني، منبعثٌ من التأويلات المتطرّفة التي يحرّضنا عليها أهلُ الاقتدار في السياسة والاقتصاد والآيديولوجيا؛ والتصوّر الثقافيّ الثالث، ناشئٌ من إخضاع حقائق الوجدان الجماعيّ لمحكمة التمييز التي تستند إليها شرعةُ حقوق الإنسان الكونيّة في سعيها الدؤوب إلى تهذيب الإنسان واستنقاذه من بهيميّته المتربّصة به. واجبُنا أن نعتصم بالتصوّر الأوّل مستضيئاً بالثالث، وأن ندين التصوّر الثاني. ذلك بأنّه من أقبح أشكال الحيوانيّة المفترسة هذه، أن تتحوّل الهويّات الجماعيّة إلى مُعتركات الإفناء العبثيّ.