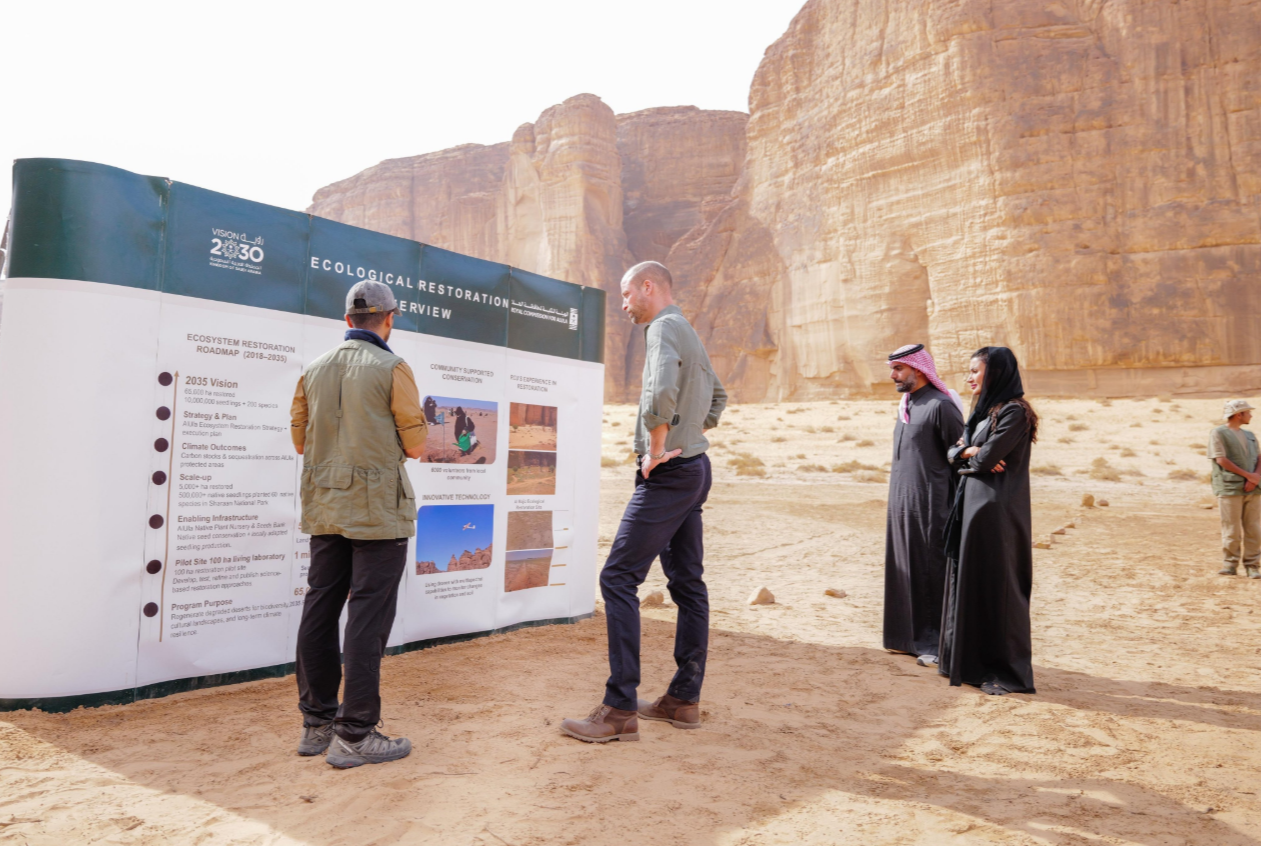تبِعَ لقاء مي شدياق مع أنس بوخش في السعودية، تعرّضها لحادث يُضاف إلى مسار حياة تراجيدي تمتهن عناده. حين سألها سؤالَ افتتاح حلقات «ABTalks» الشهير، «كيف حالك؟»، تمهّلت قبل أن تُخبره بأنّ الوضع يصبح أفضل. يطول حوارهما ألمها العميق وقدرتها على التحمّل. صنفها لا يُهزم، تقارع المآسي بأكثر ما يستفزّ الحياة: الابتسامة في عزّ الزعل.
يظهر أنها تسرد قصص العذاب، لكنها في الحقيقة تروي فن الأمل. يصمت الإعلامي الإماراتي وهو يصغي إلى تجارب إعلامية لبنانية بُترت ذراعها وقدمها واحترق جسدها بمتفجّرة زُرعت تحت مقعد سيارتها، مُدعَّمة بمائة غرام من مادة الـ«C-4» لضمان الشواء. لا تتباكى ولا تثير الشفقة. مثل سروة تتصدّى للعصف بإدراك بديع بأنها تتمايل أمامه، لكنه يعجز حيال أوراقها المُخضرَّة.
تخبره القصة فيصغي. يتألق «ABTalks» («يوتيوب»، «نتفليكس»، «شاهد»)، لتحلّي مقدّمه بأذن تتّسع لكل الحكايا. تعود الابنة المدلّلة لأب غادر باكراً ليتبعه الأخ ويعمّقان وحشة الداخل. تشاء دمعةٌ زيارة عين ترى النور في نهاية كل نفق، لكنها تعدّل مسارها للإقامة حيث الاحتجاب والتواري؛ في الصميم والمستور واختلاء المرء بالنفس والشكوى الصامتة.
فاق عدد الجراحات الأربعين، ورغم المشقّة عادت إلى الشاشة لرفع الصوت. تهتزّ الأبدان وتُنهَك جراء الأحوال، إنما الإرادة تسير بالعكس فتشتدّ صلابةً باشتداد القسوة. لم يكن أنس بوخش أول مَن يسأل مي شدياق عمّا يجعلها تستمر وسط كل هذا؟ يتردّد السؤال على مسمعها، وأحياناً تتوه الإجابة. لكنها تستمرّ لأنّ الأمرَّ يُهوِّن المُرّ، ومَن فقدت الوالد والأخ، وهما غلاوة العمر، وأكملت الطريق رغم الجنازتين، لن يردعها بتر ذراع وقدم عن الوصول، وهو عندها لا يتحقق وإن بلغت القمم.
تصبح قاعدتها «ابكِ تبكِ وحدك، اضحك تضحك لك الدنيا»، فتُخبّئ الأحزان. لطالما هشَّمت هواتف، وهي أسرع الطرق للتعبير عن الغضب بما يتوافر بين اليدين، فتسدّدها نحو الجدران الشاهدة على تبدّل المزاج وسطوة الحرقة، لكن ما يغلب هو حجم الإرادة وقرار الابتسام.
تظهر مي شدياق الإنسانة، مصطحبة معها الدكتورة في الإعلام الخائفة على المهنة من التحولات والرخاوة. كأنها كلٌّ، يتعذّر سلخها إلى أجزاء. من تربية الأسرة إلى حماية قيم الصحافة، المسألة واحدة والنظرة متشابهة. تُعدّد لمُحاورها بعض الإنجازات، وتُذكّر بأنها مُستَمدّة من بيت أسَّس ومنح الركيزة المتينة، ثم أطلق إلى الحياة نموذجاً للمرأة الجبارة.
تعود الصور ولعلّها اشتمّت رائحة جسد مسَّته النار ولم تكوِ عزيمته. تسرد قصة يوم الأحد من عام 2005 حين أصبحت هي الخبر. يتساءل بشرٌ عن طعم الإحساس الذي يسبق الموت، ومي شدياق تذوّقته. كادت تلتحق بالأحبّة في العلياء، لكنّ الشظايا شاءت استثناء القلب، ليُبقي على خفقانه ويُهديها فرصة أخرى.

بالقهقهة الأنيقة تهزأ: «كتير هلقد على حياة واحدة. لا بأس لو وُزِّع كل هذا على ثلاث حيوات». حرب وموت عزيزين ومحاولة اغتيال ومهنة صعبة وظروف لا ترحم، ثم تُفجَّر بيروت وتطال النيترات المدافن، مرقد أحبّتها، والشوارع حيث الذكريات. تنظر إلى أنس وتُلخّص: «في 2005 سرقوا مستقبلي، أما في 2020 فسرقوا ماضيَّ».
مع ذلك، «منرجع منكفي». المهم ألا يُشفق الإنسان على نفسه فيهوّن الشفقة عليه. مي شدياق تولّد قوتها من ضعفها لتستمر. يتحرّك فيها صراع حتمية القدر مع تدخّل المرء في صناعة أقداره، ولا تعلم تماماً إن ساقها قدرها إلى ما هي عليه أم أنها مُحرِّكة مصيرها. تميل إلى اعتقاد أنها رسمت طريقها بنفسها وشاءت مدَّه بالألوان والضوء، إنما ثمة ما تربّص فتسرّبت أحزان تُذعن إليها حيناً وتردعها أحياناً. «أنا إنسان»، تقول. كلمتان تفسّران طبيعة التناقضات ومنطق الإحباط والأمل.
يعود الأمر إلى ما تسمّيها «التركيبة». بالنسبة إليها، هناك ما يُمهِّد، والأحداث تتوالى قبل بلوغ الذروة. فهي، بخسارة الأب قبل أوانه، والأخ وهو صغير أصابته «اللوكيميا» فاستعجل الغياب، ثم وطأة الحرب ومسؤولية أن تتألف الأسرة من أُم وفتيات، اشتدّ عودها لتُواجه. بدا البتر امتداداً لكل ما سبق، للفقد وتعدّد أشكال الجنائز، فلم يكن عصياً على «الاستيعاب». حصّن القدر نجمة الإعلام اللبناني من الانجراف وأتاح امتلاك جذور تتشبّث في الحياة وتقرّر احتواءها. وبينما الأخيرة تظنّ أنها الأقوى، تلقّنها شدياق درساً في عدم الغرور وحسم المعارك دائماً لصالحها، لتكون أيضاً المنتصرة.
يسألها مُحاورها عمّا يُخيفها بعد النجاة من الموت وسائر محاولات رميها في الفراش. تسرح وسط الصمت، لتجيب: «أخشى أن أحتاج إلى أحد وأن أفقد صفائي الذهني. أخاف الإثقال على الآخرين. أنا خفيفة، هكذا أودّ أن أبقى». لقبها الفراشة، مثلها رشيقة وحرة.