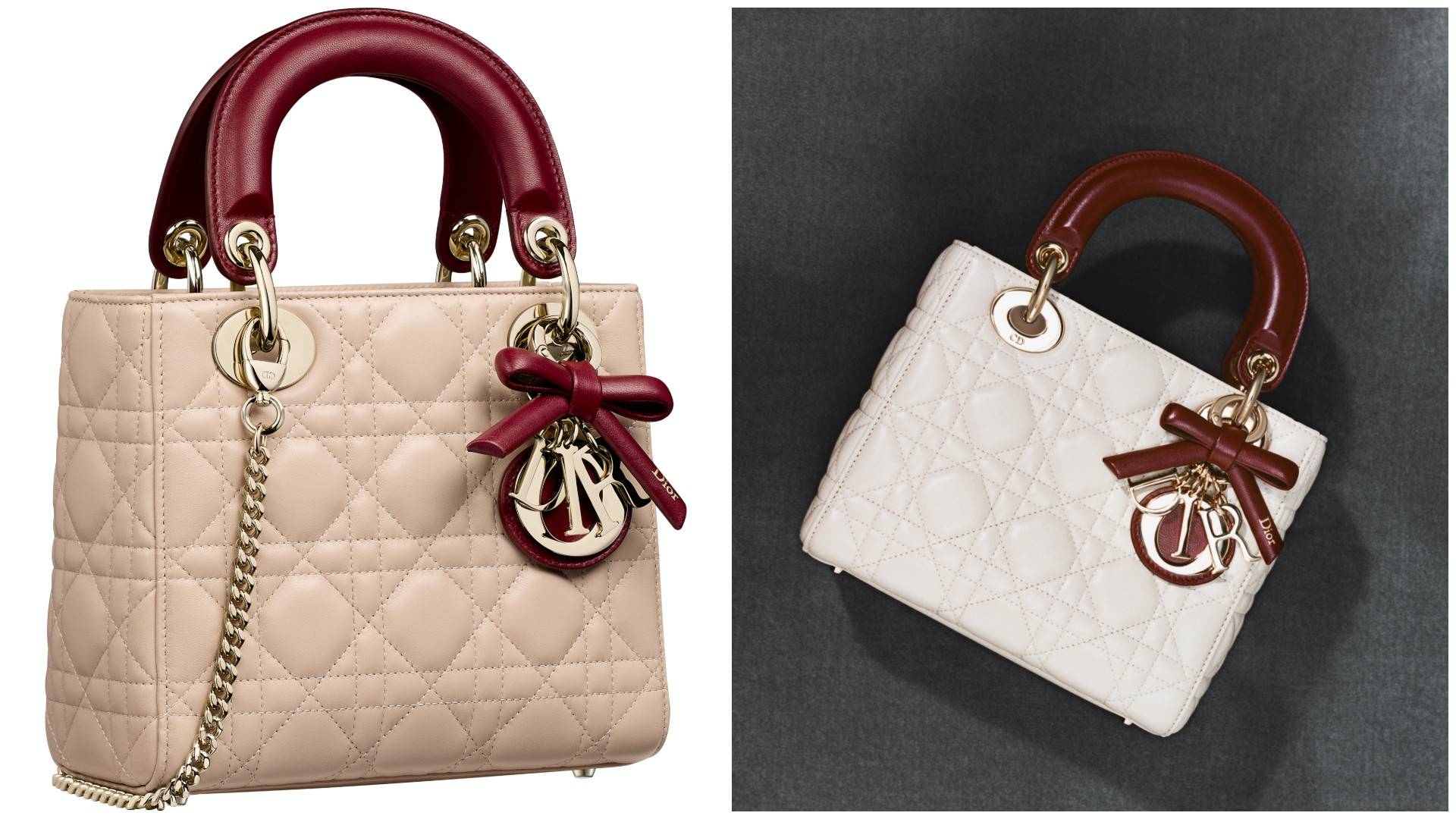عندما تُذكر أسماء عطارين أتحفونا بعطور فاخرة، فإن أسماء كثيرة تتبادر إلى الذهن من جون كلود إلينا، بيير بوردون، ودومينيك روبيون إلى إدوارد فليشيير، وأوليفيا جياكوبيتي، وموريس روسيل، مرورا بإدمون رودنيتسكا، وآخرين، لكن عندما يُذكر اسم خبير عطور بمرتبة مايسترو أمين على صناعتها وحريص على الحفاظ على تميزها، فهناك اسم واحد في الساحة العالمية حاليًا وهو فريدريك مال، مؤسس دار «إيديشن دو بارفان» Editions de Parfums.
عندما أسس هذه الدار في عام 2000، كانت فكرته تتلخص في الارتقاء بهذه الصناعة إلى مستوى فني بعيد عن الابتذال التجاري. اختار عشرة من أكبر العطارين واقترح على كل واحد منهم ابتكار عطر لا تنازلات فيه من ناحية الخامات أو الوقت الذي يستغرقه أو التكاليف، على شرط أن تأتي النتيجة بالمستوى الذي يطمح إليه. كان مقتنعًا بأنه: «عندما تختار أحسن عطار وأفضل الخلاصات فإن المتعة تكتمل».
ما قام به فريدريك مال أيضًا أنه رد لهؤلاء العطارين الاعتبار، بكتابة أسمائهم بالبنط العريض على ابتكاراتهم، عوض بقائهم في الظل كما كان الحال في السابق عندما كانت مهمتهم تنتهي بمجرد توصلهم للخلطة التي تبيع لبيوت الأزياء وشركات التجميل الكبيرة. وبالفعل راقت الفكرة لهم، ولم يترددوا في التعاون معه، ما كان ثمرته حتى الآن عطورًا لا مثيل لها مثل «كارنال فلاور»، و«بورتريت أوف ألايدي»، و«لو بارفان دو تيريز»، و«إين فلور دو كاسي»، و«فتيفير إكسترا أوردينير»، وأخيرا وليس آخرًا «ليل»، العطر المستوحى من الشرق وموجه إليه.
غني عن القول إن هذه الخطوة أثارت الانتباه والإعجاب، واقتدت بها شركات العطور وبيوت الأزياء. فالآن أصبح للعطارين اسم وصورة، ولا يكتمل حفل إطلاق أي عطر من دون حضور «الأنف» المبتكر، لما يعطيه حضوره من ثقل للعطر. وهذا يعني أن فريدريك مال أخرجهم من الظل وحوَّلهم إلى نجوم.
في لقاء خص به «الشرق الأوسط» مؤخرًا، بمحله الجديد بـ«14 بيرلينغتون أركايد» 14 Burlington Arcade بمنطقة مايفير، تحدث مال عن علاقته بالشرق الأوسط وفلسفته في صناعة العطور عمومًا، مؤكدًا أنه يرى أن مهمته تتلخص في إعادة الحميمية والتميز لهذه الصناعة بعد أن أصبحت تجارية إلى أقصى حد، وأصبح الكل يستسهلها جريًا وراء الكسب، موضحًا: «عندما يكون طموحك إغراء كل الناس، فإنك تصبح مملاً وتفقد روحك وشخصيتك».
ما تجدر الإشارة إليه أن فريدريك ليس عطارًا بالمعنى المتعارف عليه، فهو لا يخلطها ويبتكرها، لكنه يفهم كل تقنياتها وأسرار مكوناتها، وكأنها كتاب مفتوح حفظه عن ظهر قلب منذ ولادته، بحكم أنه ولد في أسرة تتقن لغة العطور، وبيت تفوح من بين جدرانه روائحها الغنية. فجده هو سيرج هيفتلر، مؤسس عطور كريستيان ديور، ووالدته كانت مديرة فنية في نفس الدار، كما كانت الشقة التي ولد ونشأ فيها ملكًا في فترة من الفترات لجون بول غيرلان، العطار المشهور، وهو ما يعلق عليه مبتسمًا: «كنت أشم العطور في الجدران».
أول ما يواجهك عندما تدخل محله في رواق «بيرلينغتون» بمايفير، إلى جانب القارورات المرصوصة على الأرفف الخشبية، صور بالأبيض والأسود لكل العطارين الذين تعاون معهم حتى الآن. يشرح بأن العلاقة التي تربطه بهم، مبنية على مفهوم المشاركة والاحترام أكثر منها مجرد علاقة عمل تنتهي بانتهاء العمل، مشبهًا نفسه برئيس تحرير «عطور»، يقترح فكرته، ويترك للمحررين أو «المؤلفين» مطلق الحرية في صياغتها حسب رؤيتهم. ولأنه مقتنع تمامًا بقدراتهم الإبداعية، فهو لا يتدخل إلا في بعض الحالات النادرة جدًا. وطبعًا هذه العطور المتميزة، تحتاج إلى محلات تليق بها وتتوجه إلى زبائن أكبر، لهذا بعد باريس، افتتح محلاً في نيويورك، صممه المهندس ستيفن هال، وأخيرًا وليس آخرًا وصل إلى لندن، معترفًا بأنه تردد طويلاً قبل أن يتخذ هذه الخطوة، لأنه لم يكن متحمسًا للندن، لأنها أصبحت وجهة متوقعة بالنسبة للكل وهو يختلف عن الكل. يشرح: «كنت أفكر في روما، لكن لم يتحقق الأمر، وعندما أصبحت لندن خيارًا لا بديل عنه، كان لا بد أن تتم العملية بشروطي وبمنظوري الخاص، بأن يكون المحل في موقع مميز بمعماره وجيرانه، وأصدقك القول إنني عندما زرت رواق (بيرلينغتون) هذا شعرت أن وقت النقلة قد حان»، مضيفا أن «التسوق والتسرع لا يتماشيان مع بعض.. فللتسوق متعة يجب تذوقها ببطء، وهذا ما يوحي به هذا الرواق.. كل ما أتمناه ألا يخضع لتغييرات عصرية جذرية، وأن تبقى فيه محلات الجواهر لأنها تضفي عليه بريقًا». تجدر الإشارة هنا إلى أن الرواق قد يتحول قريبًا إلى وجهة لعشاق العطور، فبعد «شانيل» و«بينغهاليون» و«فريدريك مال» ستُفتتح فيه قريبًا محلات لكل من «روجا داف» و«باي كيليان».
عندما تدخل محل «فريدريك مال» حضر نفسك بألا تتفاجأ بمساحته الصغيرة، رغم أنه يمتد على ثلاثة طوابق، ولا ببساطة ديكوره الذي تغلب عليه ألوان الخشب الدافئة وعلب العطور الحمراء والسوداء المتراصة جنب بعض، والتي أضفت عليها صور بالأبيض والأسود لكل العطارين الذين تعاون معهم حتى الآن واحتلت جدارًا بالكامل، لمسة فنية، فسرعان ما ستكتشف أن المحل مثل قارورة ثمينة ما إن تفتحها حتى تدهشك بما تكتنزه بداخلها. صغر المكان وديكوره المرتب، يجعل نصبًا أنبوبيًا مستديرًا في الوسط يمتد من الأرض إلى السقف تقريبًا، يبدو نشازًا للوهلة الأولى خصوصًا إذا اعتقدت، مثلي، أنه قطعة فنية معاصرة مستوحاة من مسلسل «ستار تريك»، لكنك ستغير رأيك سريعًا عندما يضخ مدير المحل، عطرًا بداخله ويسألك أن تدخل رأسك من خلال باب جانبي لشمها. فهذه طريقة جديدة للتعرف على العطر الذي اخترته من دون حاجة إلى تجربته على بشرتك.
بمجرد صعودنا إلى الطابق الأول وجلوسنا يعود فريدريك مال للحديث عن سبب اختياره لهذا الموقع بالذات موضحًا أنه كان بإمكانه الاكتفاء بباريس لا يخرج منها، وخصوصًا أن اسمه انتشر بين النخبة، لكن العصر يتطلب افتتاح محلات جديدة وربط علاقات مع زبائن جدد من أسواق بعيدة، وهو ما اضطر إلى احترامه، لكن بشروطه الخاصة حتى يحافظ على شخصيته وروحه.
يقول إن بدايته كانت في منطقة «سان جيرمان» الباريسية، وليس في شارع سانت هونوريه أو جادة «الشانزاليزيه»، حيث يتقاطر السياح، إلا أن لكل مرحلة استراتيجياتها، حسب رأيه: «فعندما تكون في بداية الطريق، يكون لك زبائن من النوع الفضولي الذي يكون منفتحًا على الاستكشاف، وهو أمر رائع جدًا، لكن عندما تكبر شركتك، يصبح الوجود في موقع يسهل وصول الزبائن من كل النوعيات إليه أمرًا ضروريًا.. لحسن الحظ أن لا أحد سيصاب بخيبة الأمل عندما يأتي إلى هذا الرواق لأنه سيستمتع بمعماره المميز وما يقدمه من منتجات فريدة».
لم تكن فكرة افتتاح محل في منطقة «نايتسبريدج»، مثلاً، مطروحة بالنسبة له لأنها «تفتقد إلى الحميمية»، كما لم تكن واردة في «سلوان ستريت»، لأنه «كلاسيكيًا إلى حد الملل ولا يتمتع بأي جاذبية»، حسب قوله. فكر في مناطق أخرى مثل «بورتوبيلو» و«نوتينهيل غايت»، لكنه وجدها «إنجليزية محضة ذات طابع محلي، بينما لندن عاصمة عالمية، لهذا كان الخيار الأمثل هو منطقة مايفير، التي خضعت لعمليات تجميل ناجحة جدًا في السنوات الأخيرة جعلتها منطقة جذب لصناع المنتجات الفاخرة».
عندما أشير إلى أن كل العطارين تقريبًا يحلمون بدخول محلات «هارودز» كونها البيت الثاني للعرب، يقاطعني قائلاً: «لا تفهميني خطأ، هناك فرق بين أن أوجد بداخل (هارودز) أو في منطقة (نايتسبريدج). الكل يعتقدون أنهم عندما يفتتحون محلات في المنطقة، سينالهم بعض من النجاح التجاري، والحقيقة أن الزبون الذي نستهدف، يستقل سيارته الخاصة أو تاكسي ويذهب إلى وجهة أخرى من دون أن يلتفت إلى المحلات المجاورة، بمجرد خروجه من (هارودز)». يسكت لبضع ثوانٍ وهو يفكر قبل أن يضيف: «ثم إنني لو اخترت تلك المنطقة، لكنت كمن يقول إنني هناك من أجل السياح والربح السريع، وهو ما أرى فيه بعض الابتذال وعدم الاحترام للذات وللزوار في آنٍ واحد».
نفس الأمر ينطبق على موضة «العود»، التي ركبها معظم العطارين، إن لم نقل كلهم، في محاولة واضحة لجذب المتسوق العربي تحديدًا.
هذا التودد المبالغ فيه لا يناسب حسه الباريسي الرفيع، لما فيه من استسهال يرفضه بكل جوارحه، مع أنه كرر مرارًا خلال المقابلة، أنه يحترم الذوق العربي ويريد أن يلبيه، بدليل أنه استعمل العود في عطره الأخير، لكنه أكد أنه وضع شرطًا مهمًا نصب عينيه، وهو أن يبتكره بطريقة مختلفة تمامًا عما هو متوفر في السوق.
فعلاقته بمنطقة الشرق الأوسط ليست وليدة الساعة، بل بدأت منذ أكثر من 12 سنة تقريبًا عندما كانت «دبي مجرد مشروع على ورق تقريبًا، وحركة البناء فيها لا تتوقف، حيث تظهر شوارع ممتدة بلا نهاية على تلال من الرمل.. أتذكر مجمعات التسوق وكيف كانت أكبر وأفضل من المجمعات الأميركية، لكنها تبقى في نظري مجرد مجمعات ضخمة تفتقد إلى الحميمية. كنت مبهورًا بطموح المشروع، ومع ذلك رفضت عندما عرضت علي فرصة كبيرة للعمل هناك. لقد خفت على نفسي أن أدمن على الربح السهل، كما هو الحال بالنسبة لبعض من قاموا بهذه الخطوة في ذلك الحين. فما اعتبره البعض مكانًا بعيدًا عن أوروبا آنذاك، يمكن أن يبيعوا فيه أي شيء، أصبح مفتوحًا على كل العالم، والوصول إليه سهلاً كما أن سكانه يسافرون إلى كل البقاع في الصيف بما فيها باريس ولندن».
كان فريدريك حينها شابًا يحلم بتأسيس دارًا راقية مبنية على الترف أولاً قبل أن يفكر في التوجه إلى دبي أو غيرها، واستغرقه الأمر 12 عامًا، لكنه حقق هدفه بطريقة عضوية، وبمساعدة أفراد من عائلة الطاير، الذين فتحوا له أبواب هارفي نيكولز بـ«مال الإمارات» و«بلوميندايل» بـ«دبي مال».
يبدو أن الحديث عن دبي فتح شهيته للحديث عن منطقة الشرق الأوسط، ومدى افتتانه بثقافتها الساحرة وغموضها، لأنه سارع بالإشارة إلى أنه كان حريصًا على ألا يطرح لها عطرًا عاديًا يكون موضة عابرة، وخصوصًا أنه لا علاقات جيدة بأفضل العطارين في العالم، ويمكنه الوصول إلى أجود الخلاصات والمكونات.
وبالفعل وقع اختياره على العطار المحترف دومينيك روبيون، الذي رحب بالمهمة ورافقه إلى الشرق الأوسط للتعرف على الثقافة عن قرب، أو كما قال فريدريك «لدراسة لغة العطور». استغرقهما الأمر عدة سنوات، وبعد أن تيقنا بأنهما أتقنا هذه اللغة، قررا البدء في عملية الابتكار. يشير: «نعم استغرقت العملية سنوات، قضيناها في التعرف على الروائح في الأسواق وكيفية خلطها وتقطيرها، فضلاً عن البحث عن أفضل أنواع العود». يعلق ضاحكًا: «يمكنك تشبيه عملية شراء العود الجيد في هذه الأسواق بشراء المخدرات، لما تكتنفها من سرية ومناقشات عن أصفى الأنواع وأكثرها ندرة». وحتى يختلف، قرر استعمال العود كأساس فقط، لهذا لم ير داعيًا للإشارة إليه في الاسم بشكل مباشر، عدا أن «إضافة كلمة عود إهانة لذكاء الزبون»، حسب رأيه، أي طريقة رخيصة للتسويق.
كان مهمًا بالنسبة له أن ينطلق من فكرة عربية رومانسية، ولم يجد أقوى من صورة الليل جمالاً وشاعرية في المخيلة العربية «ففي الليل تبدأ حياة جديدة مليئة بالغموض والسحر، حيث تتلألأ السماء بالنجوم ويحلو السهر والسمر»، ما أوحى له بإطلاق «ليل» على عطره العربي. عطر يشكل فيه العود نسبة الربع، وهو ما يعتبر نسبة عالية عندما يكون صافيًا وبجودة عالية، وأضاف إليه كمية وافرة من الورود، تم تقطيرها بعناية كبيرة، لترقى به إلى مستوى غير عادي، سواء تعلق الأمر بخلاصة الورد التركي، أو بورد بلغاريا، الذي يتمتع برائحة مثل التبغ، وفي الأخير جعل كل هذه المكونات ترقص على نغمات من المسك والعنبر ما زاد من قوة وسحر «ليل».
في لحظة صراحة، يتبرع فريدريك مال بالقول إن أغلب العطارين لا يستعملون العود الحقيقي، وفي أحسن الحالات يستعملونه بنسب قليلة جدًا: «95 في المائة منهم يكذبون أو يبالغون عندما يقولون العكس.. هناك الكثير من الكذب في هذه الصناعة، فمرة قال لي أحدهم إنه صنع عطرًا لدوق ويندسور، رغم أني تابعت ولادة هذا العطر، وأعرف جيدًا أنه لم يصنع إلا بعد 10 سنوات من وفاة الدوق. هذا يعني أنه بإمكان أي أحد أن يقول أي شيء للتسويق، ومن دون متابعة، وهو ما يحدث كثيرًا للأسف. نفس الشيء بالنسبة للعود، فهو أكبر كذبة في صناعتنا حاليًا، لأنه كلمة السحر بالنسبة للدعاة، وهذا ما جعلني أتجنب استعماله في العنوان، وفضلت عليها (ليل). والحقيقة، إني سعيد جدًا باختياري، لأنه يجعلني أحلم ويأخذني بعيدًا، وهذا هو دور العطر أساسًا». وربما هذا ما يفسر أنه مع الوقت وجد أن أكبر تحدٍ أمامه ليس منافسة كبار العطارين العالميين، بل الدخول في منافسة مع العطارين المحليين في الأسواق الشعبية، لأنهم يفهمون لغة العطور عمومًا والعود خصوصًا بشكل يشد الأنفاس.
ينتهي اللقاء، وتمشي في الرواق المظلل بسقفه العالي، وأنت منتش بروائح العود والورد التي تتبعك أينما توجهت وتلح عليك إلحاح فريدريك مال أنه يرفض الدخول في منافسة مع أي من الشركات الكبيرة، وأنه عندما فكر في عطر للعرب، أراد أن يتحدى هؤلاء العطارين الشعبيين، الذين احتك بهم لفترات طويلة وتعلم منهم الكثير، وكانت النتيجة أنه بعطره هذا انطلق من الشرق الأوسط إلى العالمية، وليس العكس.
فريدريك مال لـ («الشرق الأوسط»): العود أكبر كذبة في صناعة العطور حاليًا
المايسترو الذي أخرج العطارين من الظل وحوَّلهم إلى نجوم

فريديريك مال

فريدريك مال لـ («الشرق الأوسط»): العود أكبر كذبة في صناعة العطور حاليًا

فريديريك مال
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة