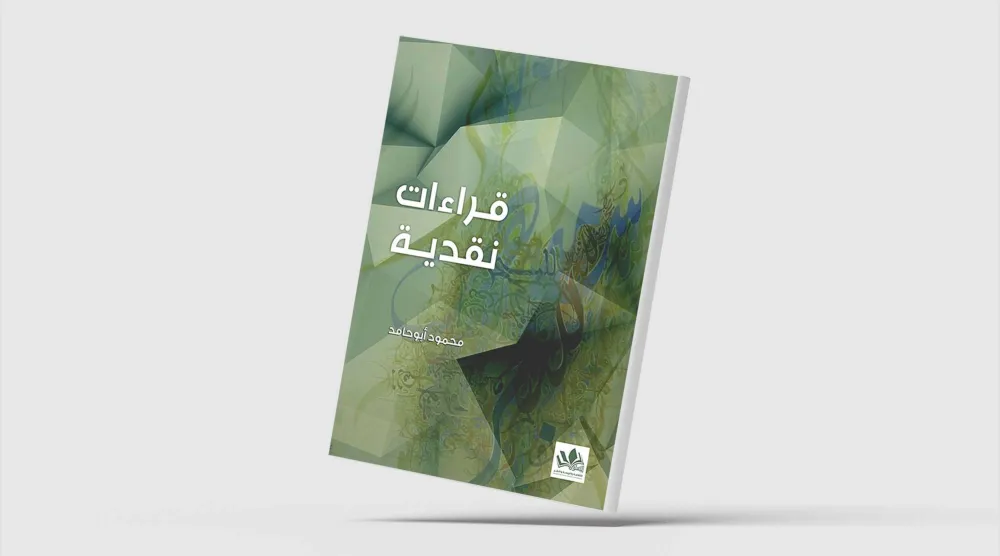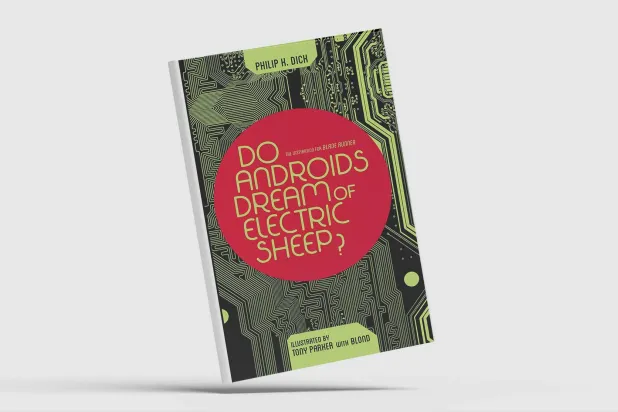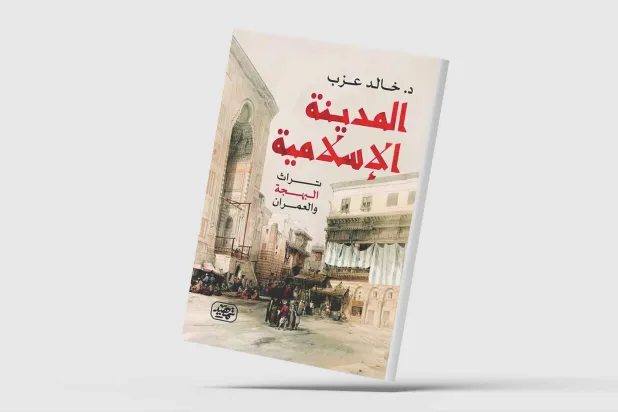في روايته الجديدة الصادرة مطلع العام الحالي، التي حملت عنوان «اليوم جمعة وغداً خميس»، يتطرق الكاتب التونسي سفيان رجب إلى الأقلية اليهودية التي ما زالت متمسكة بالإقامة في تونس، رغم المصاعب التي تواجهها، خصوصاً بعد أن تصاعدت موجات التعصب والتزمت في تونس خلال السنوات العشر الماضية. وقد ركز سفيان رجب روايته على الأقلية اليهودية التي تعيش في مدينة سوسة، ولم يكتفِ بالتحقيق في أوضاع هذه الأقلية المادية والمعنوية، بل تعمق في قراءة التراث اليهودي، وفي تاريخ اليهود في تونس.
ينتمي سفيان رجب إلى الجيل الجديد من الكتّاب. والمؤلفات التي أصدرها إلى هذه الساعة في مجال الشعر، والقصة القصيرة، والرواية جعلت له حضوراً واضحاً في المشهد الثقافي التونسي.
هنا حوار معه...
> واضح أنّك اخترت أسلوب التحقيق في كتابة روايتك حول الأقلية اليهودية في سوسة. كيف حدث هذا التحقيق؟
- لم أكتفِ بقراءة العهد القديم وبعض الكتب التراثية اليهودية كالتلمود والكابالا وكتب موسى بن ميمون، بل التقيت ببعض اليهود في مدينة سوسة، وتحدّثت معهم، واستمعت إلى هواجسهم، ونظرتهم إلى جيرانهم المسلمين في المدينة. في اللقاءات الأولى عادة ما يكون التوجّس والخوف عقبة في طريق الحوار، لكن بتعدّد اللقاءات يرتفع محرار الثقة بيننا، ويرتفع مقابله محرار الصّدق. كنت محظوظاً بلقائي صانع الحلوى الشّهير في مدينة سوسة باسكال تميم، وتحدّثت إليه أكثر من مرّة، حدّثني عن الأيام السوداء التي عرفتها عائلته في سبعينات القرن العشرين. كان يقول إنّه تونسي حتى النخاع ويرفض مغادرة بلاده، وقد توفّي باسكال منذ 3 سنوات، ودفن بمقبرة اليهود بسوسة. كما عدت إلى كثير من المراجع التي تتحدّث عن تاريخ اليهود في البلدان العربية، وإلى الروايات التي تناولت موضوع الأقليات اليهودية في البلدان العربية.
> لماذا اخترت هذا الموضوع خاصة؟
- كتبت هذه الرواية لتكون شهادة ضدّ التعصّب والتطرّف، ودعوة للمحبّة والتسامح وفهم الآخر. كتبت عن المهمّشين والبسطاء الذين دهستهم جرافة الآيديولوجيا دون رحمة. كتبت عن أبناء وطني المنبوذين لأنهم يحملون كتاباً مختلفاً ومعتقداً مختلفاً. هذا هو السّرّ الوحيد لهذه الرواية. بعد إصدارها، تعرّضت إلى التهجّم من بعض المتعصبين. لكن كلّ هذا لا يشعرني إلا بالقوة والثبات. مهمة الكاتب أن يكون حليف النور والإنسانية، لا أن يتستّر بالظلام، ويكون مضخّم أصوات التعصّب وقوميات الدّم. كلّ القوميات المتطرّفة لا تنتج سوى قوميات متطرفة مضادة لها، هذا ما يجب علينا أن نفهمه من درس التاريخ. أنا مصطفّ مع الإنسان أينما كان، ومهما كان معتقده أو كان لونه...
ولأنقد تاريخنا العربي الرافض للأقليات، تاريخ اللون الواحد والفكر الواحد، تاريخ التعصّب وإلغاء الآخر المختلف. إنّ درجة الوعي الحضاري والرّغبة في التغيّر والثورة على ما يكبّل الفكر تبدأ من خلال نقد الذّات. ومن خلال فهم الآخر المختلف. جزء كبير مما يسمّى بالمثقفين العرب يحكمهم التعصّب، لكنهم لا ينتبهون إلى ذلك، ويبنون خطاباتهم الفكرية والجمالية من خلال عاطفة العامة، إمّا جهلاً أو نفاقاً.

> هل شعرت بأنّ طرد الجاليات اليهوديّة من تونس ومن المجتمعات العربية عموماً، مثّل خسارة لتركيبة مجتمعاتنا، خاصة أنّ تلك الجاليات كانت فاعلة في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الفنّي والثقافي؟
- الإضافة التي قدّمها اليهود التونسيون لثقافة بلادهم، في القرن العشرين خاصّة، لا ينكرها إلا جاهل أو جاحد، لا أحد من التونسيين المولعين بالموسيقى التونسية الأصيلة ينسى الشيخ العفريت أو حبيبة مسيكة أو راؤول جورنو أو ميمون التونسي أو أشير مزراحي أو لويزة التونسية أو يعقوب بشير أو بنات شمالة أو الخلفاوي...
في الأدب والسينما والفكر، ترك اليهود التوانسة بصمات واضحة، مثل السينمائي ألبير شمامة شيكلي، والأديب ألبير ممي، والمؤرخ بول صبّاغ، والممثل ميشال بوجناح، والكاتب والمناضل اليساري جيلبار نقاش، والأديبة كوليت فلوس... وغيرهم.
كان عدد اليهود التوانسة في خمسينات القرن العشرين يصل إلى 100 ألف نسمة، وكانوا يخلقون تنوّعاً حضارياً وثقافياً في بلادهم، لكن مع الأسف أغلبهم دهستهم ماكينة الآيديولوجيا المرعبة، ففرّوا من بلادهم التي عاش فيها أجدادهم منذ أكثر من 2000 سنة. من المحزن حقّاً أن يضطرّ الإنسان لمغادرة وطنه، لأي سبب كان. لكن عدد اليهود في تونس اليوم لا يتجاوز الألفين، يعيش اليهودي التونسي في بلاده بصفة مواطن ناقص، لا يدخل إلى الخدمة العسكرية، ولا يمكنه المشاركة في مناظرات الشرطة والديوانة والجيش، ولا يمكنه التّرشّح للانتخابات الرئاسية...
> الشعراء والباحثون هم الآخرون انخرطوا في كتابة الرواية، هل نجحوا في ذلك؟
- علاقة الشعراء بالرواية هي علاقة قديمة، حين نقرأ الآن أعمالاً شعرية خالدة مثل الإلياذة والأويسة لهوميروس أو «مسخ الكائنات» لأوفيد، أو الكوميديا الإلهية لدانتي، أو الفردوس المفقود لميلتون، أو الإنياذة لفرجيل... نحتار في تصنيفها، هل هي شعر أم رواية. شخصياً أعتبر أن الشعراء إذا دخلوا الرواية يفتحون داخلها كوى جديدة على عوالم أخرى في السرد، صحيح أنّ السرد هو فضّاح الشعراء كما يقول العرب، وهو امتحانهم القاسي. وقد سقط في ميدانه كثير من الشعراء، لكنّ بعضهم عرفوا كيف يبنون عوالمهم الروائية، وكتبوا روايات فارقة في السرد العربي. أمّا الجامعيون فهذه مسألة أخرى، فثمة المبدعون منهم، وهي صفة نادرة جداً في المشهد الأدبي العربي، عبد الفتاح كيليطو مثلاً. أمّا الأغلبية من المدرّسين النمطيين، فقد كان دخولهم إلى الرواية كدخول التتار إلى بغداد. لا أفهم ما الذي يفعله بعض الجامعيين في الرواية، فهم يستعملون جملاً تقريريّة لا روح فيها، ويكتبون في موضوعات مجترّة منذ بداية المشروعات الأولى في الرواية العربية. وأغلب رواياتهم التي ترجمت إلى لغات أخرى أعطت صورة سيئة جداً للرواية العربية. أرى أنّ الطاقة التي يهدرونها في مشروعاتهم الإبداعية الوهميّة لو وضعوها في النقد الأدبي لساهموا في خلق ثورة في الرواية العربية.
>كيف تقرأ المشهد الثقافي التونسي بعد الثورة؟
- المشهد الأدبي في تونس أضاع البوصلة بعد الثورة، من وجهة الثورة في النصّ إلى وجهة النّص المحتفي بالثورة. ثمة كسل لا ينتج شعراً، وثمّة كدح لا ينتج سوى ثرثرة. جزء كبير من المشهد الأدبي التونسي الآن تتجاذبه الثرثرة والنعاس، ويهندسه إداريون جاهلون بالأدب متحصّنون بمدرّسي الجامعات و«أصحاب الدالات». لا يوجد مشروع واضح للثقافة التونسية، لا توجد مؤسسات موازية فاعلة تخرج بالنشاط الثقافي من المجترّ والنّمطي، ولا توجد مراكز للدراسات الثقافية، كلّ هذه الأسباب لا تخلق سوى مشهد متعفّن، تحرّكه الأشباح واللوبيات «المتمعّشة» من وزارة الثّقافة، ولا يخرج عن دائرة الاستعراض «الواجهة التي تخفي المزبلة»، والمئويّات والأربعينات «كرنفالات تستهلك من الحلويات ما تستهلكه من دموع التّماسيح». وإذا عرفنا أنّ الأدب والفكر هما في هوامش المؤسسة الثقافية الرسمية في تونس، نستنتج المستوى المتدني للمشهد الأدبي. لا توجد ورشات للتدريب على الكتابة، لا توجد جماعات أدبية تثوّر المشهد، لا توجد دور نشر متميزة. لا توجد مجلات وملاحق أدبية، حتى مجلة الحياة الثقافية التي تصدرها وزارة الثقافة توقفت عن النشاط منذ سنة، والحقيقة أنّ توقّفها كان رحمة بنبتة الحلفاء، فالمجلة غارقة في النعاس والجهل منذ سنوات. لا تبقى سوى بعض الأصوات التي تغرّد منفردة، ولن نقول تغرّد خارج السرب، لأنّه لا يوجد سرب من الأساس. أمّا الجوائز الأدبية فقد تحوّلت إلى رشاوٍ وإلى ترضيات لبعض الأسماء المكرّسة في الأدب. نحن نعرف أنّ الجوائز الأدبية في العالم جعلت لاكتشاف النصوص المغامرة، وليس للنصوص التجارية والنصوص التقليدية كما هي الحال في أغلب الجوائز الأدبية في تونس. بعض الجوائز هبطت إلى درجة الفضائح. جزء كبير من المشهد الأدبي التونسي الآن تتجاذبه الثرثرة والنعاس، ويهندسه إداريون جاهلون بالأدب