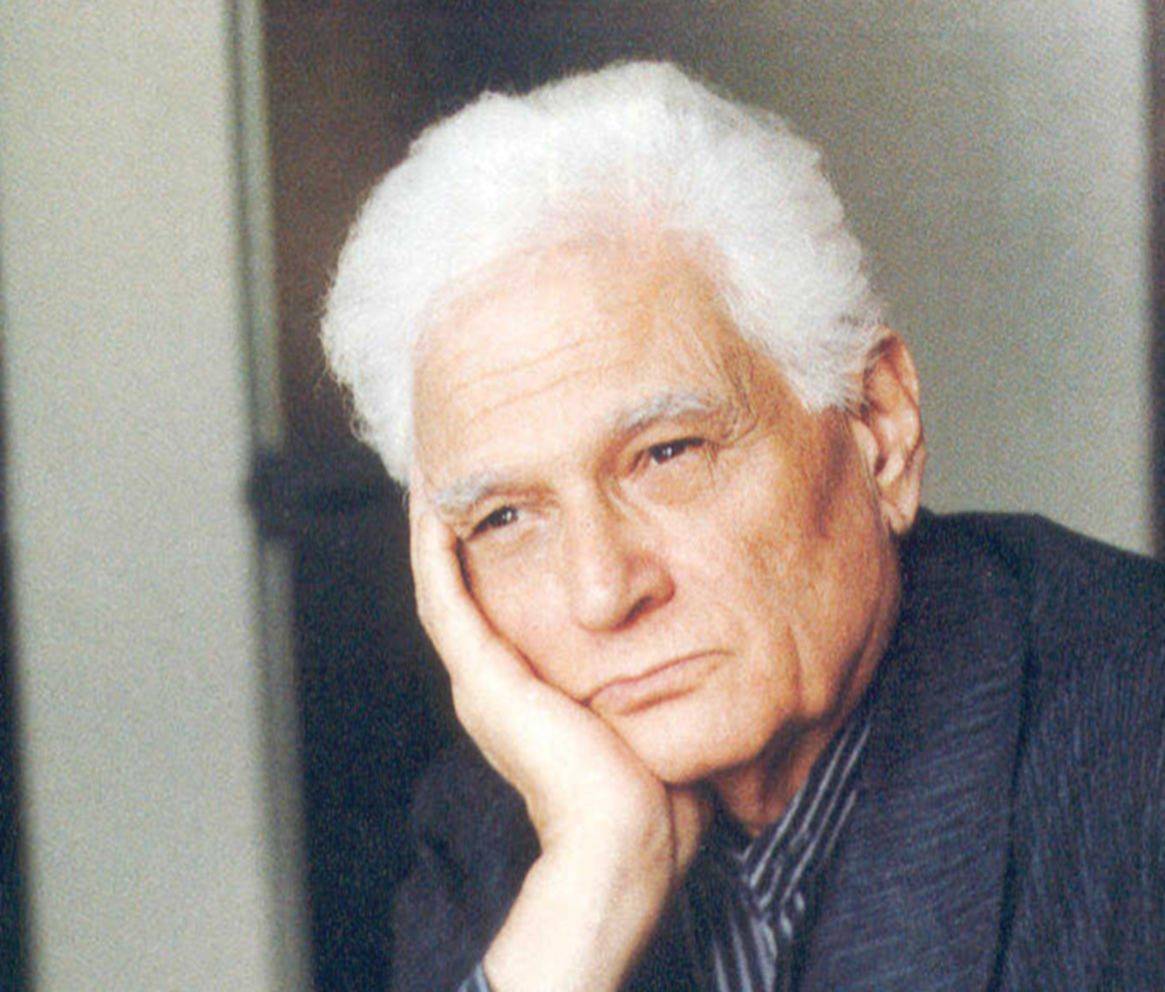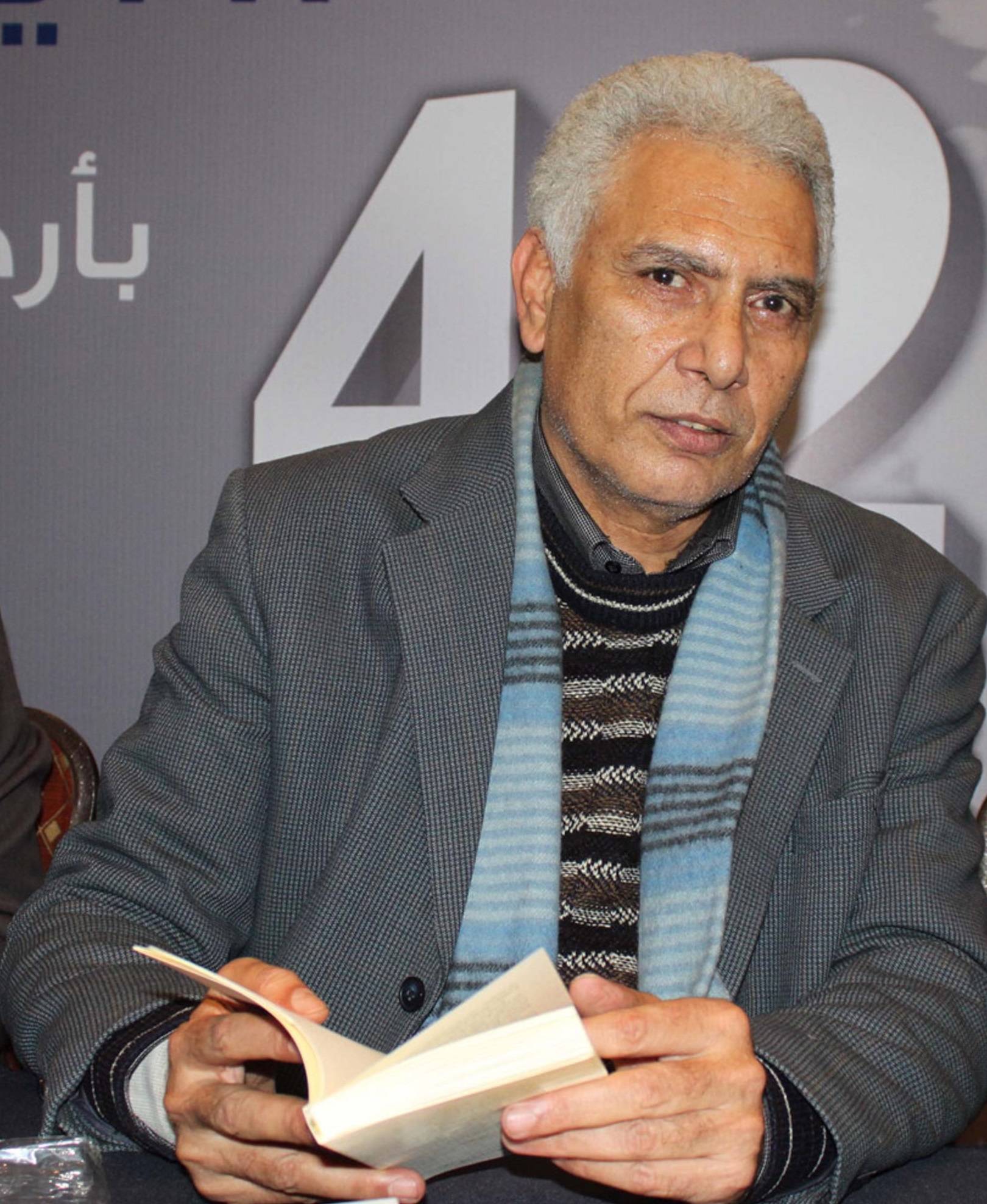انتقد كتاب وروائيون مصريون جائزة «مؤسسة ساويرس الثقافية»، رغم تشديدهم على أهميتها، ولفتوا إلى أن جوائزها صارت شكلية، وأن هناك استئثاراً من جانب بعض دور النشر بها، كما أن لجان تحكيمها غالباً ما تفتقر إلى الحيادية، فضلاً عن تكرار الحاصلين عليها أكثر من مرة.
وحذَّر الكُتاب - ومنهم من فاز بها - من أن تفقد الجائزة جديتها وقيمتها.
هنا تحقيق حول الجائزة التي احتفلت قبل أيام بدورتها السابعة عشرة.
الروائي رشيد غمري: تدوير الفائزين ولجان التحكيم
عدد الجوائز الأدبية العربية على العموم ضئيل للغاية، إذا ما قورن مثلاً بعدد الجوائز التي تُمنح في فرنسا وحدها، وتصل لحوالي ألفي جائزة سنوياً، تمثل حافزاً كبيراً بالنسبة للأدباء. وتعد جائزة ساويرس من حيث المبدأ إضافة مهمة؛ لكن هذا بالطبع لا يمنع أن لي ملاحظات عليها. كنت أتمنى ألا تصاب بالداء الذي تعاني منه أغلب الجوائز العربية التي تقوم على حسابات خاصة بخلاف جودة العمل المرشح. وقد لاحظت مع آخرين أنه جرى خلال عمر الجائزة تدوير الفائزين ولجان التحكيم من ناحية، ومنح الجوائز لدور نشر بعينها فيما يشبه «الكوتة».
ويمكن ببساطة ملاحظة الدوائر الفاعلة في الجائزة، والمتحكمة فيها، والمستفيدة منها، بمجرد رصد الفائزين على مدى السنوات الثماني الأخيرة؛ حيث سنجد نصيب الأسد لكُتاب هم في الوقت نفسه صحافيون ثقافيون في أماكن بعينها، وعدد من دور النشر ضمن شبكة علاقات مهنية وشخصية، يجري توزيع الجوائز بينهم، بينما يتبادل بعضهم المواقع في لجان التحكيم، مما يلقي ظلالاً من الريبة، ويفقد الجائزة حضورها وقيمتها عاماً بعد عام.
ورغم ذلك فنحن لا نريد هدم الجائزة ولا تشويهها؛ بل نرغب فقط في أن تصلح مسارها، بتعيين إدارة مختلفة، واعتماد لجان تحكيم أكثر حيادية. وتطبيق معايير موضوعية دون التفات لحسابات العلاقات الشخصية، ومكاسب دور نشر بعينها، فالجائزة كان يمكن أن تكون فرصة لكتاب تنويريين، ولديهم أفكار جديدة، ورؤى فنية مغايرة.
صحيح أن بعض الفائزين بالجائزة كُتاب جيدون؛ لكن مجمل النتائج يكشف أن المعيار الأدبي ليس وحده ما يحكم لجان التحكيم.
أما فيما يتعلق بجوائز «المجلس الأعلى للثقافة» وجوائز الدولة على العموم، فلا أظن أن هناك أي تعارض، ونحن بحاجة إلى عشرات الجوائز؛ لأن لدينا أعداداً متزايدة من الكُتاب المبدعين.
أعتقد أن هناك استبعاداً متعمداً للشعر، بحجة أنه ليس زمنه، كما أن قصيدة النثر التي يُفترض أنها التعبير الملائم للعصر، لم تصل بعد إلى كثير من القراء. وأظن أن هذا أدعى لتخصيص مزيد من الجوائز للشعر.
الكاتب عبد الوهاب داود: لا دور ثقافياً لها
أظن أن جوائز عائلة ساويرس لم يعد لها أي دور ثقافي منذ دوراتها الأولى، لا سلبياً ولا إيجابياً، اللهم إلا منح بعض النقود لأشخاص يحترفون العمل الثقافي، سواء في لجان التحكيم، أو الكتابة، حتى أنه لم يعد ينتظرها أحد، ولا يعقد عليها أملاً سوى من يمرون بضائقة مالية، أو من يبحثون عن أي بارقة اعتراف بكتابتهم الباهتة.
وأذكر أنني حضرت جلسة كان يتصدرها الكاتب الراحل سعيد الكفراوي، في الدورات الأولى للجائزة، كان يتحدث عن دوره في لجنة تحكيم الرواية، وأذكر أنه قال ما معناه أن اللجنة استبعدت كل الروايات التي تقدم بها صحافيون، لا لشيء إلا لأنهم يكسبون جيداً، ولديهم مساحات للنشر، وما زلت أذكر عبارته جيداً: «ح نديها لكلاب السكك، ولا ياخودهاش صحفي»! ساعتها ضحكت، وتحسرت على بؤس الثقافة والمثقفين المصريين، وأدركت طرفاً من مأساة الجوائز في عالمنا العربي. فأغلب الظن أن أي جهة مانحة تتصدر أهدافها قيمة الجائزة المعنوية، فهي تبحث لنفسها عن مكانة ما لدى الكُتاب والقراء، ولدى المجتمع الذي تعمل فيه؛ لكن ما يحدث من لجان التحكيم في الغالب هو ما يفقد هذه الجوائز مكانتها ومصداقيتها.
ولك أن تتأمل أسماء من فازوا بهذه الجائزة على مدار سنواتها، ومنهم –مثلاً- كاتب فاز في إحدى الدورات بأفضل رواية للشباب، وبعدها بعامين فاز بأفضل سيناريو، ثم رواية كبار الكتاب، وآخر فاز بجائزة المسرح، وقبلها جائزة القصة القصيرة، وقبلهما جائزة الرواية!
عائلة ساويرس تعمل في مجال الإنتاج السينمائي، فبماذا –مثلاً- نفسر أنها لم تنتج أي سيناريو من السيناريوهات الفائزة بجوائزها طوال 16 عاماً؟ لماذا لم تحوِّل ولو رواية واحدة من روايات الفائزين إلى فيلم؟
الروائي والمترجم أشرف الصباغ: مجرد وسيلة مالية
موضوع الجوائز شائك جداً، وخصوصاً عندما يكون كل أعضاء لجان تحكيم هذه الجائزة أصدقاء. وفي الحقيقة هناك لغط كثير حول جائزة ساويرس. أنا أستشعر الحرج في الحديث. وأود ألا أسبب لهم أي إحراج. ولكنني ممتن جداً لأنهم يحصلون على مقابل مادي لجهودهم في التحكيم يعينهم على مواجهة أعباء الحياة. وهذا أمر جيد، ومن أهم فوائد هذه الجائزة.
الأمر الآخر، هو أن أجيالاً مختلفة تحصل على جوائز ساويرس. وهذا شيء مهم. وفي الواقع القيمة المالية هي أهم ما في هذه الجائزة، لتساعدهم قليلاً على مواجهة الفقر وتدني مستوى المعيشة. وعموماً: غالبية الجوائز المصرية والعربية تكمن قيمتها الحقيقية في القيمة المادية. وهذا ما يفرحني وما يجعلني أتحدث عن هذه الجوائز باهتمام شديد. لكن دعونا من مسألة الإبداع؛ لأن الإبداع وقيمته يكمنان في المادة المكتوبة وليس في الجوائز. يجب ألا نخلط الأمور حتى لا نفسد فرحة الحصول على أموال تساعدنا على مواجهة الفقر والبطالة.
جائزة ساويرس لا تنافس أي جائزة. ولا توجد جوائز في مصر ينافس بعضها البعض الآخر. إنها مجرد وسيلة للحصول على مكافأة مادية (أموال) لمواصلة الحياة، وربما الكتابة أيضاً، ومواصلة المشاركة في اللجان، وإحداث حالة حراك حتى وإن كانت شكلية.
وبالطبع، هذه الجوائز -سواء كانت خاصة مثل «ساويرس»، أو حكومية مثل جوائز «المجلس الأعلى للثقافة» وجوائز الدولة وغيرها- كلها تختلف في شيء واحد فقط؛ في قيمتها المادية لا أكثر ولا أقل.
وأنا في الحقيقة، أناشد منظمي هذه الجوائز والقائمين عليها زيادة قيمتها؛ لأن الكُتاب والشعراء يعانون، وليست لدى غالبيتهم مصادر للرزق.
الروائي حاتم رضوان: الجوائز ظاهرة صحية
تعدُّد المؤسسات المانحة للجوائز الأدبية ظاهرة صحية، فكلما زاد عددها أعطت فرصة أكبر لعدد من المبدعين للفوز بها، كما أن قيمتها المادية قد تعوِّض المبدع عما يعانيه من صعوبات كثيرة في النشر والانتشار.
وبالنسبة لجوائز ساويرس، لا أعلم الآلية المتبعة في التحكيم؛ خصوصاً في مراحل التصفيات الأولية، والتي أرى أنها قد تظلم بعض الأعمال التي تستحق الوصول للقوائم القصيرة، على حساب بعض الأعمال لقلة من المبدعين، وليس كلهم ممن أعتقد أنهم مفروضون عليها، أو تحوطهم شبهة مجاملة.
وبالتأكيد فإن لكل محكم ذائقته الخاصة التي قد تؤثر في الاختيارات النهائية. وكذلك لا توجد جائزة عادلة بنسبة مائة في المائة، ولكن في النهاية فإن معظم من فازوا بجوائز ساويرس يستحقونها، ولا أعتقد أن جائزة ما يمكن أن تسحب البساط من جائزة أخرى؛ لكن لي ملاحظة على جوائز الدولة التي أعتقد أنها في كثير من الأحيان تتبع سياسة «الدور»، وليس الأفضل.
وهناك علامة استفهام كبيرة في جائزة ساويرس، وهي عدم تخصيص جائزة للشعر، وهذا سؤال يوجه للهيئة المؤسسة للجائزة. ولا أعتقد أن السبب تدني مستوى الشعر؛ لأن مصر زاخرة بالشعراء المجيدين، وهناك جوائز مخصصة له.
الكاتبة وسام سليمان: أين السيناريوهات؟
رأيي أن الجائزة الأجدر للسيناريو أن يتم تحويله إلى فيلم، وبما أن هناك اعترافاً من جانب اللجنة -وهي تضم شخصيات سينمائية بارزة مثل الفنان بشير الديك، وكمال رمزي- بعدد من السيناريوهات الجيدة بالفعل، فمن الأَوْلى أن تكون الجائزة دعماً لتنفيذ الفيلم أو إنتاجه.
في البداية، كان صيت الجائزة يلفت نظر المنتجين، وهناك أفلام ظهرت بالفعل كانت فازت بجائزة ساويرس، مثل «واحد صفر»؛ لكن يبدو الآن أن المنتجين صاروا بعيدين جداً عن الاهتمام بها، وهو ما جعل الجوائز تأخذ طابعاً شكلياً.
لماذا نشكو من قلة السيناريوهات، أو من عدم وجود أعمال جيدة منها؟ فالجائزة ولجنة تحكيم السيناريو تشير إلى أن هناك كُتاباً جيدين يحصلون على جوائز، فأين تكمن المشكلة إذن؟ وما الموانع التي تعوق تحويل تلك السيناريوهات إلى أفلام يراها الناس، ويفرح بها كاتبها؟
الجوائز لا تأخذ قيمتها من العمل نفسه، وهو غالباً لا يُرى ولا تتم قراءته؛ لأنه سيناريو. وأنا لهذا أشعر ببعض الغضب، ولدي أمنيات أرجو أن تتحقق وتتحول جوائز السيناريو إلى نوع من الدعم لتنفيذ وإنتاج الفيلم، وليس مجرد جائزة محددة بمبلغ مادي. فرأيي أن الجائزة الحقيقية التي يحصل عليها السيناريست يجب أن تتحدد في شيء واحد فقط، هو أن يرى روايته على شاشة السينما.