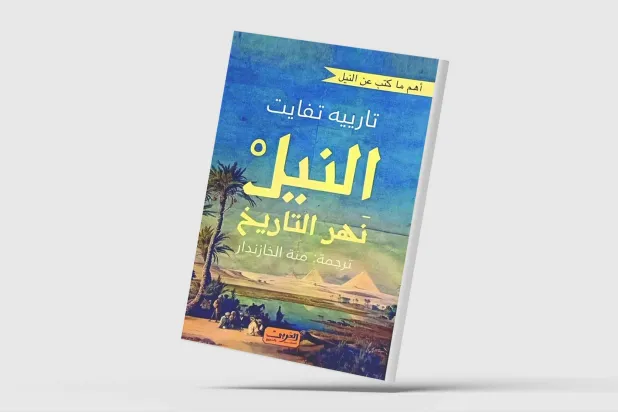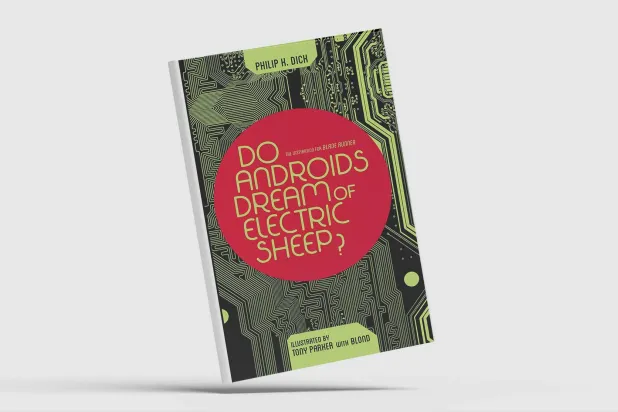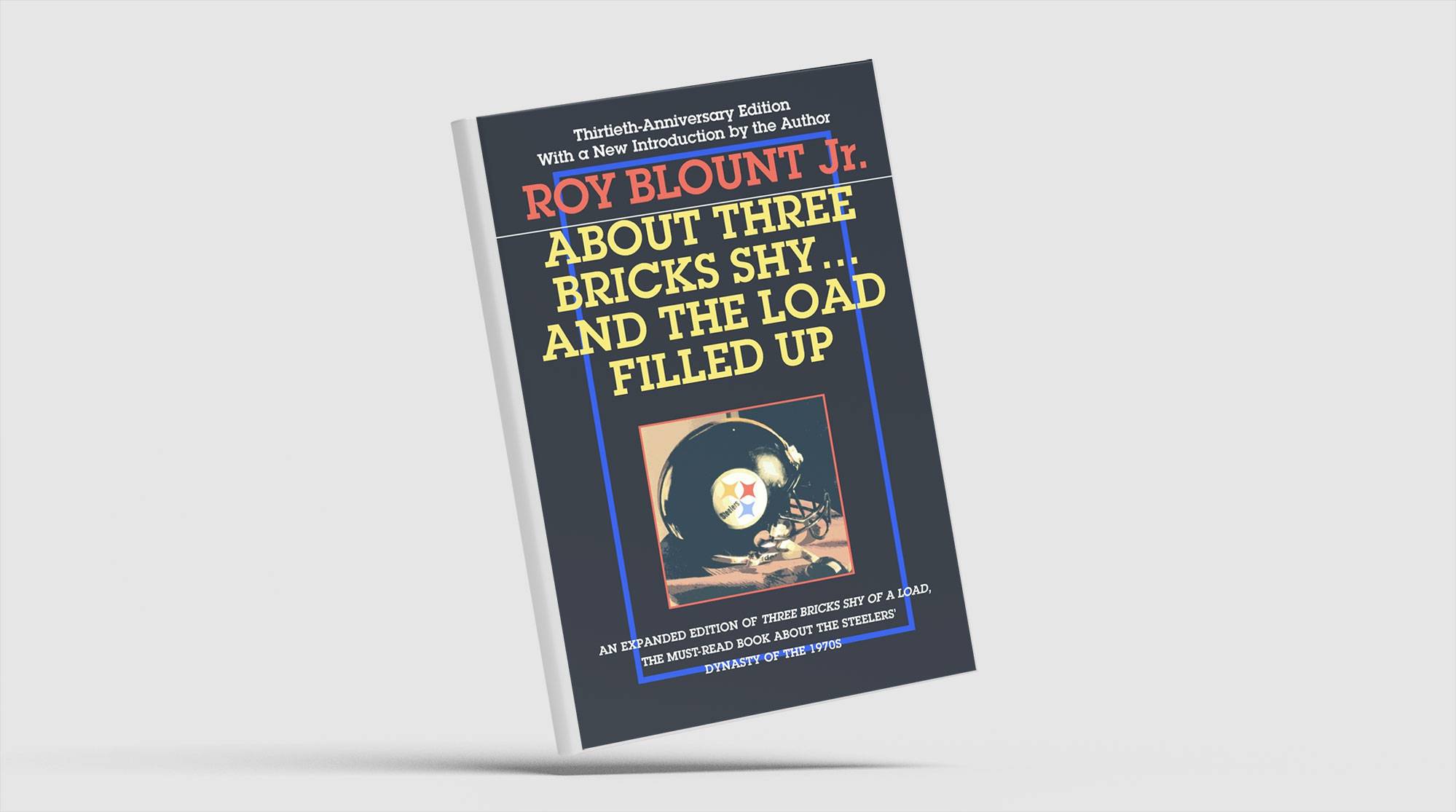لقد مر وقت طويل منذ كان على الفلاسفة أن يخافوا من مصير سقراط، الذي أعدم في أثينا القديمة بتهمة الإلحاد وإفساد عقول الشباب. فمعظم الفلاسفة الأحياء في أيّامنا هذه لا يعبئون كثيراً بأفكار العامّة، وينعزلون في أبراج عاجيّة بالجامعات والأكاديميّات، يقضون وقتهم بالقراءة وإلقاء المحاضرات الدراسيّة، ويكتفون عند شعورهم بالملل بإثارة الصخب حول مفاهيم نظريّة ولغويّة معقدّة مع زملائهم وحلقة تلاميذهم الضيقة، ويتجنبون على كل حال إزعاج السلطات الدنيوية أو الدينيّة، أو الاقتراب من مقدّسات الكتل الشعبيّة، وهم يتمتعون برواتب جيّدة، وميّزات لا بأس بها، وتقاعد محترم. ومع ذلك، فمن النّادر أن يفوز أحدهم بجوائز عالميّة مرموقة أو يحظى بتكريم مادي مجزٍ مقابل طرحه أسئلة وقضايا خلافيّة تمس مسلمات الأكثريّة.
بعيداً عن كل هذا يبدو بيتر سينجر. هذا الفيلسوف الأسترالي الذي يدير في الولايات المتحدّة قسم أخلاقيّات البيولوجيا في جامعة برينستون النخبوية المعروفة، فهو مستمر في إثارة عواصف من جدل تمس دون مواراة ولا مخاتلات قطاعات عديدة من المجتمعات على نحو يثير الاستفزاز العام أحياناً، وكثيراً ما قاد إلى احتجاجات ضدّه حيثما ذهب لإلقاء المحاضرات، ناهيك عن إطلاقه المستمر لدوائر فائرة في مياه راكدة كثيرة: عند المتدينين كما اليساريين، وعند دعاة حقوق الإنسان كما العنصريين ذوي الميول النازية، ومن قاعات التدريس إلى وادي السيلكون. وها هو فوق ذلك كلّه يحظى بجائزة أميركيّة رفيعة يمنحها معهد بيرغرون بلوس - أنجليس تتضمّن مكافأة ماديّة قيمتها مليون دولار أميركي تمنح سنوياً لمفكر «شكلت أفكاره بعمق وعي الإنسان لذاته وتقدمه في فضاء عالم سريع التغير». وقد أشادت لجنة تحكيم الجائزة بسينجر لتنشيطه التقليد الفلسفي للنفعية العملية والذي يَعتبر أنّ خلق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الأشخاص بدلاً من الاستناد إلى المبادئ المطلقة للخير، ينبغي أن يكون المبدأ التوجيهي للعمل الإنساني في كل مجالاته، لا سيّما في السياسة وحكم المجتمع والعلاقات الدّوليّة كما في الصحّة والطبّ، فيما وصفه كوامي أنتوني بياه، رئيس لجنة تحكيم الجائزة والأستاذ في جامعة نيويورك، بأنّ «سينجر هو الفيلسوف الأكاديمي الأكثر تأثيراً في العالم».
وبالطبع فإن الجوائز المليونيّة لا تمنح لوجه الله تعالى، بخاصة في الولايات المتحدة، وإنما تعبّر بشكل أو آخر عن أفكار ترضى عنها أطراف فاعلة من النخبة الأميركيّة. لكن ذلك لن يعني أن سمعة الفيلسوف الذي تعدّ أعماله مرجعيّات لدعاة الرفق بالحيوان، ستتحسّن عند البعض الذي يراه نازياً، وتناسخ أرواح لنائب هتلر مارتن بورمان، وقاتل أطفال، ومنافقاً متفلسفاً، وعدواً للحضارة والإنسانيّة، ومهرطقاً يريد التخلص من الوصايا العشر، كما في الثقافة اليهومسيحيّة السائدة في الغرب. أيضاً يراه البعض «أستاذاً للموت»، وعدواً لحقوق المعوقين والمسيحيين والليبراليين الكلاسيكيين، و«أخطر فيلسوف في العالم اليوم».
منذ بداياته كأستاذ في جامعة أستراليّة مغمورة، صدمت مواقف سينجر كثيرين من حاملي الأفكار المريحة حول ما هو صحيح وإيجابي وأخلاقي. وفي مقالة له من عام 1972 بعنوان «المجاعة والثراء والأخلاق»، استلهمها همتها وقتها المجاعة الكبرى في بنغلاديش جادل بأن الناس الميسورين في الغرب ملزمون أخلاقياً بإعطاء القضايا الإنسانية في جميع أنحاء العالم أكثر بكثير من الشكليات التي تتبعها المجتمعات الغربية، معتبراً أن المسافة الجغرافية ينبغي ألا تحدث فرقاً في التزامات المرء الأخلاقية. وقد أثارت المقالة وقتها نقاشات على نطاق واسع في الأوساط الفلسفية. ولكنه اشتهر في النطاق العام منذ نشر عام 1975 كتابه عن «تحرير الحيوان»، والذي زعم فيه أن زراعة المصانع والأبحاث التي تجري على الحيوانات في عصرنا غير أخلاقية، داعياً الناس إلى جعل حياتهم «خالية قدر الإمكان من القسوة»، معتبراً أن قصر المعايير الأخلاقيّة على نوعنا البشري دون المخلوقات الأخرى عنصريّة غير مبررة. وهو أصبح لاحقاً منظراً لمذهب النفعيّة والإيثار الفعّال القائل إن الأخلاق يجب أن تهتم قبل كل شيء بالترويج لأكبر قدر من الخير لأكبر عدد من الناس، ونشر كتباً لحث الناس العاديين على ممارسة أخلاقيات إيجابيّة كما في «الحياة التي يمكنك إنقاذها: كيف تقوم بدورك لإنهاء الفقر في العالم – 2009» و«أفضل ما يمكنك القيام به - 2015». على أن كتابه الأشهر «الأخلاق العمليّة - 1979» جلب له أكثر العداوات. فقد ذهب فيه إلى أن الآباء والأمهات ينبغي أن يمتلكوا الحقّ في إنهاء حياة المواليد الجدد المصابين بإعاقات شديدة. ومع أن تلك الفكرة قد تطرح بشكل خافت في بعض الأوساط الطبية إلا أن سينجر يضعها على الطاولة أمام الجميع، بل يقول إنه إذا تحتّم علينا الاختيار بين إنقاذ رضيع بشري معاق وقرد شمبانزي فالواجب الأخلاقي إنقاذ الشمبانزي لانعدام الفرق في وعي الألم بين الحيوانات والبشر. وقد شكلت مجموعة من ذوي الحاجات الخاصة لجنة للدفاع عن المعاقين رداً على سينجر سموها «لم نمت بعد» نظمّت احتجاجاً غطته الصحافة بكثافة لدى تعيينه أستاذاً للأخلاقيّات ببرينستون، ووصفه بعضهم بـ«أخطر فيلسوف في العالم» وأنّه «كما نازي أثناء الحرب العالميّة الثانية يبرر التمييز البغيض ضد الذين لم يولدوا بعد والرضع الضعفاء والعجزة والمسنين».
ولعل الثيمة الأهم التي تمتد عبر مجموع أعمال سينجر هي التساؤل حول ماهيّة فهمنا لمعنى الإنسان والقدسيّة التي تمنح له، مقارنة بأشكال الحياة الأخرى. فإذا كان البعض يتحدثون عن الوعي الذاتي، والقدرة على التفكير، وامتلاك اللغة، وصنع الأدوات، أو الإحساس بالعواطف مثل الحزن، فإن الدراسات التي أجريت على الشمبانزي مثلاً خلال مدى الثلاثين عاماً الماضية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بأن أيّاً من هذه الصفات مقتصر على البشر وحدهم، بينما بعض البشر في ظروف معينة، كالرّضع الصغار، وأولئك الذين هم في حالة موت دماغي أو أولئك الذين هم في المراحل المتقدمة من مرض مثل الزهايمر، ليست لديهم أي منها. ولذلك يمضي سينجر إلى الادعاء بعدم وجود بناء قاعدة مطلقة يمكن الدفاع عنها حول مبررات لتمييز البشر عن الحيوانات دون استبعاد بعض فئات البشر أيضاً أو بالطبع العودة للميتافيزيقيّات.
مجموع هذه المواقف الفلسفيّة لسينجر والتي تؤسس لتوجه أخلاقي منفصل بالكليّة عن المكان والعاطفة والحس السليم المتوافق عليه في المجتمعات الغربيّة القائم على أساس ادعاءات ثقافيّة ودينيّة - بشأن الكرامة الإنسانية الفطرية على سبيل المثال - وضعته دائماً في موقف استقطابي بين أنصار متحمسين وأعداء مبغضين، دون أن يهنأ يوماً بحياة الفلاسفة الأكاديميين المريحة التي يحظى بها زملاؤه في برينستون وبقية الجامعات الغربيّة الكبرى.
ولكنه، وهو يبلغ اليوم الخامسة والسبعين من عمره ولا يأكل اللحوم ولا يشرب الألبان ولا يرتدي أو يستعمل أي شيء مصنوع من جلود الحيوانات، يبدو مزهوّاً بكل العداء الذي تولده آراؤه. وهو يقول: «يُنظر إلى آرائي على أنها تهديد لشريحة من المتدينين الأصوليين في هذا المجتمع، شريحة تشعر بالأزمة لأنها تستمر بخسارة بعض المعارك الهامة، ولا سيما معركة الإجهاض.
هذه الشريحة تحتاج إلى سماع بعض الأشياء التي يجب أن تقال. والفرق أنني أقول تلك الأشياء بصراحة أكبر من معظم الناس». وقد أعلن فور إعلامه بفوزه بالجائزة المليونيّة عن تبرعه بنصف قيمتها لجمعيّات خيرية سيدعو الجمهور للمساعدة في اختيارها إلى جانب جمعية أسسها لمساعدة الفقراء حول العالم.
بيتر سينجر «أخطر فيلسوف في العالم»
استفزازي ترافقه الاحتجاجات أينما ذهب

بيتر سينجر

بيتر سينجر «أخطر فيلسوف في العالم»

بيتر سينجر
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة