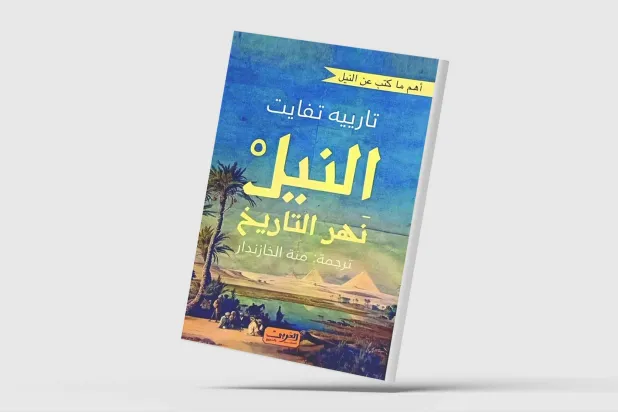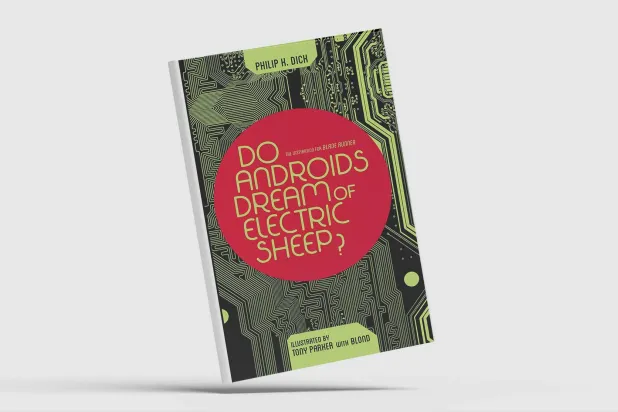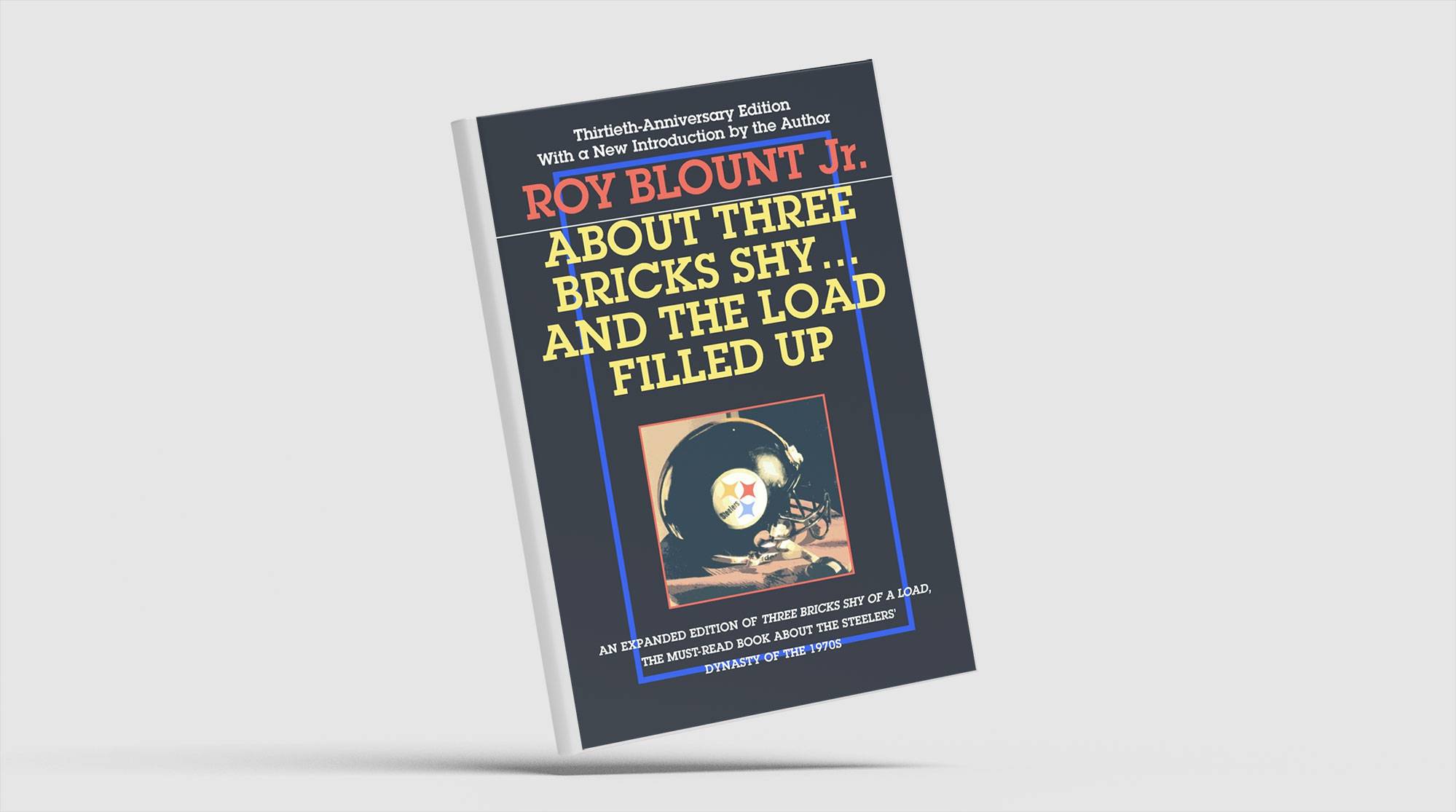في عصر الإفراط في مشاركة المعلومات، والقصص الذاتية، تقدم قراءة المراسلات للمرء أفضل نافذة على كيفية تشكل النفس الأدبية. ورغم أن كتابة الخطابات طريقة عتيقة، فلا يزال لها وجود معاصر، بحسب ما كشفت مجموعات من المراسلات الأدبية أخيراً.
كتبت إليزابيث هاردويك، الروائية والناقدة الفنية في مقال نشر عام 1953 عن المراسلات الأدبية: «أهم ما في الرسائل هو أنها مفيدة كوسيلة للتعبير عن النفس العليا المثالية، ولا توجد طريقة أخرى من طرق التواصل تضاهيها في تحقيق هذا الغرض. في المحادثات تمثل تلك الأعين المثيرة للقلق التي تتطلع إليك، وتلك الشفاه المتأهبة للتصحيح حتى قبل أن تبدأ الحديث، رادعاً قوياً لعدم الواقعية، بل للأمل».
فقط في رسائلنا نستطيع التعبير عن النسخة الفضلى والأكثر ذكاء من أنفسنا، وطرح الأسئلة، وتقديم الأجوبة، والتعبير عن أنفسنا كما نشاء. وأمام الزيادة الكبيرة في عدد رسائل البريد الإلكتروني، كنا بحاجة على ما يبدو إلى وباء عالمي لنعود إلى الرسائل والخطابات التي يتم صياغتها في قالب «أرغب في الاطمئنان فحسب»، من أشخاص كنا نعرفهم في الماضي أفضل مما كنا نعرفهم في الوقت الحاضر.
وإذا كانت الرسائل الشخصية تمثل شكلاً من أشكال تصوير الذات، فربما يتساءل المرء عن السبب الذي يدفعنا إلى قراءة الرسائل الأدبية. يبدو أنها تتمتع بهذه المكانة والأهمية لأنها تكشف أكثر مما كان يريده المؤلف، ويمكن لها، كما تقول هاردويك، الكشف عن مواقفنا تجاه عملنا، وأحبائنا، وأنفسنا. كذلك يوجد عنصر درامي في الصياغة؛ حيث تقدم طريقة التنقل في السرد للأمام وللخلف في الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني، إثارة طبيعية، إلى جانب انتظار رد على الخطاب قد يغير كل شيء، وكذلك التوقف المؤقت، والجلوس وجمع وترتيب الأفكار، وإتاحة مساحة للتأمل والتفكير، وسياحة العقل الذي يبحث عن خلاص. وليس من النادر، أن نقرأ إضافة ملحوظة ذات نكهة ممتعة، فتبدو الصفحة البيضاء مثل درج (جارور) مرتب بجمال، موضوع داخله بعناية ذلك العالم الداخلي. سوف يفهم أي شخص كتب مسودة لرسالة بريد إلكتروني طويلة، وسمح لأفكاره بالتدفق بحرية، قبل أن يحذف أكثر ما جاء فيها بدافع الإحراج قبل إرسالها، السبب وراء تلك الرغبة. على الجانب الآخر لم يكن هناك في زمن الاستخدام الشائع للآلة الكاتبة أو القلم ما يقيد ويعرقل هذا الزخم من الإقدام، أو ما يصفه إي إم فورستر بعبارة «كيف يمكنني التعبير عما أعتقد حتى أرى ما أقول؟».
أعتقد أننا نقرأ مجموعات الرسائل إلى حد كبير لرغبتنا في الاستمتاع برؤية الجوانب الإنسانية الأخرى من أبطالنا من الشخصيات الأدبية مثل النميمة الخبيثة لهنري جيمس، ومشروعات الحياكة الخاصة بسيلفيا بلاث، وشبق جيمس جويس. إن مثل هذه الرسائل ناضجة من جميع الأوجه؛ حيث نجد عبارات مثل «يستيقظ الطفل من القيلولة ويبكي»، و«تنطلق صافرة إنذار الغارة الجوية»؛ كما تتسرب إلينا الأعراف الاجتماعية والديناميكية النفسية من حقبات أخرى. من الصعب تخيل أنه بعد 50 عاماً من الآن سوف نقرأ «مجموعة رسائل البريد الإلكتروني» لزادي سميث؛ ويبدو من غير المرجح أن يرغب أي مؤلف معاصر في هذا الأمر. لا تعدّ رسالة البريد الإلكتروني، التي باتت شكلاً قديماً بالفعل، بديلاً إلكترونياً للخطاب، لكنها شكل مختلف من أشكال التواصل أكثر سرعة، ويمكن أن يصبح قابلاً للتخلص منه بدرجة أكبر أو أقل في الوقت ذاته؛ فمن غير الحكمة أن يهب المرء نفسه لشفرة إلكترونية سوف تبقى موجودة عبر الأثير، ولن يتم إلقاؤها في الموقد.
أعتقد أنه من أجل تلك اللحظات من الانكشاف على العالم الداخلي ما زلنا نقرأ الرسائل الأدبية. لذا يمكن القول بإيجاز إن الأمر يتعلق بالتلصص؛ حيث لا يزال بعضنا يقرّ بأنه يقرأ رسائل أبطاله من الشخصيات الأدبية مثلما يشاهد البعض الآخر برامج تلفزيون الواقع، انتظاراً للحظات التي يعبر فيها شخص ما عن مشاعر ملتهبة. عندما نشرت «برينتسون» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد مرور 50 عام على وفاة هيل «رسائل تي إس إليوت إلى إيميلي هيل»، التي تمت كتابتها على مدار 30 عاماً، تسبب الأمر في أن ينشر ورثة إليوت براءة من هذه الرسائل. لم يكن إليوت يحبها حقاً، بل كان يعتقد أنه يحبها، بحسب ما كتب. وجاء في الرسائل: «كانت إميلي هيل لتقتل الشاعر الذي بداخلي. لقد لاحظت بالفعل أنها ليست من محبي الشعر، وبالتأكيد لم تكن مهتمة كثيراً بأشعاري. لقد كنت أشعر بالقلق إزاء ما بدا لي دليلاً على تبلد مشاعرها، وذوقها السيئ»، كذلك أوضح أنه لم يقم علاقة حميمية معها.
أثار تعبير إليوت عن مشاعر الجحود والإنكار الذي جاء في غير وقته استياء جماعياً، لكن من المؤكد أن أي شخص يشعر بخوف من فتح صندوق الرسائل الواردة، خاصة الرسائل الأكثر مرارة، سوف يتفهم فزع إليوت من تخيل نشر رسائله، التي تعبر عن عدم الحب، حتى بعد مماته. من منّا يستطيع التظاهر بالاتساق في عواطفه إلى حد يجعلنا لا نريد حذف الأدلة على قصص الحب الأول الخاصة بنا. مع ذلك، كما يعلم المؤرخون وكتّاب السيرة الذاتية جيداً، كثيراً ما تكون مجموعة الرسائل، التي تتم كتابتها على مدار فترة من الزمن، أفضل إشارة لدينا إلى النقاط الغامضة في عالم الفن. عند إعادة قراءة «آريل» لبلاث في سياق رسائلها الأخيرة قبل وفاتها حين كان يتراجع الأسلوب البارع المثير، سيشعر المرء بالعجب من انتصار الإبداع في خضم الإحباط. وتكشف الرسائل، إن لم تكن عن «النفس الأصيلة»، عن توترات أساسية محددة تشعل القدرة على التعبير، أو ربما الكبت والقمع، في حالة الكاتبة أليس جيمس، التي تفوقت على شقيقيها هنري وويليام في القدرة على الملاحظة واختبار وتمحيص الذات. بناءً على رسائل إليوت، لا يسعنا سوى تخيل كيف كان حنينه إلى هيل بمثابة الشعلة التي ساعدته على كتابة أفضل أعماله التي ألّفها خلال فترة زواج غير ناجح.
ما يقابل فكرة هاردويك عن الرسالة الأدبية كتصوير مثالي للذات هو مراسلاتها مع زوجها الشاعر روبرت لويل التي امتدت لـ23 عاماً. لطالما كانت رواية لويل عن العلاقة معروفة، لكن لم تصبح رواية هاردويك عن هذه العلاقة معروفة إلا أخيراً؛ حيث تم نشر «رسائل الدولفين، 1970 - 1979» خلال الخريف الماضي، التي تغطي عقداً من الزمان، هجر فيه لويل زوجته وابنته هارييت من أجل الروائية الأرستقراطية الليدي كارولين بلاكوود، بحسب ما جاء تفصيلاً في ديوانه الشعري «الدولفين». وقد اقتبس لويل في ذلك الديوان الذي تم نشره عام 1973، والذي فاز بفضله بجائزة «بوليتزر» للمرة الثانية، بشكل مطول من رسائل هاردويك إليه، والتي تم كتابة كثير منها بحزن وأسى، لكن بعد مراجعتها وتنقيحها لتناسب غرضه.
عندما أرسل لويل المخطوطة إلى صديقته الشاعرة إليزابيث بيشوب، كتبت رداً عليه: «لقد غيّرت خطاباتها؛ إن هذا خداع على ما أعتقد، لكن لا يستحق الفن القيام بمثل هذه الأفعال». كذلك وصفت أدريان ريتش، التي تعد من أصدقائه المقربين، في مقال عن الديوان المذكور عام 1973، تعديله لرسائل هاردويك بأنها «من أكثر الأفعال انتقامية، ولؤماً في تاريخ الشعر». لقد أعربت هاردويك للويل عن قوة الفصاحة النابعة من مشاعر الألم والغضب، لكن أيضاً عن استمرار حبها له حتى مع علمها بأنه من الممكن قراءة الآخرين لخطاباتها يوماً ما.
لقد أشار ناقد نفسي، قام بتحليل نفسية كل من بلاث وزيلدا فيتزغيرالد، وسيدات مبدعات أخريات تشوهن نفسياً بسبب الرجال في حياتهن، بمحدودية الطرق الاعتيادية التي نروي بها قصصنا عن الآخرين، وتحديداً الطابع غير الموضوعي للانطباعات الشخصية، أو الجمود، أو الشطط في الحقائق الخاصة بالسيرة، وهي طرق غير كافية للنظر إلى التغير المستمر المعقد للكينونة الإنسانية.
ربما يتساءل البعض؛ ماذا إذن بشأن مستقبل الرسائل المجمعة في القرن الواحد والعشرين، أي رسائل سنختتم بها هذا المقال؛ رسائل فيليب روث، أم توني موريسون؟
* خدمة «نيويورك تايمز»
لماذا نحب أن نقرأ الرسائل الأدبية؟
أفضل إشارة لدينا إلى النقاط الغامضة في عالم الفن

الرسائل تذكارات الحب

لماذا نحب أن نقرأ الرسائل الأدبية؟

الرسائل تذكارات الحب
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة