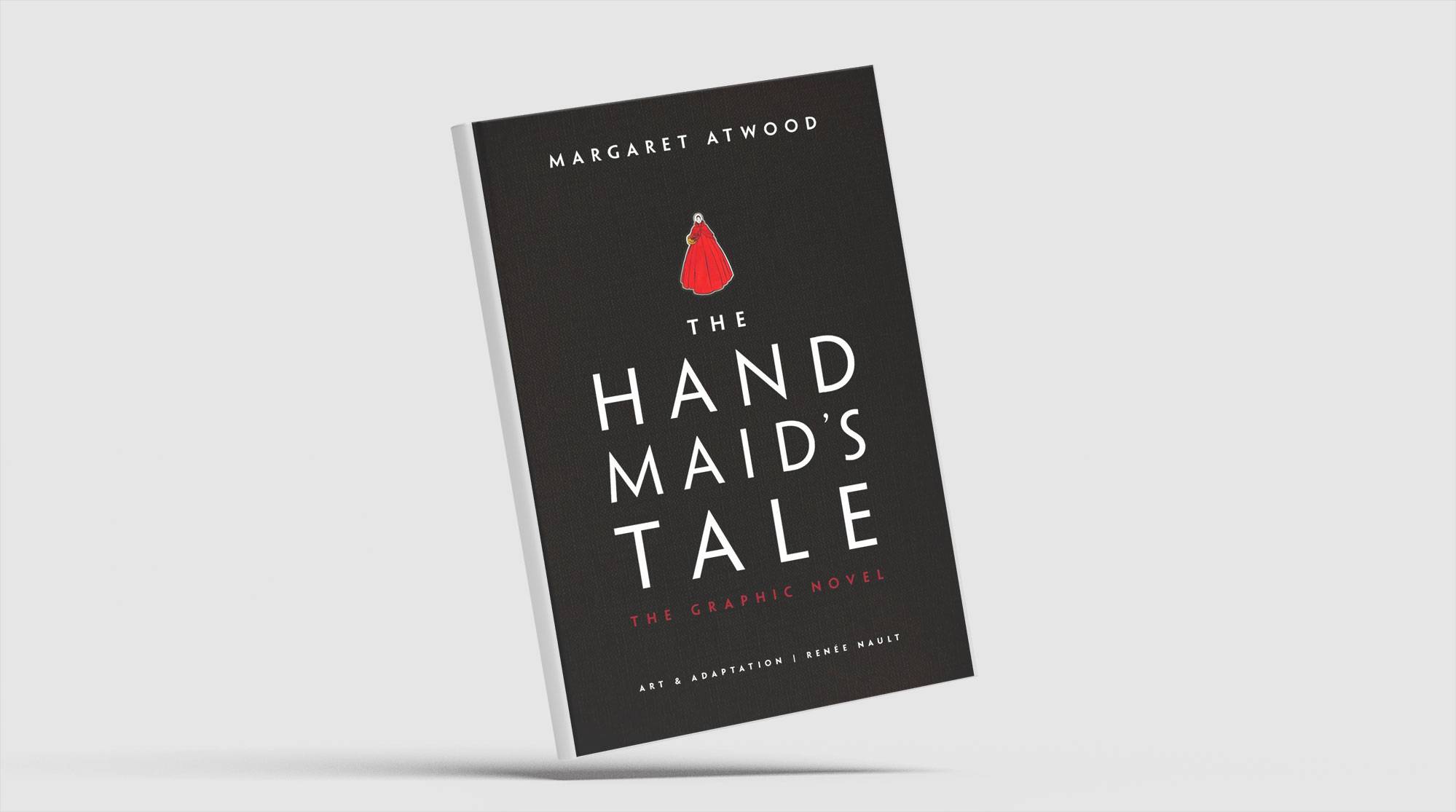كم استوقفتني الصور الفوتوغرافية الأرشيفية بالأبيض والأسود، التي تؤرخ لأناس عاديين من جنوب لبنان لعقود الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن المنصرم، حينما زرتُ معرض المصور الفوتوغرافي اللبناني أكرم الزعتري في غاليري «التيت مودرن»، وكم استوقفتني لاحقا صور أكرم الزعتري بمركز جورج بومبيدو في باريس كجزء من معرض فوتوغرافي عن الشرق الأوسط. ترى لماذا يحظى أكرم الزعتري بكل هذا التقدير في أكبر المعارض في العواصم العالمية؟
يمزج أكرم الزعتري، المولود في صيدا عام 1966، مهارات المؤرخ والفنان والدليل الفني، ليجري فحصا دقيقا للصور الفوتوغرافية القديمة والمهملة ربما، ومدى قدرتها وقابليتها لعرض الماضي بحيادية ونقده. لوحاته الفوتوغرافية تتحدى الصور النمطية للتاريخ القريب، في محاولة لتقويم هذا التاريخ والتركيز على الفردانية إلى درجة تضخيم هذه الفردانية في أحيان كثيرة. عام 1997، أسس مؤسسة الصورة العربية، وهي منظمة غير ربحية متخصصة لدراسة وحفظ الصور الفوتوغرافية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحوزة هذه المؤسسة الآن ما يعادل 300 ألف صورة فوتوغرافية.
بدأ أكرم الزعتري عبر هذه المؤسسة مشروعا لإثارة انتباه الناس والرأي العام لأرشيف استوديو شهرزاد للمصور الفوتوغرافي هاشم المديني، وهو استوديو للفوتوغراف بدأ عمله في مدينة صيدا جنوب لبنان منذ عام 1948. اللقطات الفوتوغرافية التي التقطها مصورو استوديو شهرزاد تمثل صورا لأناس من مختلف الفئات العمرية غير معروفين، فردية أو في مجموعات أو صورا ثنائية.. أناس مغيبين ومجهولين غالبا، لكننا نراهم بملابسهم البسيطة وتسريحات الشعر ونظراتهم التي يواجهون بها الكاميرا بشكل متعمد حينما تعلق هذه الصور المنسية في كبرى الغاليريهات في العواصم العالمية. الصورة الفوتوغرافية إذن هي اللغة الوحيدة المفهومة في كل أرجاء العالم والتي تصل بين الأمم والثقافات وتربط حياة البشر بتضامن عاطفي غالبا، والفوتوغراف إذا ما استقل عن الخطاب السياسي يعكس الحياة ومجرياتها بصدق ويتيح لنا مشاطرة الآخرين آمالهم وآلامهم، ويلقي بضوء ساطع على الأوضاع السياسية والاقتصادية في لحظة الصورة، ونصبح نحن المتلقين أينما نكون شهود عيان على إنسانية ولا إنسانية البشر.
تضج هذه الصور بحياة حيوية كاملة الوجود: صورة لفتاتين ترتديان عوينات شمسية كبيرة كتلك التي سادت في تلك الحقبة، تحضنان بعضهما بعضا.. صورة أخرى لرجلين ومسدسين في أيديهما، ويمثلان مشهدا للقبض على رجل ثالث بينهما.. صورة أخرى لرجلين أحدهما يرتدي برقعا على رأسه في محاولة لتمثيل دور عروس، بينما يلف الرجل الثاني ذراعه حول كتف الأول. الكاميرا تحنط الابتسامات والإيماءات وحركات الجسد ونظرة العين، بل يخيل لنا أننا نسمع الناس ونشعر بهواجسهم الداخلية وننصت للضوضاء خلف جدران الاستوديو في الشوارع، نلمس أحلامهم ورعبهم وآمالهم ووضعهم والاقتصادي وتطلعاتهم.
* الصورة الفوتوغرافية تصافح الآخرين
كان استوديو شهرزاد ملاذا آمنا في مجتمع محافظ، يسمح للناس بأن يمارسوا خيالاتهم وأحلامهم أمام الكاميرا للوصول إلى صورة مثالية لهم (من وجهة نظرهم)، وهي ممارسة كانت شائعة ومقبولة داخل استوديوهات التصوير في تلك الحقبة، كأن الاستوديو يفصل الناس عن محيطهم ليصبحوا بطريقة ما أكثر انتماء لأنفسهم وأحلامهم. كان الناس في تلك الحقبة من الزمن يذهبون للاستوديو لأخذ الصور الفوتوغرافية كنوع من الموضة مثلما يذهبون إلى قارئ البخت لمعرفة طالعهم، لذا فهم يعتمدون على المصور كي يحررهم من واقع خاذل أغلب الأحيان.
عرض غاليري «التيت مودرن» في لندن مجموعة لوحات أرشيفية تستقرئ وجوه ومواقف الناس العاديين في لبنان للفترة من 1950 - 1970، مصنفة حسب الفئات، تعكس هذه الصور وتبرز المكانة الاجتماعية والسياسية التي يعيشها من يجلس أمام الكاميرا. الصور بالأبيض والأسود تثير فينا حنينا جارفا، وتستنفد غريزة الفضول إلى أقصاها. ويقترح أكرم الزعتري طريقة لقراءة الصور الفوتوغرافية بالتمعن في لباس ودوافع الناس الذين يجلسون لالتقاط الصور، كما لو أن الاستوديو يروي فيلما متسلسلا لأناس مجهولين والمصور هو مخرج هذا الفيلم.
الزعتري يركز على الذكريات والأحداث اليومية التي تعيد تفسير سلوك الناس وأفعالهم وردود فعلهم في أوقات الحرب والمنفى ضمن نطاق المسموح به. في مقابلة لابنة هاشم المديني صاحب استوديو شهرزاد قالت إنها ما زالت تحتفظ بالديكورات والأزياء التي كان والدها يحتفظ بها في الاستوديو كي يلبسها الناس ليتشبهوا بنجوم السينما. الزعتري صانع صورة وجامع لها، لكن حقوق عرض الصور الشخصية بمعارض عامة للجمهور قد يثير فينا تساؤلا: هل يسمح أصحاب هذه الصور بنشرها علنا؟ هناك صور مخربة عن قصد لامراة شابة تدعى زوجة الباقري، طلب زوج هذه المرأة من المصور أن يتلف نيجاتيف صورها لأنها ذهبت إلى الاستوديو دون موافقته. لكن أكرم الزعتري يبدع صورا جديدة من نيغاتيف الصور المخربة عمدا، تصبح الخطوط المتعجلة التي تتقاطع على وجه المرأة الفاتنة جزءا من جمالية الصورة ودليلا كافيا على أن تخريب الجمال عمدا يزيده بهاء.
* الكاميرا لا تكذب
هناك قاعة أخرى خصصت لعرض صور لأطفال فلسطينيين من إحدى مدارس الأونروا وهم يجلسون جميعا على الكرسي ذاته بالتعاقب وخلفهم حائط مخربش.. يعود تاريخ هذه الصور لسنة 1960.. الفاقة جلية على الوجوه جدا، لا ابتسامات ولا ملابس مرتبة. أطفال غادروا طفولتهم قبل أن يولدوا ربما.
في صالة أخرى صور أرشيفية لرجال من المقاومة الفلسطينية والسورية، بعضهم شباب يرتدون الملابس العصرية في تلك الحقبة يوجهون بنادقهم إلى زاوية منحرفة عن الكاميرا بفرح يطفر من ملامحهم كأنهم يحملون حبيباتهم بين أيديهم. ونستطيع أن نخمن بسهولة أن حمل البندقية في تلك الحقبة هو جزء مكمل لرجولة الرجل الفلسطيني. بينما يظهر رجال المقاومة السورية بشكل أكثر صرامة تلف رقابهم وصدورهم الغترة العربية ولا يحملون أسلحة بين أيديهم.
بينما علقت في مركز جورج بومبيدو صورة أرشيفية جميلة ضمن مجموعة صور أخرى لأكرم الزعتري، لصياد لبناني يرتدي الطربوش وتقف خلفه ابنتاه، يرتسم على محيا إحداهما عبوس العنوسة، بينما تلون وجه الأخرى ابتسامة الأمل. ويبدو أن الصورة قد التقطت في منزل الصياد لأن خلفية الصورة هي بطانية داكنة تخفي تفاصيل البيت البسيط، لكن يد طفل تمسك البطانية في زاوية الصورة وتفضح ضوضاء الدار.
صور أكرم الزعتري شفوقة ومهذبة رغم بلاغتها، وشخصية تميل إلى ترك المشاهد يرى بنفسه صورا لا تتظاهر بكونها فنا، كما أنها ليست عظة.. هي أثر الواقع فقط مثل طبع القدم أو بصمات الأصابع أو مثل أقنعة الموتى.