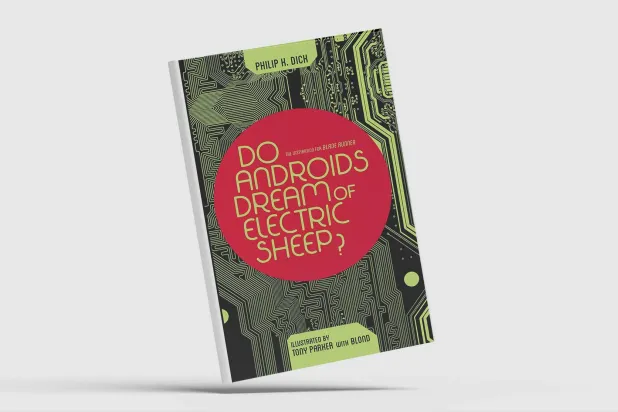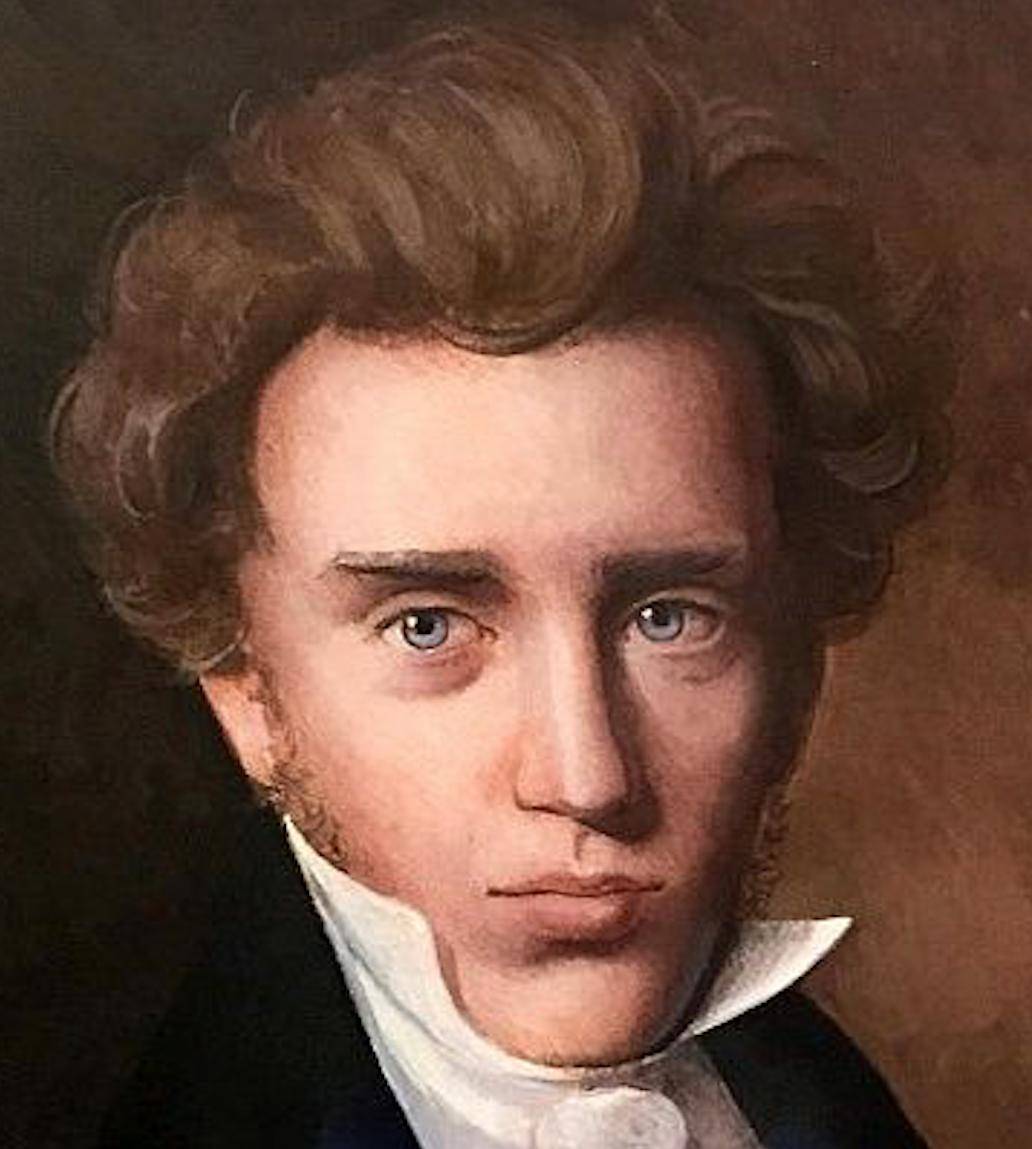لا أحسب أنّ عبارة «موت الرأسمالية» قد وهنت نبرتها يوماً خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية، وبخاصة عقب كلّ أزمة دورية متوقّعة للرأسمالية، وقد تغوّلت هذه النبرة في خضمّ الجائحة الكورونية الحالية، وتمظهرت بهيئة نذير يحمل نبوءة أشبه بالنبوءات اللاهوتية، حيث لا يكون الفناء محض تلاشٍ فيزيائي لحالة واستبدالها بحالة أخرى؛ بل يكون فناءً عاماً للبشرية مقترناً بخراب شامل لا يُبقي شيئاً من معالم الحياة الإنسانية على وجه الأرض.
يبدو الفيلسوف سلافوي جيجك للوهلة الأولى الفيلسوف النموذجي الممثل لخطاب «السرديات الكبرى»؛ فهو لم يتأخر عن ركوب موجة المبشّرين بميتة جديدة للرأسمالية بعد ميتاتها الكثر حتى بات الأمر يتخذ صيغة الفعل التالي: عند أي أزمة وجودية تواجهها البشرية - ولطالما واجهت وستواجه مثل هذه الأزمات – لا تفعل شيئاُ باستثناء لعن الرأسمالية والتبشير بموتها الوشيك! هذه شعبوية ترقى إلى مصاف التملّص من الالتزامات الأخلاقية التي تعلن عن نفسها بتفاصيل إجرائية بدلاً من الركون المسترخي إلى الإعلانات الصاخبة التي يمكننا وصفها بأنها بعض مواريث عصر (السرديات الكبرى والآيديولوجيات المتضخّمة) التي حفل بها القرن العشرون، وأزعمُ أنّ الشيوعية لو كانت حيّة في عصرنا هذا لما توانى جيجك في كيل التهم لها ووعدها بميتة لا تقلّ عن بشاعة الميتة المنتظرة للرأسمالية.
قد يخفى على البعض أنّ الرأسمالية في بواكيرها الأولى تلوّنت بصبغة لاهوتية (بروتستانتية على وجه التخصيص) أعلت شأن الجهد الفردي، والأخلاقيات الصارمة القائمة على الانضباط الفردي، وحبّ العمل وكراهية الكسل واعتباره خصيصة مرذولة لا تليق بالمتطلعين إلى حياة شريفة، ويمكن في هذا الشأن العودة إلى كتاب «الأخلاقيات البروتستانتية وروح الرأسمالية» الذي وضعه السوسيولوجي المؤسّس ماكس فيبر، ليس بوسع أحدٍ نكرانُ أنّ البدايات الرأسمالية كانت لها آثارها ومفاعيلها في حضارتنا الراهنة لقدرتها الفائقة على الارتقاء بالرفاهية العامة عبر إشباع البطون الجائعة ومن ثمّ تصنيع أسباب الترف المادي وتوفير المتع ووسائل البذخ اللامحدودة. ربما قد يتقاطع هذا الفهم لدى البعض مع المفهوم السائد لدينا والقائم على اعتبار الرأسمالية شراً مطلقاً، وهم إذ يفعلون هذا إنما يقصدون نمط «الرأسمالية المالية» القائمة على الاستحواذ الريعي بوسائل فاسدة بدلاً من اعتماد وسائل الرأسمالية الدافعة للبحث والتطوير العلمي والتقني وتخليق الثورة غير الريعية، وتلك حكاية طويلة لها سردياتها الخاصة في أدبيات التنمية ومعوقاتها.
سادت اليوم شعبوية أعلى شأنها صوت الراديكالية اليسارية ومنظّرو أحزاب اليسار الجديد الذين اندفعوا لترجيح كفة الخطاب الآيديولوجي على حساب الحقائق الراسخة على أرض الواقع، متّخذين من «الأزمات الدورية في الرأسمالية المعاصرة» شاهدة على مصداقيتهم في الوقت الذي نعرف فيه بما لا يقبل اللبس أنّ هذه الأزمات الدورية ليست أعراضاً سريرية منذرة باقتراب الموت بقدر ما هي ملامح ملازمة لطبيعة آليات اشتغال الرأسمالية.
لم يكن الترويج لفكرة شعبوية عن موت الرأسمالية سوى فكر رغائبي يُراد منه رؤية القلاع الرأسمالية تتهاوى مثلما تهاوت قبلها قلاع الشيوعية، ولا ننسى في هذا السياق أن الشيوعية ذاتها تعرّضت للهجمة النبوئية ذاتها المنذرة بموتها (روايات جورج أورويل وآرثر كوستلر مثالاً)، ثمّ تحققت هذه النبوءة بتهاوي الحصون التي كانت تمثل التجربة الاشتراكية نتيجة ظروف متضافرة كثيرة أدت إلى انهيار المنظومة بكاملها.
هناك الكثير مما علينا التوقف عنده في الحالتين: قد نتفق على سقوط الشيوعية كتطبيقات ؛ لكن الفكر الماركسي الذي عُدّ الخلفية الآيديولوجية للدول الشيوعية لا يزال حياً، ولا تزال الأدبيات الماركسية تلقى رواجاً كبيراً في أنحاء عالمنا ؛ فنجد أعرق الجامعات في البلدان الرأسمالية تواصل إصدار دراسات حديثة وكثيرة بشأنه. إذن، ثمة فرق كبير بين جوهر الأفكار وبين تطبيقاتها والمؤسسات (ومنها الحكومات) القائمة على تلك التطبيقات، والأمر يصحّ على الرأسمالية بقدر ما يصحّ على الماركسية.
ونعلم أنّ الرأسمالية ليست رأسمالية واحدة، بل هي رأسماليات عدّة؛ فالرأسمالية الأميركية الأصولية المحكومة بتغول الفردانية الجامحة هي غير الرأسمالية الألمانية أو الإسكندنافية المُرشّدة بموجّهات الديمقراطية الاجتماعية، وهذه غير الرأسمالية اليابانية المحكومة باعتبارات التقاليد اليابانية الصارمة، ولعلّ المثال الأكثر تطرفاً بين الرأسماليات المعاصرة هو نموذج الرأسمالية الصينية التي تجاوزت التلازم القسري بين الليبرالية السياسية والاقتصاد الحرّ، ونجحت في توظيف الآليات الرأسمالية بمعزل عن إسقاطاتها السياسية وأحرزت انعطافات ثورية في هذا المجال طبقاً لقاعدة دينغ زياو بنغ القائلة «ليس المهمّ أن يكون القطّ أبيضَ أو أسودَ، بل ما يهمّنا فيه أن يصيد الفئران».
من الطبيعي أن تتعالى الأصوات المنادية بموت الرأسمالية عند كلّ أزمة وجودية تعانيها البشرية، ولعلّ هؤلاء المنادين بموت الرأسمالية إنّما يعنون السياسات النيوليبرالية (أو الرأسمالية المتأخرة طبقاً لمصطلحات المنظّر الثقافي فريدريك جيمسون Fredric Jameson) – تلك السياسات التي تعد بعض مواريث السياستين الريغانية والثاتشرية اللتين أطلقتا يد الأسواق الحرة المتغوّلة وأعلتا شأن الاقتصاد الرمزي القائم على المشتقات المالية بدلاً من عناصر الإنتاج الحقيقية.
إذن، يبدو أن السياسات النيوليبرالية آن لها أن تنتهي؛ لكن السياسات الرأسمالية سيعاد تكييفها إلى حد قد تبلغ معه مرتبة الرأسمالية التشاركية (أو الرأسمالية التقدّمية) بحسب توصيف العالم الاقتصادي الحائز نوبل جوزيف ستيغلتز.
قدّم ستيغلتز مقاربة فكرية رصينة وهادئة وبعيدة عن الدراما الإعلانية (بخلاف الإعلانات الصاخبة المنذرة بالمشهديات القيامية) في سياق مقالة له نشرها في صحيفة «الغارديان» البريطانية قبل أشهر. يرى ستيغلتز أنّ مصداقية الإيمان الأعمى الذي تبديه النزعة النيوليبرالية حول كون الأسواق غير المقيّدة هي الطريق المؤكّدة نحو تحقيق الرفاهية العالمية المشتركة غدا أمراً مشكوكاً فيه حتى بات من الضروري وضعه على جهاز إنعاش الحياة، وبخاصة في خضمّ الجائحة الكورونية الراهنة. ويرى ستيغلتز أنّ انخذال الثقة وتراجعها في كلّ من النيوليبرالية والديمقراطية ليس محض مصادفة أو ارتباطاً عابراً؛ فقد عملت النيوليبرالية على التقليل من شأن الديمقراطية وتوهينها على مدى أربعين عاماً، ثمّ يضيف كشفاً عن حقيقة ما يحصل في عالمنا: يجري عادة إخبار الناس - حتى في البلدان الثرية - بأشياء من قبيل: «ليس بمستطاعكم اعتماد السياسات التي ترغبون سواءٌ أكانت توفير مظلة حماية اجتماعية كاملة أو أجوراً وافية توفّر حياة محترمة أو سياسة ضريبية تصاعدية أو منظومة مالية محكومة بضوابط كافية،،،»، والتسويغ جاهز دوماً: «لو احتكم البلد إلى سياساتكم هذه سيفقد ميزته التنافسية، وستختفي الأعمال، وستعانون معاناة رهيبة ليس في قدرتكم تحمّل تبعاتها المدمّرة».
لقد وعدت النخب السياسية في البلدان الغنية والفقيرة أن يكون اعتماد السياسات النيوليبرالية وسيلة مضمونة لنمو اقتصادي أسرع، وأن تكون الفوائد المجتناة من هذه السياسات قادرة على بلوغ قاع المجتمع على نحوٍ يكفل انتفاع الجميع منها بما فيهم الأفراد الأكثر فقراً؛ لكنّ تلك النخب السياسية ترى أن بلوغ هذه الرفاهية الموعودة يتطلّبُ قبول العمّال بأجور أقلّ فضلاً عن قبول كلّ المواطنين باقتطاعات مالية ضخمة من البرامج الحكومية المخصصة للخدمات العامة. ماذا تحقّق بعد كلّ هذه الوعود الكبرى من جانب منظّري السياسات النيوليبرالية؟ لم يتحقق شيء مهمّ أبداً.
* كاتبة وروائية ومترجمة عراقية
8:25 دقيقه
«موت الرأسمالية»... تفكير رغائبي وفكرة شعبوية
https://aawsat.com/home/article/2471956/%C2%AB%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9



«موت الرأسمالية»... تفكير رغائبي وفكرة شعبوية
عالم ما بعد «كورونا»


«موت الرأسمالية»... تفكير رغائبي وفكرة شعبوية

مواضيع
مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة