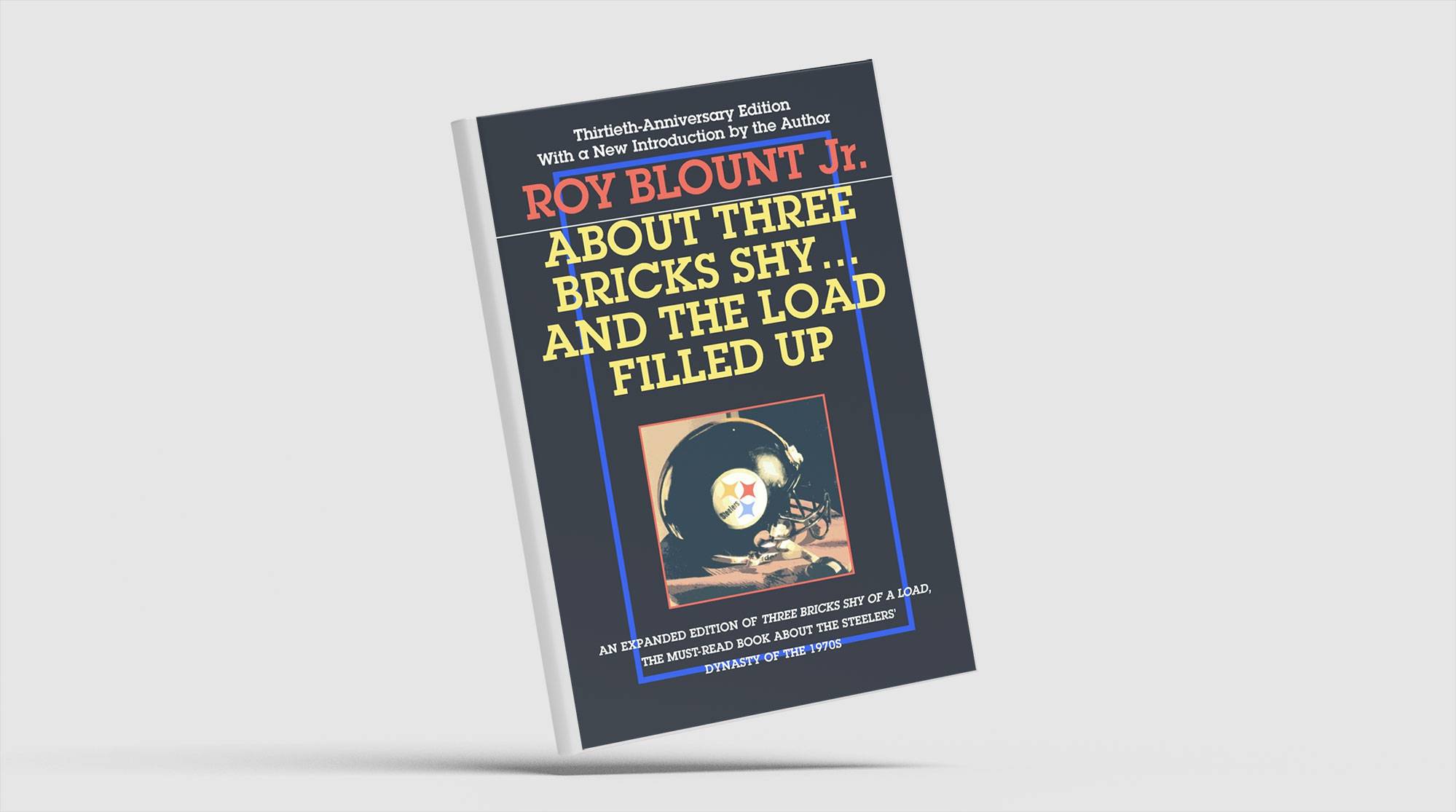بداية سوف أقول إن إدغار موران يمثل ظاهرة فريدة من نوعها. فهذا الرجل الذي اخترق القرن العشرين كله منذ ولادته عام 1921 لا يزال حياً يرزق حتى الآن. والشيء المدهش الذي يدعو للإعجاب حقاً هو أنه وصل إلى هذا العمر المتقدم وهو لا يزال في كامل ملكاته العقلية والنقلية. بل إنه يجوهر أكثر فأكثر إلى درجة أنه أصبح حكيم فرنسا والعالم كله في هذه اللحظات بالذات.
بالأمس فقط تحدث عن مشكلة هذا الفيروس المجرم الذي يرعب العالم بأسره، والذي لا أتجرأ على ذكر اسمه مجرد ذكر خوفاً منه وذعراً. وقال إن العالم بعده لن يكون كما كان قبله أو هكذا يأمل ويرجو. ودعا الغرب الرأسمالي المتغطرس إلى تغيير عاداته وأساليب حياته المتطرفة والمسرفة الغارقة في الشهوات والملذات الضرورية وغير الضرورية وعبادة العجل الذهبي. بل ودعا إلى انتهاج سياسة حضارية مختلفة كلياً عما سبق في كتاب مشهور بعنوان: «من أجل سياسة حضارية». وقال إنه لا حضارة من دون نزعة إنسانية تضامنية تحترم كرامة الإنسان وتتعاطف معه وتقيم العلاقات الأخوية بين جميع الأقوام والشعوب.
فنحن جميعاً نعيش على سطح هذا الكوكب الأرضي فإما أن نغرق معاً وإما أن ننجو معاً. وكارثة «كورونا» التي انقضت علينا فجأة أثبتت ذلك بكل وضوح. من أين جاءته كل هذه القوة والحيوية؟ العام المقبل سوف يصبح عمره مائة سنة بالتمام والكمال وهو لا يزال يكتب وينشر، بل ويحاضر في الجامعات والمؤتمرات. لا يزال يتحفنا بإضاءاته وأفكاره أمد الله في عمره. ونحن بأمس الحاجة إليها في الواقع.
سوف ألقي هنا نظرة سريعة على المذكرات الضخمة التي نشرها مؤخراً والتي تتجاوز الـ750 صفحة من القطع الكبير. وقد خلع عليها عنواناً شاعرياً جميلاً حقاً: الذكريات تأتي لملاقاتي... وقد اشتريتها من «مكتبة كليلة ودمنة» الواقعة في قلب العاصمة المغربية: الرباط العامرة. وفرحت بها كثيراً، بل وغطست فيها كلياً وأنا عائد في القطار إلى البيت في القنيطرة.
علاقته بأندريه بريتون
عندما قابل إدغار موران أندريه بريتون لأول مرة فوجئ بقوة شخصيته وجلالته الإمبراطورية. بدا له وكأنه يعتلي عرش السريالية كالملك المبجل. ولم يكن متوتراً غاضباً يوزع الشتائم يميناً وشمالاً كما كان يتوقع ويخشى. ومعلوم أن البيان الثاني للحركة السريالية كان ينضح بذلك. وكان مليئاً بالتهديد والوعد والوعيد. كان بريتون سابقاً يمارس سلطته بكل حزم ويهدد بفصل أي شخص يخرج عن المبادئ العامة للحركة التي غيرت وجه الآداب الفرنسية بل والعالمية بل والعربية. ولكن البركان الثائر هدأ بعد ذلك رويداً رويداً.
ويرى إدغار موران أن الحركة السريالية هي أهم حركة ثقافية ظهرت في القرن العشرين. فقد حررت الكتابة من كل أنواع القمع التي تحيط بها أو تضغط عليها وفتحت لها آفاق الإبداع على مصراعيها.
بل ووصل بها الأمر إلى حد ممارسة الكتابة الأتوماتيكية، أي العفوية الحرة المتحررة من رقابة الوعي الظاهري القمعي والتي تطلق العنان للوعي الباطني كلياً. عندما التقى إدغار موران به كان عمر أندريه بريتون 60 سنة وكان قد خاض كل التجارب الجنونية ووصل إلى مرحلة النضج والثقة الكاملة بالذات. وكان يقول هذه العبارة: لا يوجد أي حل أبداً خارج الحب.
كل شيء عابر في هذا العالم
ما عدا لحظة حب
وهذا يعني أنه كان قد تجاوز المراحل الأولى الانفجارية التي تشبه انفجار الزلازل والبراكين. وبدل اللعنات والشتائم انتصر مفهوم الحب بالمعنى الضيق والواسع على عالمه الفكري والأدبي. قبل أن يقابله راح إدغار موران يغطس كلياً في الأدبيات السريالية فقرأ البيان الأول والبيان الثاني للحركة وقرأ أيضاً أعداد مجلة «الثورة السريالية». ويعترف بأنها كانت غنية بالنصوص العبقرية. ثم يقول بأنه كان دائماً معجباً بشعار الحركة السريالية: ينبغي تغيير العالم! ينبغي تغيير الحياة! ويعترف أنه مدين لبريتون بالفكرة التالية التي طورها فيما بعد لحسابه الخاص: وهي أنه يوجد استقطاب ثنائي بين نثر الحياة - وشعر الحياة. بمعنى: هل تعيش الحياة نثرياً أم شعرياً؟ في الواقع أننا نعيشها في كلتا الحالتين، وبالتناوب... لا يمكننا أن نعيش الحياة كلها شعرياً وإلا لغرقنا في الهذيانات الخيالية والجنون وانقطعنا عن حركة الواقع كلياً. اللحظة الشعرية لا معنى لها إن لم تأتِ فجأة بعد لحظات نثرية طويلة، بل ورتيبة مملة. آه ما أجمل الحياة، ما أجمل شاعرية الحياة!
علاقته برولان بارت
لقد كانت علاقة ودية جميلة لا عدائية ولا صراعية على عكس الحال مع سارتر. يقول لنا إدغار موران ما فحواه: «كنا نلتقي كثيراً إبان الخمسينات من القرن الماضي. وفي أثناء الستينات راح ينخرط أكثر فأكثر في الاتجاهات السيميولوجية أو السيميائية. ثم سيطرت عليه الموجة البنيوية كسواه من النقاد الفرنسيين. وبالغوا في هذا الاتجاه وأسرفوا. وراحوا يعاملون الأدب بطريقة تشريحية جافة قتلت روحه وجعلته يبدو عقيماً مملاً. لقد أرادوا تحويل الأدب إلى علم ناشف وصارم وهذا مستحيل لأن روح الأدب ذاتية شاعرية مضادة لمنهجية العلم الحسابية الدقيقة الباردة. ولذلك كانت فرحتي عظيمة عندما تخلى عن البنيوية في سنواته الأخيرة وعاد إلى روح الأدب الحقيقية وراح يكتب مؤلفات من نوع: (متعة النص)». كم أسعدتني هذه الكلمات من طرف إدغار موران! كم أنعشتني! فأنا أيضاً كنت أرى البنيوية هكذا بالضبط. وأتذكر أني عندما وصلت إلى باريس لدراسة النقد الأدبي في أواخر السبعينات فاجأتني هذه المدرسة التكنولوجية ببرودتها الصقيعية وأزعجتني إلى أقصى حد ممكن. وقد كتبت عن ذلك سابقاً وعبرت عن استيائي من الموجة البنيوية التي طغت بكل إمبريالية متعجرفة على الساحة الباريسية أولاً فالساحة العربية ثانياً. البنيوية ليست إلا تطويراً لنظرية عبد القاهر الجرجاني العبقرية عن مفهوم «النظم». ما عدا ذلك لا ينبغي الإسراف فيها ونسيان متعة النص. لا ينبغي القضاء على جماليات النص من خلال هذا الإسراف البنيوي المليء بالشكليات الفارغة والجداول الإحصائية. يضاف إلى ذلك أن المثقفين الفرنسيين آنذاك راحوا يطلعون علينا بصرعات وشعارات من نوع: موت الإنسان، موت المؤلف، إلى آخره. وفي الوقت ذاته كانوا حريصين أشد الحرص على توقيع نصوصهم ومؤلفاتهم بأسمائهم الشخصية. فلماذا لم يطبقوا نظرية موت المؤلف على أنفسهم؟ لماذا كانوا حريصين على وضع أسمائهم الشخصية بحروف ساطعة وفاقعة على كتبهم؟ ما هذا الهراء؟ لحسن الحظ فإن كل ذلك قد انحسر الآن عن الساحة الباريسية وانتهى. «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض».
إدغار موران والحضارة الغربية
كنا نعتقد أن العالم الشرقي هو وحده المريض ولكننا اكتشفنا أن الغرب هو أيضاً مريض وإن بشكل آخر مختلف كلياً. فنحن نعاني من التطرف والإكراه في الدين والغيبيات والطائفيات التي تمزقنا تمزيقاً وتجعل وحدتنا الوطنية حلماً بعيد المنال. وهو يعاني من التطرف المعاكس الغارق في الإباحيات والماديات والركض المسعور وراء الشهوات والخروج كلياً على المثل العليا والروحانيات. تطرف وتطرف مضاد. تعددت الأسباب والموت واحد! يقول لنا إدغار موران ما معناه: صحيح أن المجتمعات الغربية تجاوزت مرحلة الأصولية الدينية بعد المرور بالمرحلة التنويرية ولكنها ولدت أصولية جديدة غير السابقة. صحيح أنها تجاوزت الطائفية والمذهبية ولم تعد تذبح على الهوية. ولكنها ولدت بربرية جديدة يمكن أن ندعوها بالبربرية الرأسمالية الصقيعية، أي بربرية الحسابات الباردة، والربح والفائدة، والتقنيات التكنولوجية. قل لي كم تملك في البنك أقل لك من أنت. لم تعد هناك قيمة أخرى تتعالى على الماديات والحسابات والملكيات. الإنسان أصبح مختزلاً إلى رقم حساب في البنك. فإذا كان كبيراً كان من أعظم الناس حتى ولو كان شخصاً حقيراً تافهاً لا يساوي «قشرة بصلة» من الناحية الأخلاقية والإنسانية. وإذا كان حسابه البنكي صغيراً فلا قيمة له في مجتمعات الغرب حتى ولو كان من أشرف الناس! صحيح أن الحضارة الحديثة حققت لمجتمعات الغرب المتقدمة إنجازات ضخمة ما كان يحلم بها آباؤنا وأجدادنا مجرد حلم: كالرفاهية المادية، ورغد العيش، والطب المزدهر المتفوق، والمستشفيات الرائعة، والضمان الصحي، والضمان الاجتماعي، والحكم الديمقراطي، وحرية التفكير والتعبير حتى في مجال المقدسات والشؤون الدينية. إلخ. وكلها أشياء عظيمة لا تقدر بثمن ولا يعرف قيمتها إلا من هو محروم منها (انظر عالمنا العربي والإسلامي عموماً). ولكننا اكتشفنا أن هذه الرفاهية المادية لا تجلب السعادة بالضرورة. لقد دفعنا ثمنها باهظاً من إرهاق نفسي عام، وكرب، وإسراف في الشراب والمخدرات، وفراغ داخلي، أو خواء داخلي عميق. هذا هو الإنسان الغربي.
وتنتج عن ذلك كل أنواع اليأس والعدمية بل وحتى الانتحار. وبالتالي فعلى المستوى الشخصي لا يزال الغربيون أنانيين، بل وبرابرة وإن من نوع آخر. والسؤال المطروح هو التالي: لماذا نجد أن البربرية مستعدة للانبثاق في أعماق الإنسان الحضاري الذي تجاوز مرحلة الأصوليات والظلاميات والقرون الوسطى المعتمات؟ لماذا يحصل ذلك في أرقى المجتمعات الغربية وأكثرها تقدماً من الناحية العمرانية والصناعية والمادية والتكنولوجية والحضارية؟ وجواب الفيلسوف الكبير إذا كنت قد فهمته جيداً هو التالي: لأن رسالة التعاطف الكونية، وفكرة الأخوة الإنسانية، وكل القيم المثالية العليا، لم تستطع الانتصار على النواة الصلبة للبربرية الداخلية الرابضة في أعماق الإنسان. شكراً إدغار موران!