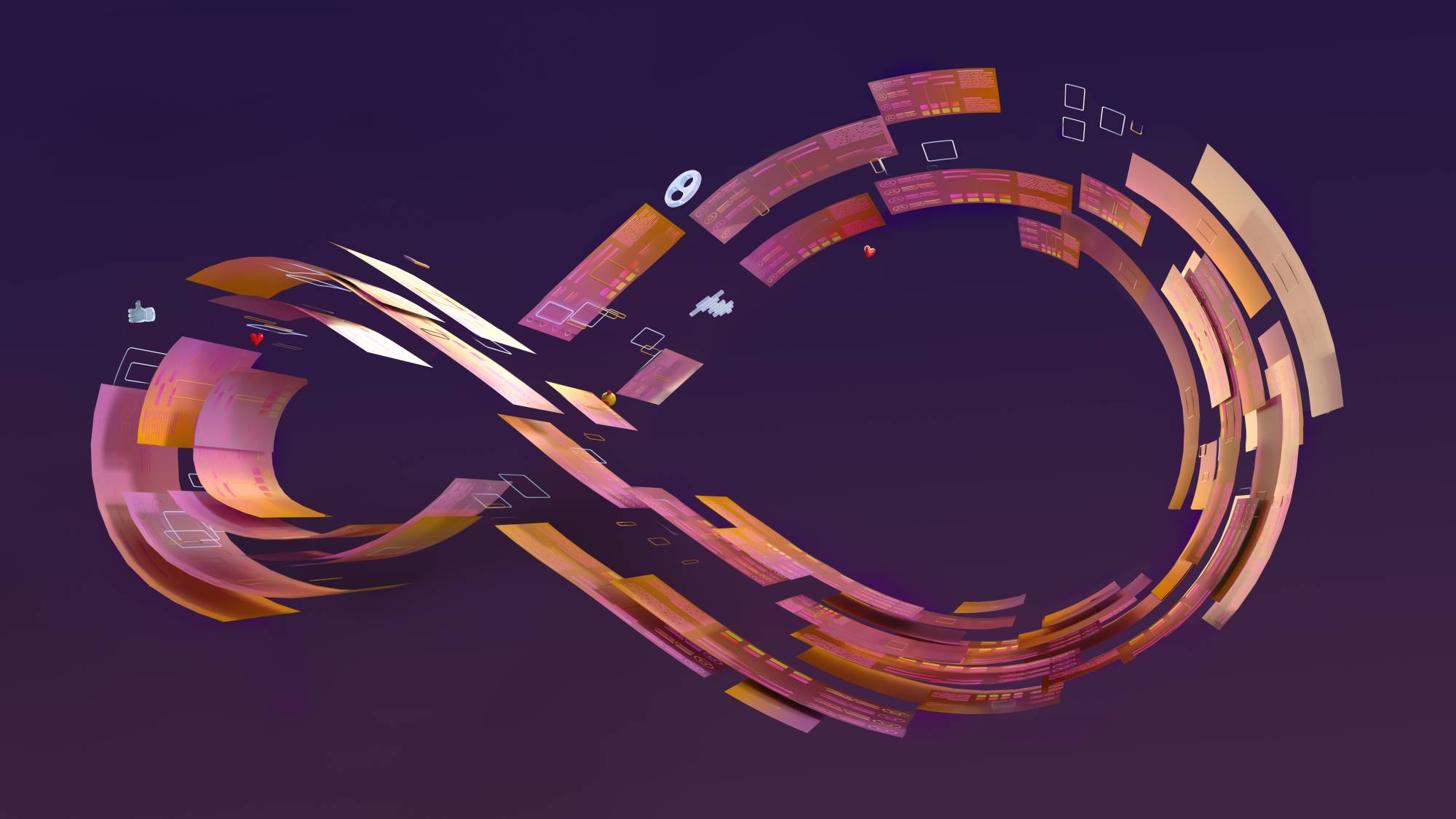في العام 2015 صدر تقريران مهمان حول التهديد الذي تواجهه الحياة البحرية حول العالم، أولهما التقرير السنوي الصادر عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية الذي حدد 8 أخطار رئيسة تهدد الحياة البحرية والساحلية على سواحل المملكة سواء على البحر الأحمر أو على الخليج العربي، وهي: تدمير بيئات أشجار المانغروف وتدمير الشعاب المرجانية التي يعتمد عليها ثلاثة أرباع الأسماك في الخليج، وتلوث المياه والهواء، وإلقاء النفايات على السواحل التي تعرض صحة السكان للخطر، وممارسات الصيد الجائر والرعي الجائر، وعمليات الردم والتجريف. أما التقرير الثاني فقد صدر في نفس العام عن الصندوق العالمي للطبيعة في سويسرا، الذي أشار إلى أن 50 في المائة من الحياة البحرية تعرضت لضربة مدمرة على مدى 40 عاما ما بين 1970 و2012. ووفقا لهذا التقرير فإن أشجار المانغروف يتم فقدانها بمعدل أسرع مرتين إلى خمس مرات من الغابات. كما يتم فقدان الشعاب الاستوائية بمقدار النصف، ويمكن أن نفقدها كلية بحلول عام 2050.
الحياة البحرية
في هذا الإطار رسمت دراسة دولية حديثة، بقيادة البروفسور كارلوس دوارتي والبروفيسورة سوزانا أغوستي من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، ونشرت أخيرا في مجلة «نيتشر»، خريطة طريق أساسية للإجراءات اللازمة، كي تتمكن الحياة البحرية على كوكب الأرض من استرداد عافيتها ووفرتها الكاملة بحلول عام 2050.
ويعمل في المشروع مجموعة من علماء البحار البارزين في أربع قارات وعشرة بلدان وست عشرة جامعة منها كاوست، وجامعة أراهوس ومعهد ماساتشوستس للتقنية وجامعة ولاية كولورادو، وجامعة بوسطن والجامعة البابوية الكاثوليكية في تشيلي وجامعة السوربون في فرنسا، وجامعة جيمس كوك وجامعة كوينزلاند وجامعة دلهاوزي وجامعة يورك.
أوضح البروفسور كارلوس دوارتي، أستاذ علوم البحار في كاوست وأستاذ كرسي طارق أحمد الجفالي لعلوم أحياء البحر الأحمر، بأن الوضع الحالي أصبح مقلقا، وأشار إلى أننا بلغنا منعطفاً يجب أن نختار عنده بين محيطات قادرة على التكيف ونابضة بالحياة، ومحيطات لا يمكن إصلاحها. وأضاف البروفسور دوارتي بأن هذه الدراسة قد وثقت تعافي الأحياء والموائل والأنظمة البيئية البحرية في أعقاب إجراءات وتدابير عمليات الحفظ والحماية السابقة. كما قدمت توصيات محددة مدعمة بالأدلة للتوسع عالمياً في الحلول التي أثبتت جدواها.
ورغم أن الإنسان قد أحدث تغييرات أضرّت كثيراً بالحياة البحرية في الماضي، إلا أن الباحثين وجدوا أدلة على تمتعها بقدرة ملحوظة على التكيف، كما لاحظوا تطورا لافتا تمثل في نشوء اتجاه من خسائر حادة في الحياة البحرية طوال القرن العشرين إلى تباطؤ في هذه الخسائر. ليس هذا فحسب فقد لوحظ أيضا أن الحياة البحرية قد تعافت خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين في بعض الحالات.
وتسلط الأدلة التي توصل إليها العلماء، إلى جانب حالات تعافٍ رائعة بوجه خاص كالحيتان المحدبة، الضوء على إمكانية استعادة وفرة الحياة البحرية، مما يسهم في ظهور اقتصاد أكثر استدامة قائم على المحيطات. وتفيد الدراسة بإمكانية التعجيل بتعافي الحياة البحرية، وإنجاز ذلك خلال عقدين أو ثلاثة لمعظم مكونات الأنظمة البيئية البحرية بشرط التصدي لتغير المناخ واتخاذ خطوات فعالة واسعة النطاق. وأكدت البروفسورة سوزان أغوستي، أستاذة علوم البحار في كاوست، أن البشرية تواجه تحدياً هائلاً، ولكن يمكن لها تجاوزه من خلال إعادة بناء الحياة البحرية، مما يمثل التزاماً أخلاقياً وهدفاً اقتصاديا ذكياً لتحقيق مستقبل مستدام.
أعمدة التعافي
حدد الباحثون، عن طريق دراسة الأثر الذي أحدثته الإجراءات والتدابير الناجحة السابقة التي اتخذتها الدول والمجتمعات للحفاظ على المحيطات إضافة إلى اتجاهات التعافي، تسعة عناصر جوهرية لبناء ما يلي: الحياة البحرية، المستنقعات المالحة، المانغروف، الأعشاب البحرية، الشعاب المرجانية، المحاريات، مصائد الأسماك، الحيوانات الضخمة، وأعماق البحار.
كما أوضحت الدراسة بأن تحقيق الهدف المنشود يجب أن يمر من خلال ست عمليات تكاملية تدعى «أعمدة التعافي»، وهي إجراءات محددة في إطار مواضيع عامة تشمل: حماية الأجناس البحرية وترشيد استغلال الثروات البحرية وحماية المساحات وإصلاح الموائل وخفض التلوث والتخفيف من تغير المناخ.
وتنطوي الإجراءات الموصى باتخاذها على فرص وفوائد وعقبات محتملة وإجراءات علاجية، مما يرسم خريطة طريق ملموسة لتوفير محيطات معافاة قادرة على تأمين منافع هائلة للبشرية ولكوكب الأرض.
ويشير الباحثون إلى أنه إذا تم تفعيل «أعمدة التعافي» كلها على نطاقٍ واسع، وفي ضوء المدد الزمنية التي استغرقها تعافي الحياة البحرية المتضررة سابقاً، فمن الممكن استعادة وفرة الحياة البحرية خلال جيل بشري واحد أو خلال عقدين إلى ثلاثة عقود، أي بحلول العام 2050.
وكان التخفيف من تغير المناخ بخفض انبعاثات غازات الدفيئة من أهم عناصر النجاح التي حُددت، إذ أن الآثار الناجمة عن تغير المناخ الذي حدث سابقاً، التي لم يكن مفراً منها، حدّت من المجال المتاح لإعادة بناء الشعاب المدارية، مما أعاق تعافيها الكامل. وتشير الدراسة إلى أنه من غير الممكن استعادة وفرة الحياة البحرية، إلا إذا تحققت الأهداف الأكثر طموحاً في اتفاقية باريس. وجدير بالذكر فإن الـ194 دولة التي وقعت على اتفاق «باريس للمناخ 2015»، كانت قد تعهدت على جملة من الإجراءات والقرارات المتعلقة بالمناخ أبرزها حصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها «دون درجتين مئويتين»، قياسا بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وبـ«متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية». وهذا يفرض تقليصا شديدا لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات.
وإلى ذلك، فالنجاح يعتمد إلى حد كبير على الدعم الذي تقدمه شراكة عالمية ملتزمة وقادرة على الصمود بين الحكومات والمجتمعات المؤيدة لهذا الهدف. ويتطلب النجاح أيضاً التزاماً جوهرياً بتقديم الموارد المالية، ولكن هذه الدراسة الحديثة كشفت عن أن المكاسب الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية لإعادة بناء الحياة البحرية لن تكون سريعة وآنية وإنما على المدى البعيد.
وتأتي الدراسة في وقت تتولى المملكة سدة الرئاسة لمجموعة العشرين وتقود شركاءها في المجموعة لوضع منهجيات جديدة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على التنوع الحيوي ما بعد 2020. وإعداد خطة عملية للتصدي للتحديات المناخية وحماية الشعاب المرجانية وغيرها من الأنظمة البيئية، التي يسهل تعرضها للضرر.
واختتم البروفسور دوراتي حديثه قائلاً: «لدينا نافذة أمل ضيقة لنخلف لأحفادنا محيطات معافاة، ولدينا المعرفة والأدوات اللازمة لذلك. لذا فإن الإخفاق في مواجهة هذا التحدي، والحكم على أحفادنا بمحيطات ضعيفة عاجزة عن دعم سبل عيش عالية الجودة، ليس خياراً».