أخيراً، رحل أشهر صحافي فرنسي في القرن العشرين عن عمر طويل جداً يقارب المائة عام (1920 - 2020). إنه جان دانييل مؤسس مجلة «النوفيل أوبسرفاتور» عام 1964 ومديرها طيلة عقود متتالية. فعلى مدار نصف قرن ما انفك هذا الرجل يؤثر على الأوساط السياسية والثقافية بافتتاحياته الشهيرة كل أسبوع. وربما كان قادة العالم، وليس فقط فرنسا، ينتظرون هذه الافتتاحيات لكي يتخذوا موقفاً من القضايا الكبرى التي تهز العالم. ولم يكن يوازيه في ذلك أو يعادله إلا ريمون آرون. والشيء الذي سبب نجاح مجلته وتفوقها على ما عداها هو أنه فهم منذ البداية أنه لا صحافة سياسية من دون صحافة ثقافية. وعرف بحدسه الثاقب أن الثقافة بالمعنى العميق للكلمة هي التي تبقى في نهاية المطاف. فالسياسة متقلبة ومرتبطة بظروف وقتها، وسرعان ما تزول أهميتها وتتبخر بزوال اللحظة، أما الثقافة فتتجاوز اللحظة المعاشة وتتعالى عليها. لهذا السبب؛ حرص جان دانييل على استكتاب كبار فلاسفة فرنسا ومثقفيها في «النوفيل أوبسرفاتور». وهكذا استطاع استقطاب جان بول سارتر، وميشيل فوكو، ورولان بارت، وعشرات الآخرين. وعلى هذا النحو أحاطت هالة الإشعاع الثقافي بمجلته وجعلتها تتخذ بريقاً لامعاً وجاذبية لا تقاوم. بل وحرص على إصدار أعداد خاصة متمحورة حول المواضيع الفلسفية الكبرى. نذكر من بينها: «المفكرون الجدد في الإسلام»، و«العرب منذ البداية وحتى اليوم: القدر العظيم لشعب الصحراء»، و«سبينوزا: معلم الحرية»، و«جان جاك روسو: عبقرية الحداثة»، إلخ... على هذا النحو ارتبطت الصحافة السياسية بالصحافة الثقافية على مدار تاريخ هذه المجلة. وكل ذلك لأن صاحبها لم يكن سياسياً فقط، وإنما مثقفاً أيضاً، بل وبالدرجة الأولى. وما معنى صحافة سياسية من دون ثقافة؟ ما قيمتها؟ ما جدواها؟ فهو صاحب كتب كثيرة، نذكر من بينها: الزمن الذي تبقى، ديغول والجزائر، شموس الشتاء، السجن اليهودي، هذا الغريب الذي يشبهني، إسرائيل، العرب، فلسطين (تقديم إلياس صنبر وإيلي برنافي)، أعزائي، أو أحبائي، أو جماعتي، إلخ.
سوف أتوقف فقط عند كتابين اثنين، هما: السجن اليهودي، وأحبائي أو جماعتي. الكتاب الأول أحدث فرقعة، بل وانزعاجاً حقيقياً في الأوساط اليهودية المتدينة، إن لم نقل المتزمتة. وذلك لأنه يفكك العقيدة الأساسية القائلة بأن اليهود هم شعب الله المختار. ففي رأيه أن جميع الشعوب مختارة وليس فقط اليهود. بل ويرى أن الله؛ إذ جعل من اليهود شعبه المختار كما تقول العقيدة الكهنوتية ألقى على كاهلهم مهمة ثقيلة جداً، مهمة تقع فوق طاقة البشر. والله إذ أحب هذا الشعب الصغير القليل العدد فإنه حرمه من هامش حريته. وبالتالي، فقد آن الأوان لكي يخرج اليهود من هذا السجن اللاهوتي، من هذا القفص العقائدي الذي انغلقوا داخل جدرانه. ويرى جان دانييل أن اليهود هم الذين سجنوا أنفسهم داخل هذه الشرنقة، داخل هذا القفص اللاهوتي الذي أحبوه إلى حد الوله. فهو يشعرهم بالتمايز والتفوق على جميع شعوب الأرض. وهذه متعة ما بعدها متعة. من هنا سر تعلقهم به على الرغم من كل ما سببه لهم من عذاب وحسد وكره واضطهاد على مدار التاريخ. والواقع أنه يشكل خطراً عليهم؛ لأنه يعزلهم داخل قوقعة مغلقة بعيداً عن جميع البشر. وفي مكان آخر يقول جان دانييل ما معناه: هناك يهود نجحوا في الإفلات من هذا الأسر، في الخروج من هذا السجن. وجميع الشخصيات التي أحبها على مدار حياته كانت من هذا النوع. يضرب على ذلك مثلاً سبينوزا، وفرويد، وآينشتاين، وكافكا، وعشرات غيرهم من العباقرة. هؤلاء خرجوا من السجن اليهودي تماماً؛ ولذلك أبدعوا وأصبحوا عباقرة. بالطبع كانوا يعرفون أنهم يهود، وما كانوا يخجلون بذلك أبداً. لكن ما كانوا حريصين على الانتماء اليهودي بالمعنى الضيق والطائفي للكلمة. نستنتج من كل ذلك أنه ينبغي على اليهودي أن يعرف كيف يخرج من قوقعته اليهودية لكي يعانق القيم التنويرية الكونية التي يلتقي على أرضيتها مع جميع شعوب الأرض. وما يقال عن اليهودي يقال عن العربي أو المسلم أيضاً، إلخ. هذا هو فحوى الكتاب استعرضناه بسرعة صاروخية وربما اختزالية. لتوضيح الفكرة أكثر سوف أقول ما يلي: أتذكر بهذا الصدد أن الكتاب عندما صدر عام 2003 لقي إعجاب محمد أركون، أكبر مفكر في الإسلام المعاصر. وأتذكر أنه قال ما معناه: أنا أيضاً كان ينبغي أن أدبج كتاباً كاملاً بعنوان السجن الإسلامي الأصولي! لقد سبقني جان دانييل إلى ذلك. فالمسلمون أيضاً منغلقون على أنفسهم داخل شرنقتهم الخاصة. وقد آن الأوان لثقب الشبابيك والأبواب الموصدة لكي ينفتحوا على العالم ويشموا الهواء الطلق في الخارج. آن الأوان لكي يخرجوا من سجنهم اللاهوتي الكهنوتي الذي غطسوا فيه لكي يعانقوا الحداثة العلمية والفكرية والفلسفية. بل وحتى لكي يعانقوا الحداثة الدينية، لكن بالمعنى الأنواري للكلمة لا بالمعنى الظلامي. فهذه شبعنا منها. والواقع أن أركون ألّف هذا الكتاب، لكن بعنوان آخر هو: ألف باء الإسلام: لأجل الخروج من السياجات الدوغمائية المغلقة. العنوان مختلف، لكن المعنى واحد في نهاية المطاف. فالسياجات الدوغمائية تعني السجون والأقفاص العقائدية أو الطائفية الخاصة بكل دين. خلاصة الموضوع كما أفهمه هي التالية: أي شخص أو أي شعب يقدم خدمات جليلة للبشرية كاختراع العلاجات ضد الفيروسات والأمراض التي تفتك بنا فهو ينتمي حتماً إلى شعب الله المختار أو إلى الفرقة الناجية إذا شئتم. بهذا المعنى، فإن الشعوب الحضارية التي تتحفنا كل يوم باختراعات جديدة هي شعب الله المختار. نذكر من بينها جميع الشعوب الحضارية المتقدمة كالشعب السويسري أو الكندي أو الهولندي أو الدنماركي الخ... وبهذا المعنى، فنحن العرب أيضاً كنا شعب الله المختار أو «خير أمة أخرجت للناس» إبان العصر الذهبي عندما أعطينا للعالم مفاتيح العلوم الفيزيائية والبصرية والرياضية والطبية والفلكية والفلسفية التي أدت إلى نهضة أوروبا لاحقاً. عندما كان إشعاعنا الحضاري يطل على العالم كله من بغداد أو قرطبة كنا من دون أدنى شك شعب الله المختار. وقل الأمر ذاته عن اليهود وبقية شعوب العالم.
أنتقل الآن إلى الكتاب الثاني الذي يتحدث فيه جان دانييل عن الشخصيات التي أحبها أو التقاها على مدار حياته الطويلة. ومن بينها شخصيات فلسفية وأدبية من الطراز الأول. نذكر من بينها: أندريه جيد، وألبير كامو، وفرنسوا مورياك، وأندريه مالرو، وجان بول سارتر، ورولان بارت، وميشيل فوكو، ولويس أراغون، وكاتب ياسين، وجاك بيرك، وأكتافيو باز، ومحمد ديب، ومكسيم رودنسون، وجاك دريدا، وسولجنتسين، وآخرين... عندما تقرأ هذه البورتريهات أو الصور الشخصية التي يكرسها جان دانييل لكبار العباقرة تدرك فوراً أن الرجل لم يكن صحافياً لامعاً فقط، وإنما كان أيضاً مفكراً حقيقياً، بل وكاتباً أدبياً من الطراز الأول. وهنا يكمن الفرق بين الصحافي العادي والصحافي الاستثنائي. إنها لمتعة ما بعدها متعة أن تقرأه وتستمتع بكتابته. لكن للأسف، لا نستطيع التوقف عندها كلها في هذه العجالة وإنما سنكتفي بما قاله عن أندريه جيد. فهو يكرس له صفحات مطولة يرد فيها ما فحواه: كان أندريه جيد يقول ما يلي: كلما كان الأبيض غبياً اعتقد بأن السود همج أو وحوش! وكان يعرف الكتابة الصحافية السريعة على النحو التالي: كل كتابة تكون قيمتها غداً أخفض من قيمتها اليوم. بمعنى أنها تُرمى بمجرد أن تُستهلك. وهذا الأمر ينطبق على المقالات السياسية بشكل عام، بل وحتى على المقالات الثقافية الهشة أو العديمة القيمة، وما أكثرها. لكن هناك مقالات سياسية عميقة تظل تحتفظ بقيمتها لفترة طويلة. انظر مقالات ريمون آرون مثلاً أو حتى جان دانييل ذاته، هذا ناهيك عن مقالات فرنسوا مورياك في مجلة «الاكسبريس» التي كان ديغول ينتظرها بفارغ الصبر كل أسبوع. ثم كان أندريه جيد يقول هذه العبارة الرائعة. لقد استقبلت شاباً غريباً الأطوار مؤخراً. لماذا أقول بأنه غريب الأطوار؟ لأنه يعتقد بأننا يمكن أن نضع شيئاً آخر فوق الأدب! عيب، لا يجوز. ومعلوم أن أندريه جيد كان من عبيد الأدب كما تقول العرب عن بعضهم بأنهم من عبيد الشعر. كان أحد كبار كتاب اللغة الفرنسية على مر العصور. ثم قال أندريه جيد لأحدهم: إياك أن تبحث عن الله في مكان محدد ومحصور يا غلام. لماذا؟ لأنه موجود في كل مكان... ألا يذكركم ذلك بالآية الكريمة التي تقول: « وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ....» (البقرة، 115).
وكان أندريه جيد يقول أيضاً هذه العبارة الجميلة: ما كنت أبحث عنه في الصحراء: عطشي! أخيراً، يرى جان دانييل أن أندريه جيد كان من أوائل من أدانوا الانغلاقات الاستعمارية والعنصرية والطائفية وما دعاه أمين معلوف لاحقاً بالهويات القاتلة. وكان يفتخر بأنه أول من عرّف الفرنسيين بأقطاب الأدب العالمي من أمثال: الروسي دوستوفسكي، والألماني نيتشه، والهندي طاغور، والعربي المصري طه حسين!
جان دانييل... مثقف تنويري كبير يغيب عن عالمنا
أدرك منذ بداية عمله أنه لا صحافة سياسية من دون صحافة ثقافية
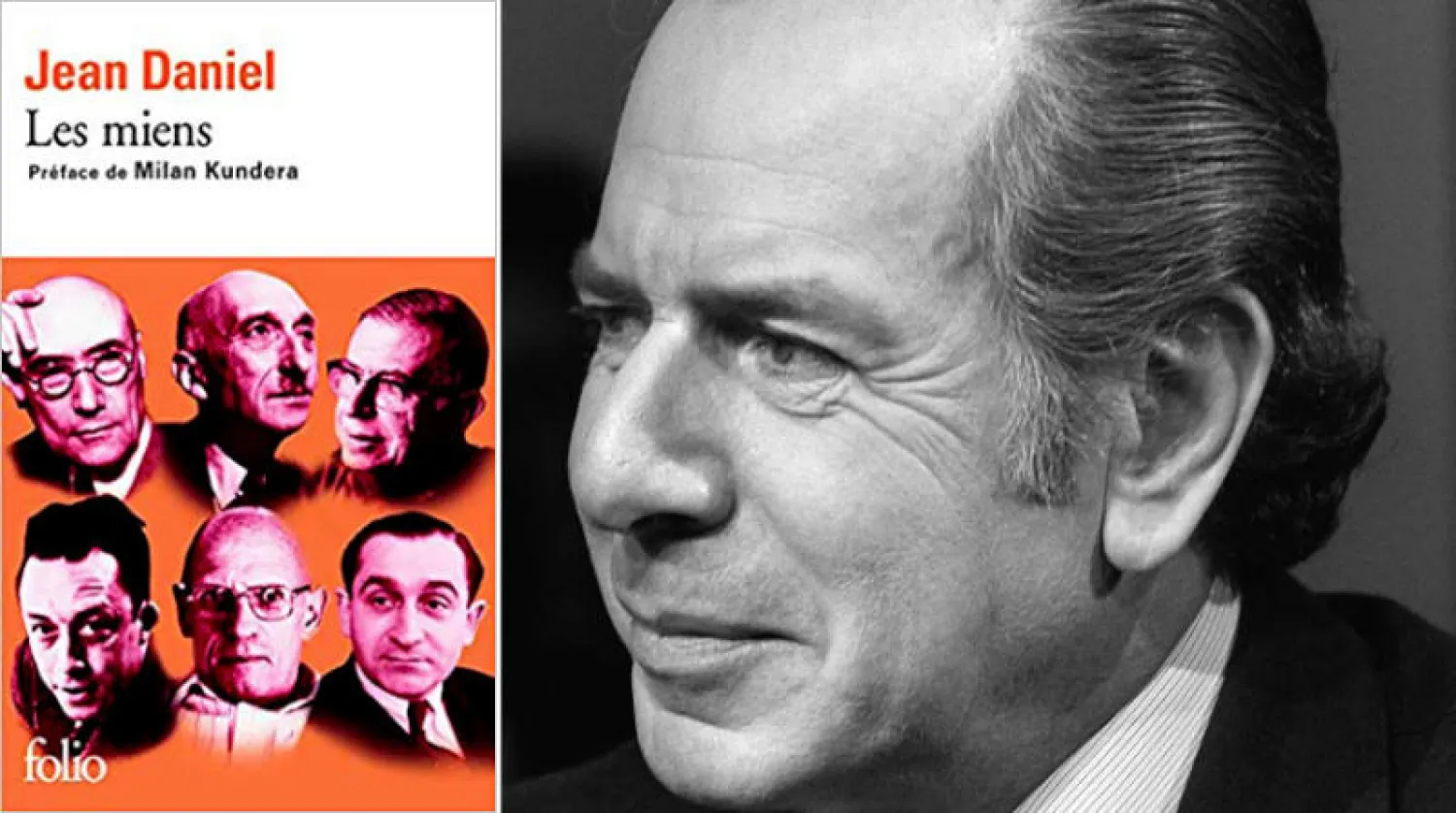
جان دانييل

جان دانييل... مثقف تنويري كبير يغيب عن عالمنا
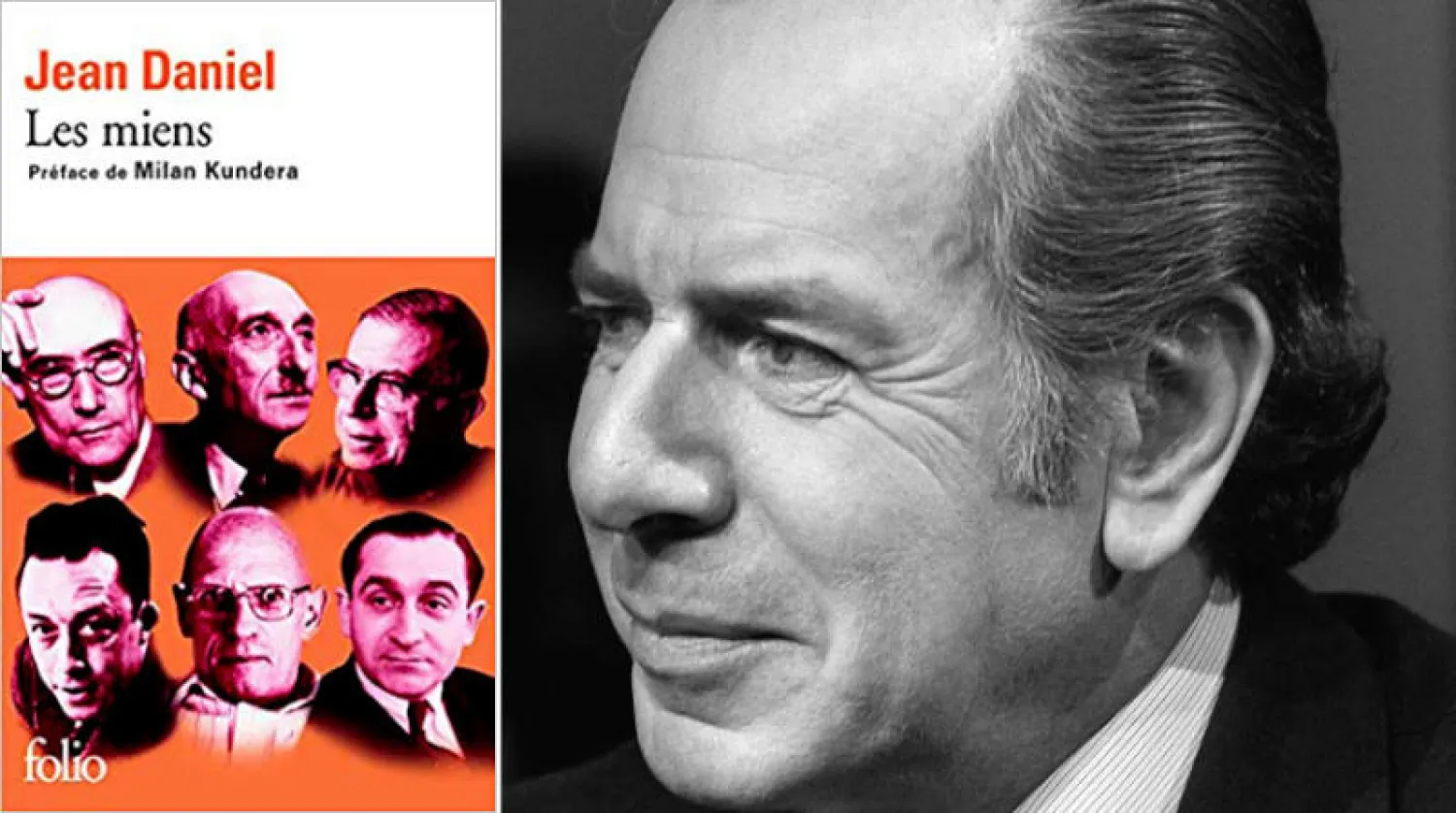
جان دانييل
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة











